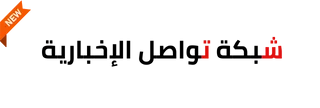إذا أعلنت رفضها، فاستمعوا إليها!

(١)
إذا مصرُ قالت نعم أيدوها….
وإنْ أعلنتْ لاءَها فاسمعوها!
وصيةٌ للعرب صاغها فى صورة قصيدة شعرية الشاعر شكرى نصرالله، وغناها المطرب وديع الصافى، ولم يأخذ بها العرب واستكبروا عليها وتجاهلوها، فآل حالُهم إلى مآل وحال كل جاحدٍ لذى فضلٍ، وكم لمصر من جُحٌادٍ نهلوا من خيرها ثم أنكروه وأنكروها!
هذا هو الملخص المعاصر للسياسة والتاريخ فى الأمة التى تنبأ نزار قبانى بوفاتها، فلم يصدقه البعض منا – نحن المصريون – فدفعنا ومازلنا ندفع ثمن إنكار نبوئته!
(٢)
فكرة عابرة كتبها أحد مواطنى دولة عربية آسيوية. كانت هذه الدولة قد سقطت فى فخ الخريف العربى فدُمر جيشُها ومُزقت أوصالها وهجرَها غالبية مواطنيها وتشتتوا فى الدول المجاورة. وكانت مصرُ أول من فتحت ذراعيها لهم وفاءً بما أثقلت هى نفسُها عاتقَها به من مبادىء الشرف والإخوة العربية..أكثر من عشر سنوات عاشت ملايينهم بيننا رأسا برأس مع المصريين، اقتسمنا معهم العيش والسكن، ولم نثقل عليهم بأعباءٍ أو نعاملهم كأجانب..
حتى كان ما كان مؤخرا وامتطى صهوة الحكم أحد الذين كان لهم دور فى تمزيق أوصالها، فتنازل عن قطع من أرضها، فرضى عنه الذين تقف لهم مصرُ بالمرصاد وقرروا مساعدته..وأول ما بدأ الحديث عنه من بنودٍ فى غنائم الخريف العربى هو بند إعادة الإعمار..
الفكرة العابرة كتبها أحد مواطنى تلك الدولة داعيا مواطنيه والقائمين على مؤسساتها بأن يستعينوا بالمصريين فى إعادة الإعمار وفاءّ وعرفانا بجميلٍ رآه الرجل من مسلمات المشهد.. لم يكد الرجل يفرغ من كلماته البسيطة حتى انفجرت على صفحته مئات التعليقات من مواطنيه ممن لا يزال بعضهم يعيش على أرض مصر..
فى عدة ساعات قضيتها لمتابعة ما يشبه استبيان الرأى على هذه الفكرة حصرتُ مئات من التعليقات الأولى فاكتفيت بها، وقررت القيام بحصرها حسب النسب المئوية.
(٣)
الغالبية العظمى من التعليقات كانت لمواطنى تلك الدولة فى هذه الساعات الاولى لنشر الفكرة، ثم بدأت بعض تعليقات المصريين فى الظهور، ولن أتوقف كثيرا أمام تعليقات المصريين لأنهم ليسوا هم المقصودون بالحديث. ويمكن حصر ردود أفعالهم فى ثلاث عبارات..صدمة..ذهول.. ثم رفض وغضب!
أكثر من تسعين بالمائة من التعليقات اتفقت على رفض الفكرة واستهجانها والغضب من صاحبها. بينما رحب بها خمسة بالمائة ورأوا أنه شىء طبيعى ومنطقى، واكتفى خمسة بالمائة بلوم صاحب الفكرة، ورأوها استباقا للأحداث وكان هؤلاء قلقين على مستقبل بلادهم ومتشككين فى الوصول لتلك المرحلة أو إعادة الإعمار ورأوا أن بلادهم قد ذهبت بلا رجعة!
التسعين بالمائة الذين رفضوا الفكرة واستهجنوها وهاجموا صاحبها انقسموا إلى فريقين متقاربين فى النسبة جدا.
الفريق الأول كان حادا جدا فى رفض الاستعانة بالمصريين تحديدا، وفضلوا – فى حال الحاجة – الإستعانة بجنسيات أخرى وفضلوا الأجانب من غير منطقة الشرق الأوسط، وبرروا ذلك بأن هؤلاء سوف يكونون أكثر انضباطا وتأهيلا، ونظروا للأمر بنظرة براجماتية بحتة من وجهة نظرهم وهى المصلحة الخالصة لبلادهم حسب رؤيتهم.
غلبت على عبارات هذا الفريق ظاهرة (التقطيع فى المصريين) من حيث الكفاءة وعبروا عن مشاعرٍ غير مرحبة بهم.
احتوى هذا الفريق على مجموعة صغيرة كان موقفها هو الأغرب، حيث ظهرت حالة عداء للنظام المصرى الحاكم – رغم الحياء الشديد لقادة هذا النظام حتى فى الإصرار على استخدام لفظ الضيوف ورفض تعبير اللاجئين – وحاولوا الفصل بين الشعب المصرى وبين النظام فى المشاعر فقط، لكنهم اتفقوا فى رفض الفكرة مثل باقى هذا الفريق.
(٤)
أما الفريق الثانى فقد رفض فكرة الاستعانة بأى عمالة من غير جنسية الدولة ذاتها، وكان لديهم مبررٌ متكرر هو أن مواطنيهم بالخارج كثيرون جدا وغالبا فقد أصبحوا مؤهلين بسنوات خبرتهم للاضطلاع ببناء بلادهم وأنهم أولى بتلك الأموال. ومجموعة صغيرة من هذا الفريق رأت أنه فى حال رفض بعضهم التضحية بما حققوه فى الدول المقيمين بها، فمن الممكن الاستعانة بعمالة من دول أخرى لكن ليس من مصر تحديدا! وظهرت فى عبارات هذا الفريق مشاعر كراهية ظاهرة.
ملاحظتى الأهم على هذه العينة العشوائية الأولى – وغالبا – الأصدق فى التعبير عن نفسها – هى الغياب شبه التام لأى حديث شمولى أممى من قبيل الأمة العربية، والغياب التام لأى حديثٍ عاطفى عن رد الجميل لمصر والمصريين وهو المحرك الاصلى لصاحب الفكرة نفسها.
لقد كان الحديث برمته جامدا يتعاطى مع مفردات المصلحة الوطنية لتلك الدولة وهذا الشعب حسبما يعتقده كل من شارك بالتعليق. لم تتطرق التعليقات إطلاقا إلى تفهم أو التعاطف مع أزمات مصر الاقتصادية جراء مواقف مصر من قضايا عربية أو حتى بسبب الأعباء التى تكبدتها مصر فى ملف استضافة هؤلاء أنفسهم.
هذه هى الحقيقة المجردة التى استصعب كثيرٌ من المصريين تصديقها. التفكير النفعى المجرد. صدمة المصريين مشروعة أخلاقيا وتتناسب مع طبيعتهم التى تغلب العاطفة، لكنها للأسف لا يمكن أن تكون هى الطريقة الأصوب فى إدارة ملفات الحياة العملية. هناك مثلٌ ساقط أخلاقيا (اللى يعمل ضهره قنطرة يستحمل الدوس!) يعبر عن نظرة انتهازية تستغل الكرماء وتتبجح فى لحظةٍ معينة حين ينتظر هؤلاء الكرماء معاملة بالمثل.
عفوا فظهر المصريين ليس قنطرة ليدهسها المنتهزون. ولا يمكن أن نلوم كريما على كرمه. وكما قال قائلٌ منذ قرون (لا يخون الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن!)، أى قد يضع الإنسان – لحسن نيته وطبيعة أخلاقه – ثقته فيمن تثبت التجارب بعد ذلك عدم جدارته بهذه الثقة.
هذه هى مصرالتى لا يمكن أن يقل من شأنها كرمٌ أبدته فى غير موضعه أو مع من لا يستحق، إنما نهمس فى أذنها ألا تلقى بكرمها مستقبلا بين أيدى من لا يستحقون!
(٥)
ماذا تعنى كلمة السيسى التى كررها أكثر من مرة (أن مصر تمارس السياسة بشرف؟) وهل أدرك الآن الذين كانوا يستخفون بهذه العبارة معناها وحقيقيتها؟
أزعم أن بحثى فى تاريخ مصر لعدة سنوات قادنى إلى الأصل التاريخى لما قاله الرئيس. لقد أطلقتُ على الحضارة المصرية لقب (الحضارة الشريفة.) لم يكن ذلك انتصارا لهوى شخصى منحاز، إنما كان نتيجة يقينية لوضع هذه الحضارة فى مقابلة باقى الحضارات الإنسانية قديما وحديثا.
ثلاثة عشر قرنا ونصف القرن بالتمام والكمال هى مجمل عمر الدولتين القديمة والوسطى، كانت مصر خلالها تملك من القوة ما يجعلها قادرة على اجتياح جميع البلدان المجاورة، والاستيلاء على ما تريد بقوة السلاح. لكنها لم تفعل، وآثرت العلاقات السلمية والتجارية. هذا أكثر مما يكفى لوسم هذه الحضارة عن استحقاق بالشريفة. لأن كل الحضارات الموازية قديما لم تصبر على امتلاك القوة أحيانا لأشهر أو سنوات قبل أن تغدر بكل الجيران.
حتى الدول التى قامت على ركيزة ديانة سماوية فعلت نفس الشىء بمسمياتٍ براقة. لكن مصر لم تفعل.
ليس هذا فحسب، بل كانت لا تغلق أبوابها أمام الجائعين والخائفين. ورغم أن كثيرا منهم، وبمجرد أن كانوا يشبعون بعد جوعٍ ويأمنون بعد خوف، كانوا ينشبون مخالبهم فى جسدها هى أولا.
لكنها لم تغير أخلاقها حين كانت تدور الدوائر مرة أخرى على نفس المجموعات البشرية فيهرعون لطرق أبوابها مجددا. قبائل الأعراب واليهود كانوا دائما أبطال هذه المشاهد. يلقون فيها الأمان والمطعم، ثم تفاجأ مصر بهم ككتائب عسكرية فى جيوش الغزاة، أو مقدمين للمساعدات اللوجستية لجيوش غزاة آخرين! ويفاجأنا التاريخ بتكرار مشاهد فتح أبوابها حين تقوى شوكتها فيرتعون فى خيرها لسنوات أخرى.
(٦)
فهل كانت مصر طوال تاريخها هذا ساذجة أو أنها قررت أن تجعل من ظهرها قنطرة؟! لا أعتقد هذا، إنما أعتقد أن الشرف هو مكونٌ جينى لا يُشترى أو يُكتسب.. هو قَدَرٌ لا يمكن للشرفاء نزعه من مكوناتهم حتى لو أحزنهم كثرة مشاهد الغدر والطعن..
أوصلنى بحثى لمعتقد راسخ أن الله تعالى قد أخبرنا بهذا فى قرآنه الكريم لكننا لم ننتبه. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. هذه الآية الكريمة هى خبرٌ إلهى عن هذه الصفة السرمدية فى المكون المصرى. لقد نزلتْ فى بنى إسرائيل، والله أعلى وأعلمُ بما سوف يكون من شأنهم فى مصر بعد ذلك. لكن منحهم هذه المنحة فهذا إخبار وتقديرٌ إلهيين لمنحة الشرف التى أودعها فى المكون المصرى البشرى.
استمرت مصر فى ممارسة السياسة بشرف طالما كان حكامها مصريين، حتى إذا ما سقطت – لأسبابٍ ذكرتها قبل ذلك فى مقالات سابقة – تحت حكمٍ غير مصرى، اصطبغت سياسة مصر الرسمية بأخلاق من حكموها وطبائعهم.(٧)
فى العصر الحديث، وبعد ابتلاء العرب بهذا الكيان الاستعمارى بينهم، لم يستمع العرب لنصيحة شكرى نصر الله التى شداها وديع الصافى. تنكروا للوصية فى أوقاتٍ حاسمة فضلّوا الطريق وأضاعوا قضيتهم. ساروا خلفها حين كان دفع الثمن مقصورا حصريا عليها من دماء أبنائها ومقدرات شعبها. ولم تضن ولم تضج بشكوى، واعتقدتْ أن السير خلفها كان يقينا منهم باقنناعهم بمنطقية وأحقية قيادتها لا ضنا منهم بدماء أو أموال.
وبعد أن قدمت نيابة عنهم جميعا ضريبة الدم وقالت نعم للسلام المخضب بالدم، زايدوا عليها ورجموها بالحجارة وطعنوها فى شرفها.. أعادوها لذكريات العصور القديمة المؤلمة بعد أن تخيلتْ وتخيل شعبها معها أن هؤلاء جميعا قد تغيروا، أو قد اكتسبوا منها بعض خصالها بعد طول اختبار منهم لتلك الخصال، وبعد أن عبوا من مكتسبات سياستها الشريفة.
كانت مصر مخطئة فى توقعها الذى خاب حتى قبل أن تندمل جراح ذوى شهدائها. أغلقتْ بابها على نفسها وأبنائها كدولةٍ دأبت واعتادت الشرف تجوع ولا تأكل أو تطعم أبناءها ببيع شرفها ومواقفها
. حتى إذا ما ضل سعيهم وعضوا أصابع الندم عادوا لطرق أبوابها فى عصر مبارك، فلم تقم حتى بحق العتاب، وكعادتها أعدت ورقة جديدة ناصعة البياض واندفعت فى محاولة إدراك ما فاتهم هم لا ما فاتها هى.
هرولتْ شرقا وغربا وأعادت قضية من مرقدها للحياة مرة أخرى ووقفت بقوة حتى كتبت لهم اسم دولة فلسطين بالأحرف الأولى فى رعايتها وكنفها.
(٨)
وعند أول محنة لها تنكر بعضهم لها، واصطف بعضهم معها، فعفت عمن تنكر وطعن، وآخت من اصطف وساند. حتى كان ما كان منذ أقل من عامين فعادوا سيرتهم الأولى. فجأة ألقوا قضيتهم الملتهبة فى حجرها وتركوها وحيدة تواجه الحملة الشرسة. وبعضهم لم يكتف بالصمت بل قرر سرا ان يقوم بدور خيول طروادة. يجلسون معها ثم يقومون بغرس خناجرهم فى ظهرها. وقفت منفردة ترفض وتقاوم وتواجه كل خطة معادية بخطة مقابلة. كانت لحظة فرز قاسية.. تمنت لو أنهم اكتفوا بالصمت.
(٩)
مشهد وجه الرئيس السيسى فى قمة بغداد يحكى القصة كاملة. تمنيتُ لو أننى كنت أستطيع قراءة وملاحقة العبارات التى كانت تتلاحق فى عقله. أتخيل أنه كان يسترجع منفردا التاريخ كاملا. ما يعرفه وما نجهله مما حدث فى الغرف والاجتماعات السرية. أتخيل أنه كان يرى الجميع على حقيقته المجردة لا كما نراهم نحن. أتوقع أن السؤال الذى كان يدور فى ذهنه… هم ليه كدا؟ بيعملوا كدا ليه؟ خايفين ليه احنا قوة مع بعض.. وأتوقع أنه كان يفكر فى مشاعر المصريين ومعاناتهم عبر العقود الماضية..وأتوقع أنه شعر بمرارة لن ينساها أبدا.
(١٠)
ما الذى يجب أن يفعله المصريون الآن؟ رؤئيتى – التى جعلت الأحداث الأخيرة منها يقينا راسخا – أن المصريين قادرون على اجتياز اللحظة. مصر دولة عصية والمصريون شعبٌ عصىٌ على الكسر. فقط نحتاج إلى وقفة مع النفس المصرية. وقفة أنانية لا تثقل نفسها بما لا تحتمل وزره. مصر تحتاج الآن إلى إعلاء راية (الأمة المصرية). نربى عليها أبناءنا ونبذل العرق والجهد حتى نجلس مصر ما يليق بها من مجلس بين الأمم لا ما يريده لها بعض الأقربين وكل من ينتظر سقوطها. نريد أن نمصر هويتنا ونمصر حزننا وفرحنا. نريد أن نبنى هذا الوطن، ولا أقول أن نتخلى عن مكون الشرف التاريخى، إنما نطبق ما يطبقه الأفراد فى علاقاتهم..حب نفسك أولا! بعضا من الأنانية المشروعة أيها المصريون تنجو بها مصر وننجو معها!