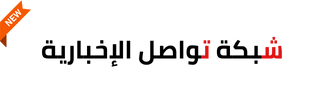د. جمال الهاشمي: العلاقات السعودية الإيرانية بين الانغلاق والفتح

د. جمال الهاشمي
الزيارة التي كانت من الممكن أن تمر بهدوء ضمن سلسلة تفاهمات ما بعد بكين اختارات ان تصفع أبواب التحليل التقليدي وتفتح فصلا جديدا من الواقعية السياسية العربية حيث لا مكان فيه للمجاملات ولا وقت للخطوات البطيئة أو التباطؤ العقيم.
إن ما مضى من وقت يكفي لأن يكون محددا للعقل السياسي فالانهيارات لا تأتي دفعة واحدة وإنما تتخطفها تفكيرات مغلقة وخطوات خاطفة.
الأرض التي تستوطنها تركيا ومصر وايران والسعودية وباكستان ودول آسيا الكبرى هي ضمن منطقة الارتطام ولكنها تختلف في نوعية الارتطام وجهاته في علم الاستراتيجية والهيمنة العسكرية.
السعودية التي تقع ايضا ضمن إقليم تتجاذبه القوى الدولية والاقليمية هو أيضا من التحديات التي فصلت العمق عن القلب، فاليمن العمق الاستراتيجي للسعودية على مستوى الاقليم والسعودية قلب للجزيرة العربية وقلب لليمن لا يمكن الاستغناء عنه ، وبقية دول الخليج أطرافا لاستراتيجيات القلب والعمق وأحزمتها الدفاعية إذا ضاقت جغرافية الشام والعراق والقرن الافريقي بالصراعات، وهنا يجب إدراك أن آخر معاقل الأمن في جزيرة العرب يكمن باتصال العمق بالقلب، وأن أي تفكير خارج هذا السياق يعد عبثا أمنيا، فالأمن يتشكل من الداخل ولا يأتي من الخارج.
الأمير خالد بن سلمان لا يزور طهران بوصفه وزيرا للدفاع فحسب بل بوصفه ممثلا لمرحلة سعودية -عربية جديدة ترفض منطق الدوران في الفراغ بل هو تجديد محاولات تأسيس تحالف إسلام الذي سبق ودعا إليه محمد بن سلمان في مرحلة شهدت توترا متصاعدا للمعتقدات السياسية، تلك المعتقدات التي أستدرجت تحت مفاهيم الثورة والخلافة والديمقراطية والتحولات الدينية والمدنية، وتحت مظلة ألفية النبوات لابن حماد والمهدية للفكر الآخر، لكنه تحالف اسلامي برؤية جديدة لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، وهنا منطق الواقعية السياسية التي تقود الى وحدة جغرافية أمنية مشتركة، وهنا لا مجال لتوظيف المعتقدات.
تلك المعتقدات التي اشعلت فتيل الطموح للدول الاقليمية الكبرى هي نفسها التي حولت الدولة إلى وقود لملاحم النهايات والتي هي تجديد لنفس ملاحم التاريخ المتكرر التي تجددت فيها الفكرة عبر تخيلات الفكر الإرادي والطموح السياسي ، وهنا تكمن إشكالية الفكر الديني، فالمهدية كما هي الخلافة من المفاهيم الجبرية التي يأذن الله بها في زمن لن يكن للمسلمين دورا في تحقيقها وإنما تأتي من خلال ارهاصات وعلامات ومؤشرات يقينية وليست تأويلية ينخرط الناس بها وفقا لأدلتها لا يكون فيها مجالا للتأويل، وإنما الدليل فيها عين اليقين.
ومع أحاديث الفتن جاءت التوصيات النبوية بالدعوة لاعتزالها واعتزال كل مقدماتها حتى تتضح الرؤية.
وهو ما يناقض فكر الاسلمة المعاصر الذي خلط بين أسلمة المفاهيم التاريخية وأسلمة المفاهيم الغربية الوافدة، مما أسس لفكر ألفي إسلامي على غرار الألفية الانجيلية وعمل على تسريع التحولات تحت مظلة المفاهيم الدينية حتى لو كان الثمن التضحية بالسلم والمجتمع والتنمية الدولة، هنا في الفكر الملوط نشأ مفهوم التضحية والموت كقيمة مقدسة في ذلتها وليس كقيمة دفاعية للحفاظ على السلم والأمن والتنمية والحياة.
وهي نفس الثقافة التلمودية التي تؤمن بالتحولات العنيفة ولو كان ثمن ذلك التضحية بنصف الشعب ليعيش النصف الآخر وهذه الرؤية هي التي تهيمن على منطق السياسة الأمريكية المتطرفة وسياسة المعتقدات المقاومة، وجميعهما يساهمان في تفكيك وحدة الإسلام والارتقاء بوعيه لتقييم المخاطر.
وتجنيد هذه المعتقدات والدول القطرية للصراع بالنيابة عن الآخر تحت مظلة الدفاع عن مصالحها.
ومن خلال هذه المنطق الوعي للدبلوماسية السعودية بعد تجارب معاصرة لم يأت خالد بن سلمان ليصافح أو يناور مناورة سياسية بل ليقول إن المنطقة لا تملك ترف الانتظار عند أبواب مغلقة وإن لحظة الخيارات الحاسمة قد حلت، وأن المصالحة هي الطريق الأقل كلفة والأكثر ربحا، و هو هنا لا يطرق الباب كفرد يقارب بين الرؤيتين بل كمبعوث عن رؤية تتجاوز الأسماء وترى أن الشرق إن لم يبادر بفتح أبوابه للحوار فستفتح عليه أبواب النيران، وحينها تكون التحولات الجبرية بجيل مرهق بالصراع والأزمات والجهل والفساد.
الزيارة لا تقرأ في سطرها الثنائي الضيق بل ضمن مشهد إقليمي ودولي معقد في الخلفية تتقدم مؤشرات التحول العالمي نحو صراع متعدد الأطراف.
القوى العظمى تعيد تموضعها وتبحث عن مساحات رخوة لتصريف توترها المتصاعد والشرق الأوسط كما اعتاد التاريخ يبدو مرة أخرى المرشح الأمثل لاحتضان الارتطام الكبير والصراع بين القوى، لأن مصلحة القوى في هذا العالم وستظل المنطقة حتى قيام الساعة مسرحا لأطماع الشرق والغرب لأن هذه المنطقة قلب العالم وسرتها وعمقها ومركزها وهي عبر التاريخ تصنع الحضارات والفكر وتقود العالم، إلا أن كبوتها المعاصرة بسبب قريتها وجنسياتها المتعددة وتعدد نقودها والصراع على الزعامة والاحتماء بضغائن التاريخ الوضعي ومفاسده.
هكذا يلوح طيف ترامب في الأفق لا كمرشح انتخابي فقط بل كمؤشر على عودة المدرسة التي تؤمن أن النار إن اشتعلت خارج حدود أميركا فستدفئ الداخل وتنهك الخصوم
وسط هذا المناخ تتحرك السعودية من منطلقين:
أولا أن علاقتها بطهران لا يمكن أن تظل رهينة للذاكرة وحدها بل يجب أن تبنى على قراءة جديدة للمصلحة والممكن.
وثانيا أن إعادة ضبط العلاقات الإقليمية ضرورة وليست ترفا دبلوماسيا لأن الفراغ في السياسة لا يدوم وإن لم يملأ بإرادة أهل المنطقة ملأته حسابات الآخرين.
ثالثا: أنه لا يمكن أن ينتصر أي من الأطراف على الآخر ما دام الصراع يغذى بتدخلات دولية، تحاول كل دولة أن تجر منافسيها الدوليين للدخول في صراعات بالنيابة ولو كان ذلك تحت مظلة العقيدة والدين الإسلامي، فالسياسة الأمريكية لا تعرف المبادئ، وإنما منطقها منطق الهيمنة وأن الحلفاء إن لم يكونوا أحزمة ملتهبة للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي فهم في خانة الأعداء، وأن فناء الأعداء والحلفاء سيان في منطق الفكر الديني الأمريكي المعاصر.
طهران من جهتها تقرأ اللحظة بعين مثقلة بالتجارب هي تعرف أن اليد السعودية لا تأتي كامتداد للغرب بل كموقف ناضج في منطقة الشرق الأوسط ووعي بهذه المنطقة التي ن لم تكن قائدة تصبح على الهامش في جغرافية التجاذبات والصراعات الدولية، وأن منطقة الشرق الأوسط لم تعد تحتمل المزيد من الحرائق، و أن مرحلة المساومات الغامضة أو التوسع على حساب الانهيارات قد قاربت على الانتهاء، وأن البقاء مرهون بالقدرة على الانفتاح لا بالمناورة، وعلى القدرة على تجنيب هذه المنطقة من مخاطر الانزلاق التي يكون فيها المنتصر كالمهزوم
من جانب آخر يتجلى التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرق في استخدام القوة الصلبة لنشر المعتقدات أو فرض الهيمنة فالقوة العسكرية أو السياسية لو كانت هي السائدة ستؤدي إلى تفكيك المنطقة وستحولها إلى قطع متناثرة في أتون الآخرين إن القوة الصلبة لا تحسم النزاع فقط بل تؤدي إلى تسريع الانقسام الداخلي الذي يزج بالمنطقة في تبعية تحكم بأغلال المصالح الدولية تاركة المنطقة في حالة من الفوضى المستمرة.
في المقابل هناك دروس يمكن أن يستفيد منها الشرق من تاريخه، فإن ثقافة الفتح المكي التي قادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية تمثل نموذجا آخر نموذجا للفتح الذي لا يعتمد على القوة بل على التأثير الثقافي الناعم، إن فتح مكة لم يكن مجرد انتصار عسكري بل كان فرصة للمصالحة والوحدة بين القبائل فترجمت تلك اللحظة إلى سياق مؤسسي وحدوي أسس لمرحلة جديدة قادة العالم من خلال المصالحة التي قاد إليها صلح الحديبية.
إن تأثير هذه الثقافة الناعمة التي تركز على المصالحة والتعايش هو السبيل الأكثر فاعلية اليوم لبناء وحدة قوية في الشرق الأوسط وإذا لم تجمعنا العقيدة في هذا العصر فإننا مطالبون بأن نتجاوز الانقسامات التي فرقتنا عبر المصالح الدنيوية الضيقة لنبني وحدة قائمة على المصالحة الحقيقية؛ المصالحة التي تقوم على الاعتراف بالآخر وليس بالانتصار عليه.
السيناريوهات بين الفتح المستقر والانغلاق المتوتر:
السيناريو الأول وهو الأكثر عقلانية أن تترجم زيارة خالد بن سلمان إلى طهران إلى خارطة عمل مشتركة تبدأ من أمن الممرات وتنتهي إلى شراكات اقتصادية مرورا بملفات اليمن وسوريا ولبنان والعراق في هذا السيناريو لا تنتصر الطموحات بل ينتصر الإدراك بأن التعايش أقل كلفة من التصادم.
السيناريو الثاني هو سيناريو الإيهام بالتقارب حيث تتبادل العواصم البيانات وتقدم الصور للصحف بينما تستمر الأجندات المتصادمة تحت الطاولة في هذا الاحتمال تتقدم الشكليات وتتراجع السياسات وتظل المنطقة رهينة الابتسامة الرمادية حيث لا حرب تحسم ولا سلم يبنى، وإنما صراع مستمر ينتهي بزوال الأنظمة والدول لصالح الجهويات والإثنيات والعرقيات ومزيد من الفوضى والصراعات المتأزمة.
أما السيناريو الثالث وهو الأسوأ فهو أن تتعثر المحاولة السعودية في ظل صعود تيارات التشدد داخل إيران والتشدد الأمريكي بقيادة ترامب، حينها قد يغلق الباب مجددا ولكن لن يغلق بهدوء بل بصوت ارتطام حاد ينذر بأن الباب القادم لن يطرق بل سيقتحم باستعمار يتساوى في نظره دماء العربي والفارسي والتركي ودم المسلم أيا كان لونه وشكله ولو كان الرجل الأشقر وما حرب الاسترداد إلا دليلا على أن قسوة العقيدة تكون على الأقرب أشد وطأة ، وأن الهجين من عرقين مختلفين أحط منزلة من الآخر المختلف من دماء واحدة.
في الختام منطق الباب:
منطق الباب هو منطق السيادة، أن تطرقه بيدك لا أن تنتظر من يفتحه لك، هكذا العلاقات السعودية الإيرانية تقف اليوم عند مفترق ليس بين سلم وحرب، بل بين فتح حقيقي وانغلاق قاتل.
الفارق هذه المرة أن السعودية لا تطرق الباب كدولة تبحث عن مخرج بل كقوة إقليمية تدرك أن تأخر الفتح يعني أن أحدا آخر سيكسر الباب لا على طهران وحدها بل على الجميع،
لن يكسر الباب بيد فرد ولا بمزاج دولة بل سيكسره قوى الفوضى التي تنتظر لحظة انهيار العقل العربي لتدفع بالمنطقة إلى مستنقع يأكل بعضه بعضا.
إن الذين أرادوا للشرق أن يتحول إلى مسرح فوضى عالمية سيكتشفون متأخرين أن نيران هذا المسرح لا تشعل الأطراف فقط بل تحرق كل ما يجاورها.
وإذا ما تواصل الانغلاق فسوف تسحب المنطقة في أتون الآخرين تُحرق بيد المصالح العابرة التي لا تعرف عواقب التفكك. أما إذا أتيحت الفرصة للفتح فستكتب قصة جديدة وحدة تصنعها المصالحة وتمدها الثقافة الناعمة التي تجمع بين المسلمين بدل أن تفرقهم، فالعقيدة إن لم تجمعنا فلا تحرقنا المصالح ولنق أنفسنا من التفكك قبل أن يسحبنا الآخرون إلى مستنقعاتهم، وختاما فليكن التفكير من داخل الباب لا على أبواب الصحافة وعلى قمم المنابر السياسية، فالعلاقات الثنائية المغلقة من أهم مجالات العمل الدبلوماسي المعاصر.