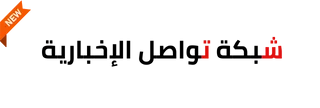هناء متولي لـ"الدستور": الكتابة في جوهرها فعل فني وإنساني

بالرغم من تباين مواقف المبدعين والنقاد تجاه مصطلح الكتابة النسوية بين القبول والرفض، ورغم شيوع استخدامه في الأوساط الثقافية، لا يزال هذا المصطلح يثير الكثير من الجدل والالتباس، بل إن الأمر يصل أحيانًا إلى اعتباره تهمة للكاتبات، بزعم أن أعمالهن تدور بشكل مفرط حول الذات النسوية.
وبينما يذهب بعض النقاد إلى أن الكتابة النسوية، تشير إلى أن المنتج الإبداعي محوره قضايا المرأة، دون اشتراط أن تكون كاتبة النص امرأة، وهو ما يرفضه البعض الآخر من النقاد ويرون أن الكتابة النسوية “يستشف منه افتراض جوهر محدد لتلك الكتابة تمايز فيها بين كتابة المرأة والرجل، وأنها قاصرة على كتابة النساء المبدعات فقط دون الرجال.
الكتابة في جوهرها فعلٌ فنيّ لكنها أيضًا فعلٌ إنساني
وحول هذه القضية، قالت الكاتبة هناء متولي، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”: “الكتابة النسوية ليست لعنة، بل وعيٌ يرفض الصمت، واللعنة الحقيقية هى مجتمعٌ يخشى هذا الوعي، فيحاول محاصرته حتى يدفعه إلى العزلة أو الجنون”.
حين يُقال إن الكتابة النسوية لعنة، فإن السؤال الحقيقي ليس عن الأدب، بل عن المنظومة التي تريد حبس الكاتبات في زوايا ضيقة، وكأن وجودهن في المشهد الأدبي تهديدٌ يستدعي التصنيف والمساءلة، لكن الكتابة ليست لعنة، ولا وصمة، ولا حتى شعارًا سياسيًا مجرّدًا، إنها ببساطة فعل إبداعي، يُحكم عليه بجودته، لا بجنس كاتبه ولا بتسميته.
وأوضحت “متولي”: في جوهرها، الكتابة فعلٌ فنيّ، لكنها أيضًا فعلٌ إنساني، والتاريخ الأدبي لم يُصنَّف وفقًا لجندر كاتبيه، إلا حين بدأت النساء في انتزاع أماكنهن في المشهد. عندها فقط، ظهر هذا التصنيف كأداة تضييق، كإطار جاهز يوضع حول أعمال الكاتبات لإرهابهن، لإيهامهن أنهن يُكتب لهن مسبقًا موقعٌ ثانوي، مهما بلغت نصوصهن من العمق والجمال والتأثير. المفارقة أن الكتّاب الرجال الذين يكتبون عن قضايا النساء لا يُتهمون بأنهم “نسويون”، ولا يُختزل أدبهم في هذه الزاوية. لكن عندما تكتب امرأة، فكل ما تكتبه يُقرأ من هذه العدسة، وكأنها لا تستطيع أن تكتب إلا عن نفسها، أو كأنها لم تصل بعد إلى درجة “الأدب المحايد”، ذلك الأدب الذي اختزلته الذكورية لعقود في رؤيتها للعالم. هل هو خوف من المنافسة؟ ربما. لأن الصوت النسوي لا ينافس، بل يفضح، يكسر احتكار الحكاية، ويعيد توزيع الأضواء على الشخصيات التي ظلت لقرون في الظل.
واستدركت: لكن هذا الصوت لم يكن بلا ثمن. التاريخ الأدبي مليء بكاتبات دفعن حياتهن ثمنًا لامتلاك صوتهن. سيلفيا بلاث، التي كافحت في عالم أدبي يهمّش النساء، لم تحتمل ثقل العزلة والإحباط، فانتهى بها الأمر إلى الانتحار وهي في الثلاثين. فرجينيا وولف، التي كتبت عن احتياج المرأة إلى “غرفة تخصها”، أدركت في النهاية أن حتى هذه الغرفة لا تحميها من عالم يصادر حقها في الوجود، فأغرقت نفسها في نهر أوز. آن سيكستون، التي عاشت بين الجنون والعبقرية، بين الإبداع والانهيار، حتى سحبت نفسها إلى الموت في لحظة يأس.
الكتابة النسوية الصوت الذي يُسمع حين يُراد له الصمت
وفي العالم العربي، لم يكن الأمر مختلفًا. مي زيادة، التي وقفت في وجه مجتمع يرفض أن يرى المرأة كاتبة، انتهى بها الأمر في مستشفى للأمراض العقلية، محاصرة بالعزلة والقهر. وأروى صالح، الكاتبة والمفكرة التي فككت أوهام جيلها في “المبتسرون”، والتي لم تتحمل خيانة الواقع لحلمها، فسقطت من الطابق العاشر. وعنايات الزيات، التي كتبت عن الألم والعزلة في “الحب والصمت”، لكنها لم تجد من يسمع صوتها، فانتحرت قبل حتى أن يُنشر كتابها.
وشددت “متولي”: كل هذه الأسماء ليست مجرد قصص فردية، بل أدلة على أن التصنيف والقمع لم يكونا مجرد نظريات، بل أسلحة استخدمت ضد كل امرأة حاولت أن تمتلك صوتها. لم يكن الأدب بالنسبة لهن ترفًا، بل صراعًا يوميًا للبقاء في عالم يرى أن كتابة النساء ليست إبداعًا، بل خروجًا عن المألوف، خروجًا يستوجب العقاب.
لكن، ورغم كل هذا، لم تختفِ الأصوات النسوية. لأن الكتابة، في حقيقتها، ليست مجرد أداة تعبير، بل فعل مقاومة، فعل وجود، إنها فعل أنثوي، لا بالمعنى البيولوجي، بل بمعنى أنها وعيٌ عميقٌ بالتفاصيل، بالغموض، بالمسكوت عنه. إنها الصوت الذي يُسمع حين يُراد له الصمت، إنها الحكاية التي تكتب نفسها رغمًا عن كل التصنيفات، لأنها تعرف أن الأدب الحقيقي لا يخضع إلا لحقيقته الخاصة، لا لأي إطار يُفرض عليه من الخارج.