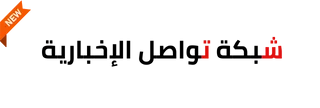هندسة الردع.. كيف حولت مصر التسليح إلى قوة دبلوماسية فى مواجهة جوار مشتعل وإقليم مضطرب؟

فى شرقٍ تملؤه الصراعات، وجنوبٍ يتهاوى على وقع الحروب الأهلية، وغربٍ تعيث فيه الميليشيات فسادًا، وفى شمالٍ تُعاد فيه صياغة خرائط الطاقة والنفوذ، تتحرك مصر ليس برغبة فى الهيمنة، بل بحتمية منطق الجغرافيا وتاريخ البقاء.فالمنطقة من حولها تشهد انهيار مفاهيم الدولة، وتكاثر قوى إقليمية صاعدة أو مشاغبة، وعالم لا يمنح الأمن إلا لمن يملك القوة الكافية لصناعته، لا طلبه. هنا لا يصلح الحياد، ولا تنفع مثالية الانتظار، بل تستدعى الضرورات الأمنية والاعتبارات الاستراتيجية أن تبنى مصر قوتها، لا كمخزون للسلاح، بل كرصيد من الردع قادر على كبح الطامعين واحتواء المتغيرات. لذلك، فإن السؤال عن «لماذا تتسلح مصر؟» لا يُجاب عنه برقم ميزانية أو عدد الغواصات، بل يُفهم فقط من عمق مشهد إقليمى متشابك ومتغير، يحتاج إلى أكثر من مجرد تحليل عابر أو رأى فى مقال محدود، إننا أمام واقع صعب ومعقد، لا يُواجه إلا بدولة تمتلك اليد الطولى، ولكنها تدرك أن اليد القوية لا تعنى بالضرورة العدوان، بل الاستقلال.ما يُثار اليوم فى بعض الموضوعات، التى تدعى جهدًا استقصائيًا كبيرًا حول دوافع التسلح المصرى، يشبه نقاشًا على المقهى أو تحليلات سريعة لا ترى من المشهد إلا سطوحه مع ادعاء العمق، ويتجاهل أن قرار التسلّح فى دولة مثل مصر لا يُفهم إلا ضمن ثلاثية «الأمن والتاريخ والمكان»، ذلك أن الجغرافيا نفسها كانت ولا تزال لعنة ونِعمة تطلّ على ممرات استراتيجية، وتجاور هشاشة مزمنة، وتُصارع على النيل الذى بات ساحة لتجاذب إقليمى عابر للقارات. أسئلة غير بريئة تتبنى وجهة نظر الاحتلال المثير للدهشة أن من كتبوا وتساءلوا فى تحقيقات قالوا إنها استقصائية، كان سؤالهم الأساسى والرئيسى: لمن تشترى مصر كل هذا السلاح؟هذا السؤال وصل إلى حد التطابق مع أسئلة أخرى شبيهة أطلقها مسئولون فى دولة الاحتلال الإسرائيلى بنفس الشكل، ففى شهر يناير الماضى، أى منذ نحو ٣ أشهر ونصف الشهر، تساءل مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانى دانون، عن أسباب اقتناء الجيش المصرى معدات عسكرية حديثة رغم عدم مواجهة البلاد أى تهديدات.وأقتبس من كلامه وقتها: «إنهم ينفقون مئات الملايين من الدولارات على المعدات العسكرية الحديثة سنويًا، ومع ذلك لا يواجهون أى تهديدات على حدودهم»، وتساءل: «لماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟.. بعد ٧ أكتوبر، يجب دق ناقوس الخطر، لقد تعلمنا الدرس، يجب أن نراقب مصر عن كثب ونستعد لكل سيناريو»، مضيفًا: «علينا أن نسأل الولايات المتحدة عن سبب حاجة مصر إلى كل هذه المعدات».هذا الكلام رددته إعلامية، المفترض أنها مصرية، ولكنها تحتمى بجنسيتها الثانية المكتسبة مرة تلو الأخرى من مهاجمة مصر وقيادتها بشكل مستمر طمعًا فى صعود للسلطة لم يكتمل، لذا تدس كل السموم فى قليل من العسل فيفضح السم نفسه مهما حاول التخفى وراء براءة العسل.فلماذا تتسلّح مصر إذًا؟ وما الذى تغيّر فى معادلات الإقليم حتى باتت القاهرة ترى فى الردع ضرورة لا خيارًا؟ وهل نحن أمام مشروع توسّع، أم استراتيجية بقاء فى عالم لا يرحم الضعفاء؟. القرن الإفريقى والبحر الأحمر قواعد النفوذ الجديدة القرن الإفريقى لم يعُد محايدًا فى الصراعات الإقليمية. فالتنافس بين تركيا، الإمارات، إيران، وإسرائيل فى إريتريا وجيبوتى والصومال، حوّل المنطقة إلى رقعة شطرنج محاطة بالألغام، لم يكن ممكنًا لمصر أن تقف على الحياد وهى ترى الموانئ تتغير أعلامها، والممرات البحرية تُدار بسلطة الأمر الواقع.من هنا جاء المشروع العسكرى المصرى فى قاعدة برنيس جنوب شرق البحر الأحمر، وتُعد هذه القاعدة، التى افتُتحت فى يناير ٢٠٢٠، واحدة من كبرى القواعد العسكرية فى إفريقيا، وتحتوى على ميناء عسكرى، ومطار، ورادارات استراتيجية، ومناطق إيواء بحرية، والهدف منها مزدوج: أولًا حماية الملاحة فى البحر الأحمر وخليج عدن، وثانيًا رسم خريطة نفوذ جديدة، تُثبت لمنافسين محتملين أن القاهرة عادت لاعبًا بحريًا لا يمكن تجاهله.وتُشير تحركات الأسطول الجنوبى المصرى، وتكرار المناورات البحرية مع السعودية والإمارات، إلى أن البحر الأحمر لم يعُد مجرد شريط مائى، بل حدود جيوسياسية متغيرة تتطلب أدوات عسكرية مرنة وسريعة الاستجابة. أزمة السد والبُعد النيلى.. حين تتحول المياه إلى أداة صراع سد النهضة ليس مجرد مشروع تنموى، بل هو أداة جيوسياسية بامتياز، منذ أن بدأت إثيوبيا إنشاءه فى ٢٠١١، تدرجت القاهرة فى التعامل معه من الإنكار، إلى التفاوض، إلى الضغط الدبلوماسى، وصولًا إلى التلويح بالقوة. ولم تكن تلك مراحل عبثية، بل محطات اضطرارية فى رحلة البحث عن ضمان تدفق النيل الذى يشكّل أكثر من ٩٥٪ من موارد مصر المائية.لكن التهديد الحقيقى لم يَكُن فى قدرة السد الفنية، بل فى النهج الإثيوبى الأحادى الذى يتجاهل قواعد القانون الدولى الخاص بالأنهار العابرة للحدود، ولأن المياه صارت تُستخدم كأداة للهيمنة السياسية، كان من الطبيعى أن ترد مصر ببناء أدوات ردع غير مائية.الرد المصرى تجلّى فى محاور متعددة:- تحريك الجبهة الدبلوماسية الدولية، عبر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، رغم إدراك محدودية تأثيرها العملى دون قوة ردع ميدانية موازية.- تعزيز الشراكات العسكرية فى حوض النيل: توقيع اتفاقيات تعاون أمنى مع أوغندا، بوروندى، جنوب السودان، وكينيا، وصولًا إلى تدريبات عسكرية مشتركة مع دول إفريقية غير مطلة على النيل، لكنها ذات وزن فى توازنات الاتحاد الإفريقى.- تطوير القدرات الجوية والاستطلاعية: خصوصًا مع اقتناء مصر طائرات رافال الفرنسية، والطائرات دون طيار Wing Loong الصينية، مما يزيد من قدرتها على الوصول السريع إلى العمق الإثيوبى إذا اقتضى الأمر. كل ذلك يُشير إلى أن التسلح فى هذا السياق ليس خيارًا، بل استجابة لبنية جديدة من الصراعات، حيث تتحول المياه إلى «نار هادئة» تستدعى من القاهرة أن تحتفظ بإطفائية استراتيجية جاهزة دائمًا. الجغرافيا.. العبء الثقيل الذى تحمله القاهرة على أكتافها منذ انقلاب موازين الإقليم فى أعقاب ٢٠١١، ومرورًا بتحولات النظام العالمى إثر الحرب فى أوكرانيا، لم تعد مصر ترى أمنها القومى فى حدود أراضيها فقط، فبين حدود ملتهبة فى ليبيا والسودان، وبين شريان مائى مهدد فى إثيوبيا، وبين شرق أوسط يضجّ بالتقلبات، بات لزامًا على القاهرة أن تُعيد تعريف مجالها الحيوى، ليس كترف استراتيجى بل كضمان للبقاء.حين تُطل مصر على سبع دول جوار، وتجاور ثلاثة بحار، وتتحكم فى ممر ملاحى عالمى، فإن كل اضطراب على حدودها ينعكس مباشرة على عمقها. هذه ليست مجرد خرائط، بل حسابات ميدانية تُترجم فى شكل عقود تسليح، وتدريبات مشتركة، ونقل تكنولوجيا عسكرية، وتطوير لقدرات الردع بعيد المدى.منذ ٢٠١٤، اتخذت مصر منحى تصاعديًا فى إعادة بناء منظومتها الدفاعية. لم تَعُد تعتمد على مصدر واحد للتسليح، بل فتحت أبوابها أمام فرنسا، وألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وفى بعض الأوقات الصين. لم يكن ذلك مجرد تنويع تقنى، بل رسائل ضمنية بأن مصر باتت تُعيد تموضعها بعيدًا عن التبعية التقليدية للولايات المتحدة. فى الشرق الأوسط مصر والتحالفات المتبدّلة السياسة الخارجية المصرية معروف عنها أنها متوازنة ومستقلة، فالعبرة بالنتائج وليس بانتهاج أساليب الصوت العالى ومحاولات «الشو» على حساب الوطن والمواطن، فمثلًا بعد فترات من الفتور مع تركيا، أعادت القاهرة رسم علاقاتها استنادًا إلى المصالح لا الأيديولوجيا.ففى العلاقة مع تركيا، وبعد سنوات من الخصومة، شهدت الأشهر الأخيرة عودة تدريجية إلى الحوار الاستراتيجى. لم يكن ذلك حبًا بقدر ما هو إدراك متبادل بأن البحر المتوسط لا يحتمل تصادم القوى الكبرى فيه، وبالنسبة لمصر، فإن تثبيت التفاهمات حول ليبيا وغاز شرق المتوسط كان سببًا كافيًا لإعادة فتح القنوات.أما مع دول الخليج، فالتعاون الدفاعى والاقتصادى يبقى أحد أعمدة السياسة المصرية، خصوصًا فى ظل الاستثمارات السعودية والإماراتية الضخمة. وقد شاركت القوات المسلحة المصرية فى عدة مناورات مشتركة كانت لها دلالات رمزية وعسكرية فى آن واحد، مثل: «سيف العرب» و«درع الخليج» و«رعد الشمال»، كلها رسائل بأن مصر ليست مجرد شريك رمزى، بل عمود فقرى فى أى ترتيبات أمنية مستقبلية للمنطقة. ليبيا والسودان.. حدود تنزف وبوابات مفتوحة على مشروعات التفتيت لم تعد الحدود الغربية والجنوبية مجرد خطوط جغرافية، بل بوابات مفتوحة على مشاريع تفتيت وتحالفات متقاطعة فى ليبيا، ولا تزال مصر تنظر إلى الصراع كمعركة على أمنها الداخلى، لا مجرد جيرة مضطربة. الميليشيات التى تسيطر على الغرب الليبى، بدعم تركى مفتوح، تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار المنطقة الشرقية، الحليف الاستراتيجى للقاهرة. لذلك، كان دعم مصر الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر خيارًا بديهيًا، لا من باب التدخل، بل من منطلق «الدفاع الاستباقى».هذا الانخراط انعكس على عدة مستويات، تدريب عناصر الجيش الليبى فى الأكاديميات المصرية، وتقديم دعم لوجستى واستخباراتى، فضلًا عن مناورة «حسم ٢٠٢٠» التى أُجريت قرب الحدود الغربية كرسالة واضحة.أما فى السودان، فقد أصبح السيناريو أكثر تعقيدًا. الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل ٢٠٢٣، حوّل الخرطوم إلى ساحة حرب بالوكالة. ومصر، التى تحتفظ بعلاقات تاريخية مع الجيش السودانى، تجد نفسها محاطة بفراغ أمنى على طول أكثر من ١٢٠٠ كيلومتر من الحدود المشتركة.لكن المعضلة الأكبر هى إمكانية تحول السودان إلى بوابة نفوذ غير صديق، سواء عبر ميناء بورتسودان، أو من أطراف إقليمية أخرى لها مصالح فى زعزعة التوازن الحدودى المصرى. لذا، رفعت مصر من تأهبها العسكرى فى جنوب الوادى، وكثّفت المراقبة الجوية والاستخبارية، ما يبرر ضمنيًا صفقات التسليح الجوى واللوجستى فى السنوات الأخيرة. السيسى يحسم نظرية الردع: «قادرين نكررها فى كل مرة» بالنظر إلى طبيعة التسليح، تبدو موازين القوى بين مصر وإسرائيل غير قابلة للقياس العددى المجرد، بل تتداخل فيها عناصر الجغرافيا، والعمق الاستراتيجى، والتكنولوجيا، ووسائل الردع، ما يجعل المقارنة بينهما رهينة بسيناريوهات الاستخدام، لا بمجرد قوائم التسليح، فرغم أن إسرائيل تمتاز بالتقنية والتكنولوجيا، فإن مصر تمتلك تفوقًا عدديًا وامتدادًا جغرافيًا وعمقًا استراتيجيًا، يجعل من قدرتها على خوض حروب تقليدية فى مساحات واسعة أكبر، بينما تعتمد إسرائيل على التقنية، ودعم أمريكى وغربى لا ينقطع، وردع نووى غير مصرح به، ورغم ذلك لا يزال ماثلًا أمامنا حتى اليوم انتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣، الذى حطمت به مصر أسطورة الجيش الذى لا يُقهر واليد الطولى لإسرائيل. هم فى إسرائيل يدركون هذا الأمر ويعرفون أنه لم يعد من الممكن أن يكرروا خديعة و«بروباجندا» حرب الأيام الستة كما فعلوا فى ١٩٦٧، الأمر أصبح يشكل لهم عقدة بعد انتصار ٦ أكتوبر ١٩٧٣ والذى أصبح فى عظمته ورمزيته وذكرياته السوداء بالنسبة لهم رادعًا نفسيًا، إلى جانب الردع العسكرى الذى بنته وما زالت تبنيه وتواصل تعليته، حتى حسم الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرية هل الردع مستمر مع السلام أم لا؟ فى الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة فى ١١ أكتوبر ٢٠١٨، عندما تحدث عن انتصار الجيش المصرى على جيش الاحتلال الإسرائيلى قائلًا: «إذا كان الجيش المصرى قدر يعملها مرة، فهو هايبقى قادر يعملها كل مرة».وتغير موازين القوى العالمية، لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أثّر بشكل مباشر على سوق السلاح والتحالفات الأمنية. مصر، التى عانت من بعض القيود الغربية على التسليح، فتحت خطوطًا جديدة مع عدة دول أبرزها روسيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين، حتى لا تظل أمريكا المصدر الوحيد للسلاح لظروف سياسية وعالمية حدثت منذ نهاية عقد السبعينيات حتى عام ٢٠١٣، ومع تنويع مصادر السلاح يُلاحظ أن مصر طوّرت قدرات بحرية وجوية كجزء من استراتيجية مرنة لردع الخصوم فى أكثر من اتجاه.لم تعد القاهرة ترى فى واشنطن الضامن الوحيد، بل أحد اللاعبين، وقد استخدمت أدواتها السياسية «مثل قناة السويس، والدبلوماسية الإقليمية» إلى جانب أدواتها العسكرية لبناء توازن ذاتى يعزز استقلالية القرار. السلاح أداة دبلوماسية من السهل السقوط فى فخ توصيف «التسلّح» كسباق غير مبرر، خصوصًا إذا اقتُطع من سياقه الجيوسياسى. لكن الأرقام- رغم تصاعدها- تشير إلى أن الإنفاق المصرى لا يزال أقل بكثير من جيرانه مقارنة بالناتج المحلى.الحديث عن التسلّح لا يُفهم بعيدًا عن التحديات الاقتصادية، نعم، هناك ضغوط على الميزانية، ولكن فى عُرف الدول قد يكون امتلاك القوة العسكرية الفعالة أرخص من دفع ثمن الضعف الذى يجعل من التدخل الأجنبى أو محاولات اقتطاع جزء من الأرض أمرًا واردًا فى حالة وجود دولة لا تستطيع الدفاع عن نفسها تجاه ما يحيط بها من أخطار، أو حتى حماية مقدراتها وثرواتها، والمنطقة حولنا تزخر بالأمثلة، من سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، إلى السودان، إلى قبرص.فى النهاية، لا يمكن قراءة استراتيجية التسلح المصرى إلا باعتبارها نتاجًا لتفاعل مركّب بين الجغرافيا، والتاريخ، والتحديات المتجددة، فمصر لا تتحرك فى فراغ، ولا تتعامل مع عالم يتسم بالسلام والاستقرار، بل مع محيط مشتعل وحدود تنزف ومصالح تُخترق كل يوم. التسلح هنا ليس فعلًا هجوميًا، بل هو رد على صخب صامت يجرى فى العواصم القريبة والبعيدة، وعلى محاولات لإعادة تشكيل الشرق الأوسط دون أخذ مصالح القاهرة فى الاعتبار، وقد فهمت مصر أن امتلاك السلاح، وتطويره، وتوظيفه فى إطار دبلوماسى محسوب، هو الضمانة الأهم لبقائها لاعبًا لا ملعبًا، وفاعلًا لا مفعولًا به، ولذلك، فإن كل غواصة، وكل طائرة، وكل تدريب، لا تُقرأ من زاوية الإنفاق، بل من زاوية الصراع على البقاء فى عالم لا يمنح مساحات للأقوياء إلا إن انتزعوها.