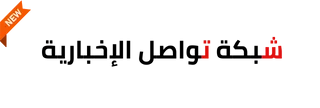الكمسارى

الجو اليوم لا يطاق، الرطوبة تخنق الأنفاس، وتحجب جنين الشمس البرتقالى المتخلق من خلفها بقسوة، رائحتها تغمر الهواء فى لزوجة وعطن منفرين، فى بداية مقدمى للبلد كنت أنزعج لهبّاتها، أتململ أكثر شىء للماء المنسكب دون مناسبة يغرق جسدى، لكن ومع مرور الوقت اعتدت عليها. هذا الصباح ركبت الأتوبيس رقم ١٨، الوحيد الذى يمر بالقرب من مكان عملى، أنتظره فى عذاب وسط حشد غفير من الموظفين ضاق بهم الرصيف، تخنقنى الرائحة الطافرة من أجساد الهنود، خليط عفن يهب يزكم أنفى بنكهات حريفة تشبه التراب المندى، أو بالأحرى الأعشاب المطمورة. فوق كرسى وثير استراح جسدى أخيرًا، استسلمت فورًا لهبات المكيف الباردة، وعلى وقع دمدمة أصوات آسيوية غير مميزة تركت رأسى المثقل وشأنه، غفوة قصيرة لن تضر، مرت دقائق قبل أن أنتبه لصوت غليظ بلكنة مصرية جنوبية، شاب أسمر نحيف فارع العود، يمرر سبابته فى ضجر ينتح حبات العرق المتكومة فوق جبهته السمراء العريضة، من جوار السائق، ابتسم ابتسامة مرة كأنها عصارة قلبه، قائلًا: «تذاكر.. تيكيت»، لم يستغرق الأمر طويلًا، سريعًا أنهى عمله، ليلقى بنفسه للشارع حيث كان.منذ عامين بالتمام، اشتهت نفسى هذه الوظيفة، قرأت خبرًا فى صحيفة يومية «مطلوب مفتشون»، أضاءت وجهى الفرحة، وقد تزخر غدى بالآمال الجميلة، أشار علىّ أبناء الحلال بالتقدم، هى أضمن من غيرها، مرتب منتظم، إقامة ثابتة، وحياة جديدة تنقذك من وطأة هذه الأيام الكئيبة، هذا ما اتقفت عليه الآراء. فى صباح يوم فاتر لا تزال ذكراه الذابلة معلقة بخيالى المجهد، تأبطت حافظة أوراق حُبلى بالمستندات، كانت خصلة من شعر الشمس صفراء ملتهبة ساقطة فوق الحيطان الظامئة، لا يزال الوقت مبكرًا، لكن رائحة «الطعمية» الساخنة تتلاعب بأنفى، وكأنى أشمها لأول مرة، لأول مرة أشعر بالحنين للوطن، للبيت والأسرة، لأمى وأخوتى الصغار، أشعر بيد الغربة الغليظة تمسك بتلابيبى، تعتصر قلبى، تطاردنى خيوط الرائحة محملة باللذة، فى تشهٍّ تتبعت مصدرها، لا أعلم لماذا رقص قلبى فرحًا، وشعور غامر بأنى ما زلت على قيد الحياة يشملنى، التهمت فى لمح البصر رغيفين، تجشأت على استحياء فى ارتياح من لا تعدل الدنيا عنده جناح بعوضة، أكمل النشوة صوت السيدة «أم كلثوم» المنبعث من فجوة بالمطعم، تغرد بلحن شجى، هززت رأسى فى تفاؤل، تجولت عينى فى المبنى، حتى استقرت فى ركن بعيد، طالعنى موظف عجوز بعين باردة من خلف الزجاج، هرش ذقنه المغبرة وهو يتثاءب، ويده تدق أوراقًا بيضاء بختم كبير، وقبل أن أسأله حدجنى بغير اكتراث، لتغيم من بعدها الدنيا فى وجهى، لم ينقذنى من هذه الوحلة غير شخص، بدت ملامحه مصرية، ألقى إلىّ بابتسامة مهتزة، شجعتنى على الاقتراب منه، لأقول بصوت متكسر: «أريد التقديم فى وظيفة المفتش»، نظر نحوى بإشفاق، ووجهه يكسوه الاهتمام، أجابنى وهو يخفى ضحكته فى صدره: «بعد قليل، سيحضر الأستاذ ناصر يستلم منك الطلب، هو فى شباك ٦»، عندها اضطربت النظرات فى عينى، بلعت ريقى بصعوبة بالغة، ليزداد ضجيج الأفكار فى رأسى، وشيش مزعج، لا أعرف لماذا استدعيت صورة المفتش بزيه المميز، القميص الأصفر، البنطلون الكحلى، نظراته الواثقة، مشيته وسط الأتوبيس فى استعلاء، يده الخشنة تمزق التذاكر بلا رحمة، استماع السائق لنصائحه فى خشوع وسكينة، ليدب من بعدها النشاط فى جسدى الهامد، تحركت فى الممر أطالع فى ونس مفاجئ وجوه الموظفين المثقلة ببقايا الأمس، نعاس وإرهاق، وتحايا الصباح تلقى فى إهمال فاترة، دقائق وضج المكان بالأصوات تهدر، اختلطت روائح الأكل، تناوب السعاة فى تقليب الملاعق داخل أكواب الشاى، وضحكات تصدر من أفواه محشوة بالطعام من هنا وهناك.صدقنى، حتى اللحظة لا أعرف مصير طلبى، لكن ما زالت تطوف برأسى ملامح الموظف الثلجية، وهو يغالب ابتسامة ساخرة، ولسان حاله يردد فى خبث: «مسكين، ستعلم أيها البائس ذات يوم ألا تصدق كل ما تراه».