نبيل نعوم يكتب: العلامة والرمز
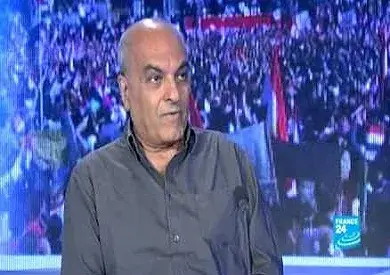
تُستخدم العلامات والرموز كثيرًا في كل من الحِرَف اليدوية والفنون التشكيلية، وإن كانت هي أساس تطور اللغات المكتوبة. وعادةً ما يُستخدم الرمز للإشارة إلى ما يمثل فكرة أو شيئًا أو شعورًا. وغالبًا ما تكون الرموز ثقافية أو دينية أو تاريخية، كالنسر مثلًا كرمز للحرية. كما يمكن لأي شيء كإيماءة أو صوت أو كلمة أن يكون رمزًا. أما العلامة، فهي شيء مادي أو صورة تُستخدم لنقل رسالة محددة، مثل النور الأحمر في إشارات المرور للتوقف.
وقد برع قدماء المصريين في استخدام الرموز كأساس للغة مكتوبة وأيضًا منطوقة، تطورت كتابتها بخطوط مختلفة من النقش المقدس المعروف بالخط الهيروغليفي إلى الديموطيقي، ثم إلى القبطي المكتوب بالحروف اليونانية مع إضافة عدد من الحروف ذات أصول ديموطيقية.
تتضمن اللغة الهيروغليفية العديد من الرموز، وقد قسّمها عالم الآثار واللغات الشهير السير ألان جاردنر إلى فئات مثل: الرجال والسيدات والآلهة، وأجزاء جسم الإنسان، والثدييات، والطيور، والزواحف، والأسماك، والشجر، والنباتات، والحرف والمهن، وأنواع الأثاث والملابس والتيجان والأطعمة، وغيرها. كما تشمل علامات تدل على الحركة والجلوس والقيام.
وحسب كتاب ريتشارد مدهيرست عن فك رموز الإيموجي، نجد أن الإيموجي (Emoji) هي مجموعة من الرموز التي تُستخدم للتعبير عن المشاعر أو الأفكار في الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وكلمة “إيموجي” مأخوذة من اللغة اليابانية وتعني “صورة رمز”. والإيموجي حاليًا ليس مجرد صورة تعبّر عن كلمة، بل إشارة إلى الحالة العاطفية التي نختبرها أثناء الحديث مع شخص لا نراه.
بدأ استخدام الإيموجي في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت البداية برموز بسيطة تعبر عن المشاعر. ثم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الرقمية العالمية، ولم يعد استخدامها مقصورًا على الرسائل النصية ووسائل التواصل، بل نراها في جداريات كبيرة مثل تلك الموجودة في محطة مترو شاتليه بباريس. وتشمل هذه الرموز الآن رموزًا تتعلق بالطعام والشراب والمعالم والأثاث، كما كانت رموز اللغة المصرية القديمة من قبل. وحتى عام 2019، كان قاموس الرموز الرقمي يضم نحو 1700 إيموجي.
تشارك العلامات والرموز ذات الدلالة التشكيلية في تحقيق مكاسب اقتصادية تسهم في التنمية، خاصة في المدن والقرى التي تعتمد على الصناعات والحِرَف اليدوية كمصدر رئيسي للدخل. ومن الأمثلة على ذلك: صناعة الفخار في قريتي النزلة وتونس بالفيوم، وصناعة النسيج اليدوي في مدينة أخميم بسوهاج، وصناعة الكليم في قرية أبو شعرة بالمنوفية ومدينة فوة بكفر الشيخ، وصناعة النسيج والحِلي في قرية الحرانية بالجيزة، وفي جنوب سيناء على يد الفتيات والسيدات.
تبدأ أحيانًا رحلة الرمز والعلامة في الفن اليدوي التقليدي من التراث الشفهي المرتبط بالوعي الجماعي، المرتبط بدوره بالموسيقى والغناء والشعر، لينتقل إلى المنتج الحرفي كالسجاد والكليم والتطريز والفخار وتزيين جدران المنازل والوشم والنقش بالحناء وصناعة الحُلي، وغيرها. ويُلاحظ ذلك في استمرار ظهور الرموز المرتبطة بالثقافة الأمازيغية كلغة وحرف في العديد من الأعمال اليدوية بالمغرب العربي.
ومن المثير للاهتمام أن بعض القبائل الرحل كقبائل القوقاز والتركمان حافظت على تراثها الإبداعي في صناعة السجاد عن طريق الإنشاد والغناء والتصفيق. وكان تغيير ألوان الصوف أو الحفاظ على شكل الرمز يعتمد على الإيقاع الموسيقي المصاحب لعملية النسيج نفسها.
بعد رسوخ هذه العلامات في التراث الإبداعي الحرفي، تنتقل العلامة إلى وعي الفنان التشكيلي الذي اختبر مدارس الفن وسوقه، حتى وإن لم يكن منبهرًا به أو يعمل من أجله فقط. فالفنان المهتم بتاريخه وتراثه، يبحث عن مصادر تضفي على فنه طابع الخصوصية، ويلتفت إلى هذه العلامات المستقاة من الفن الشعبي، كالوشم والخرافة والسحر، أو من الفن المصري القديم أو الخط العربي، ويستخدمها في تكوينات مبتكرة عبر أساليب الفن المعاصر، من اللوحة والتمثال والفخار والتركيب والكولاج.
تظهر هذه العلامات في أعمال بعض الفنانين مثل حامد ندا وعبد الهادي الجزار، والفنانتين عفت ناجي وإيفلين عشم الله، لتأخذ مكانها في القاموس التشكيلي، وتُثير اهتمام فئة أخرى من المتلقين. وهنا تتحول العلامة من رمز تراثي في منتج ذي فائدة استعمالية، إلى بنية فنية داخل إطار جديد ومبتكر لا علاقة له بالاستخدام العملي، مثل اللوحة أو التمثال.
وبالعودة إلى رحلة العلامة، نجد أنها بعد أن يقتنيها الفنان أو يتأثر بها ويُدمجها في عمله الفني الذي يُباع في صالات العرض أو يُعرض في المتاحف، تعود مجددًا إلى منبعها. إذ تثير اهتمام محبي وجامعي الأعمال الفنية الذين يسعون إلى اقتناء المنتجات الحرفية التراثية الغنية بالرموز والعلامات، لما لها من قيمة تشكيلية وجمالية، وكذلك لظهورها في أعمال كبار الفنانين.
بهذا تعود الفائدة إلى أصحاب الحِرف والصناعات اليدوية. إنها رحلة رائعة، تبدأ من القرى والنجوع وبعض المدن، إلى مراسم الفنانين والفنانات، ثم إلى جدران ومنازل محبي الفن، وأيضًا إلى المتاحف.
وأخيرًا، كما يقول المثل الشعبي عن احتراف الصنعة: «صاحب صنعة أخير من صاحب قلعة».
