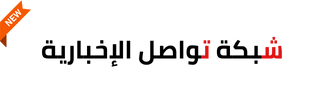الفكر الاقتصادي العربي بين قرنين

الفكر الاقتصادي العربي في القرن العشرين والواحد والعشرين كان جزءًا من شبكة معقدة من التغيرات الجيوسياسية والتحولات الهيكلية في النظام الاقتصادي العالمي. فمنذ تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية وحتى اللحظة الراهنة التي تشهد تحولات في موازين القوى الاقتصادية، خضع الاقتصاد العربي لإعادة تشكّل مستمرة، متأثرًا بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، التي رسمت مساراته المتباينة بين النمو والانكماش، وبين الهيمنة والتبعية، وبين الاندماج في الاقتصاد العالمي ومحاولات بناء نموذج تنموي مستقل.
في النصف الأول من القرن العشرين، اعتمدت الاقتصادات العربية بشكل كبير على القطاعات الأولية، حيث شكّلت الزراعة والموارد الطبيعية الركيزة الأساسية للإنتاج، مع هامش محدود للصناعة والخدمات. ومع اكتشاف النفط في دول الخليج، دخلت المنطقة مرحلة جديدة اتسمت بطفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، إلا أن هذه الطفرة رافقتها حالة من الاعتماد الريعي، التي أعادت صياغة بنية الدولة والاقتصاد على نحو زاد من هشاشته أمام تقلبات الأسواق العالمية. ومن هنا، ظهرت معضلة “الاقتصاد الأحادي”، حيث قاد التدفق الهائل للعوائد النفطية إلى تقوية مؤسسات الدولة الريعية، مما حال دون تنويع الاقتصاد، وأدى إلى نمط من النمو غير المتوازن يعتمد على الإنفاق الحكومي أكثر من الابتكار والإنتاجية.
في العقود الأخيرة، فرضت العولمة واقعًا جديدًا، حيث تسارع انفتاح الأسواق العربية على التجارة الدولية وتدفّقات رأس المال الأجنبي، مدفوعًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات التحرير التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. غير أن هذا الانفتاح لم يكن دائمًا في صالح الاقتصادات العربية، إذ أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، مما جعل العديد من الدول العربية أكثر عرضة للتضخم المستورد والأزمات المالية الخارجية، بينما لم تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التأثير المنشود على التنمية المستدامة، حيث اتجهت في كثير من الأحيان إلى القطاعات الريعية والاستهلاكية بدلًا من الاستثمار في البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية.
في موازاة ذلك، تصاعدت التوترات الجيوسياسية، واندلعت الصراعات الداخلية والإقليمية التي عطّلت النمو الاقتصادي وأعادت رسم خريطة الأولويات الاقتصادية في كثير من الدول العربية. فالاقتصادات التي كانت تأمل في تحقيق استدامة تنموية وجدت نفسها أمام تحديات أمنية وسياسية طارئة، مما أدى إلى استنزاف الموارد وشلّ قدراتها الإنتاجية. وفي الوقت ذاته، ازدادت معدلات البطالة بين الشباب، في ظل نظام تعليمي لم يواكب متطلبات الاقتصاد الجديد، مما أدى إلى تصاعد الإحباط الاجتماعي وخلق بيئة مواتية للاضطرابات وعدم الاستقرار.
وسط هذه التحديات، برزت محاولات جادة لإعادة صياغة النموذج الاقتصادي العربي، استنادًا إلى مفاهيم الاقتصاد المعرفي واقتصاد الابتكار. فالتوجه نحو تنمية رأس المال البشري، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز ريادة الأعمال، أصبح جزءًا من استراتيجيات التنمية في عدد من الدول العربية، التي أدركت أن الاقتصاد القائم على الموارد وحدها لن يضمن الاستدامة على المدى الطويل. كما ظهرت توجهات لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر مبادرات تهدف إلى توحيد الأسواق العربية من خلال مناطق تجارة حرة واتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد، وهي محاولات تعكس الوعي المتزايد بضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.
لكن، وعلى الرغم من هذه التوجهات الطموحة، يظل السؤال الجوهري قائمًا: هل يمكن للاقتصاد العربي أن يتحول من اقتصاد ريعي يعتمد على الموارد إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الابتكار؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من إعادة التفكير في دور الدولة، ليس فقط كمحرك للنمو عبر السياسات العامة، ولكن أيضًا كضامن لإطار اقتصادي يوفر بيئة ملائمة للمنافسة والاستثمار والتطوير التكنولوجي. كما يجب تبنّي نهج اقتصادي يتجاوز نماذج الاقتصاد التقليدي، عبر الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في الانتقال من الاقتصادات الريعية إلى اقتصادات ديناميكية، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، حيث لم يكن الانتقال مجرد نتيجة لتراكم رأس المال، بل كان نتيجة لسياسات تعليمية متطورة، واستثمار في التكنولوجيا، ورؤية اقتصادية شمولية تمتد لعقود.
إن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، مع صعود القوى الاقتصادية الجديدة، وإعادة تشكيل العولمة في ضوء التغيرات التكنولوجية والبيئية، تفرض على الدول العربية إعادة التفكير في موقعها داخل هذا النظام المتغير. فالعالم يتجه نحو اقتصاد أكثر ذكاءً وأقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية، وهو اتجاه يتطلب إعادة صياغة الأولويات، بحيث يكون التركيز على الابتكار، والتصنيع المتقدم، والاقتصاد الرقمي، بدلاً من الاعتماد على أنماط اقتصادية تقليدية لم تثبت جدواها في مواجهة التحديات المستجدة.
إن مستقبل الاقتصاد العربي لا يتوقف فقط على مدى قدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة، بل يعتمد على مدى استعداده لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعيق تطوره. فإما أن يتمكن من بناء نموذج اقتصادي جديد يدمج بين الديناميكية والإنتاجية والاستدامة، أو أن يظل عالقًا في حلقة مفرغة من الأزمات المتكررة.