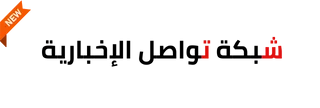دماء على «ثوب الطفولة»

فى غزة لا يكبر الأطفال بل يركضون حفاةً من رائحة الموت.. فـ«بين شهيدٍ وجريحٍ ونازحٍ» تختنق الطفولة تحت قصفٍ لا يميّز بين دميةٍ وصاروخ، وأحلام تُولد من رحم الأنقاض: دفاتر تآكلت أطرافها واختلط حبرها بالدم، وأقلام مكسورة كان أصحابها يكتبون بها عن «مستقبلٍ» لم يُكتب له أن يشرق، وشنطة مدرسية صغيرة خبّأت حلمًا أكبر من أن يتّسع له هذا العالم!
ورغم الألم لا يموت الأمل.. فمن بين الركام يخرج طفلٌ يمسك بحفنة تراب ويقول بثبات: «هذه لى.. ولن أتركها».
أطفال غزة وجوه منسية خلف دخان الغارات، نبتة حياة يقتلعونها قبل أن تورق لتخمد القضية لكنهم لا يعلمون أن كل طفل فلسطينى ناجٍ هو مشروع شهيد أو مقاوم.
فى هذا الملف.. نرصد وجع الطفولة المسلوبة فى غزة، نكتب عن أطفال فقدوا إخوتهم، أطرافهم، مدارسهم.
نُصغى لأصوات صغيرة عاشت تحت الأنقاض فأجادت الكتابة بالحجر قبل الحرف، وواجهت الحرب بابتسامة صبر.
ويبقى السؤال: أين ضمير العالم مما يحدث لأطفال فلسطين؟
«صبا أبوعابدة».. بُترت قدماها ولم تُبتر أحلامها
عاشت بجسدٍ مبتور، وقلبٍ مثقوب بالفقد، وطفولة مُبعثرة بين الخوف والوجع، وبيتٍ لم يبق منه جدار.. إنها الطفلة الفلسطينية «صبا رأفت أبوعابدة» التى لم تتجاوز عامها الثانى عشر.
خرجت «صبا» من مخيم البريج لتشترى بعض الأغراض، لم تعلم أن الخروج فى غزة أشبه بلعبة موت، وعادت دون قدميها، صاروخ أنهى كل أحلام طفولتها البريئة لتبدأ المأساة!
بوح موجِعٌ تقاسمته معنا الطفلة الفلسطينية قائلة: «الحرب ما تركت لى شيء؛ أخذت بابا.. كنت أنام على صوته، وهدّت بيتنا.. كنت أركض فيه، ورِجلى كانت توصّلنى للّعب.. اليوم ما تقدر تودينى لأى مكان، اعتقلوا ماما وأختى ٤٥ يوما، وما كنت أعرف إذا راح يرجعوا أو لا، حتى مدرستى صار فيها نازحين، وصار الصف الخامس هو آخر شيء كتبته قبل ما الحبر يجف، وقبل ما الحلم يكبر».
وأضافت: «أنا دايمًا خايفة.. صوت الطيارات والقصف ما بيفارقنى حتى وأنا نايمة، بحس الدنيا عم تهتز حولى، ما عُدت أعيش مثل باقى الأطفال، اللعب والضحك صاروا أشياء بعيدة، نظرتى للدنيا تغيّرت، صارت حزينة، رمادية.. كل مرة بشوف طفل يُستشهد أو ينصاب بحس كأنه أنا، حتى أصدقائى بالمخيم ما عادوا يحكوا عن بكرا أو عن أحلامهم، بس قاعدين.. نعدّ الأيام ونستنى، وما منعرف شو عم نستنى بالضبط».
«صبا» لم تعد تملك سريرها ولا دفاترها ولا حتى لعبتها المفضلة نزحت مع عائلتها إلى مخيم مكتظ لا يكاد يتسع لأنفاسهم، بالكاد مساحة للنوم وظروف قاسية لا ترحم.
استعادت «صبا» بذاكرتها تفاصيل النزوح قائلة: «غادرنا بيتنا وهو يحترق خلفنا، كنا نركض بين أصوات القصف والخوف يلاحقنا من كل الجهات.. ما لحقت آخذ شيء، لا ملابسى، ولا كتبى، حتى ألعابى تركتها وراى، ورغم كل الخراب لسه قلبى بيقاوم اليأس، ولسه فيّ أمل، ورغم انقطاعنا عن الدراسة، أنا وصديقاتى حفظنا القرآن الكريم جوّا المخيم، أتمنى ترجع الحياة مثل ما كانت، نرجع ندرس ونلعب ونحلم.. إحنا كمان أطفال نستحق نتعلم ونعيش طفولتنا بسلام».
واختتمت: «أتمنى أتعالج بالخارج، وأصير دكتورة أضمّد الألم اللى ما عم يوقف.. إحنا صامدين، رغم الحرب والجراح، حتى لو بتروا أقدامنا، ما رح يقدروا يبتروا أحلامنا.. ورسالتى للعالم، من طفلة فلسطينية تعيش تحت النار: شوفونا! إحنا عم نموت كل يوم وبكل لحظة.. أنقذونا قبل ما يصير سكوتكم قبر أحلامنا».
«سناء طافش».. صوت من تحت الركام
«الطبيبة سناء».. حلم دُوِّن على ورقة سقطت وسط حجارة محترقة، لكنه ظل شاهدًا على طفلة حلمت بمستقبل فى وطن تُقصف فيه الأحلام!
حملت «سناء» بداخلها عمرًا أثقل من سنواتها؛ عمرًا كُتب بلون الدم وامتحنته الأنقاض والنار، وتجاعيد حربٍ حفرت فى قلبها ما يعجز عن تحمله الكبار.
تحدثت الطفلة الفلسطينية «سناء أحمد طافش» لـ«تواصل» وفى صوتها رجفة الناجين من تحت الركام قائلة: «كل يوم نعيشه فيه خوف جديد؛ خوف من قصف مفاجئ، من فقدان أحبّة، من اقتراب الموت، صوت الطائرة يخلينى أرتجف ويسرق منى نومى وطمأنينة قلبي؛ حياتنا صعبة جدًا، وبدل ما أكون على مقاعد الدراسة صِرت أقف فى طوابير التكيّات أبحث عن لقمة.. كل يوم نشوف مشاهد ما يتحملها عقل، صرنا ننام وإحنا مش عارفين إذا رح نصحى أو لا.. لكن الشيء الوحيد اللى مخلينى واقفة لهلّا هو وجود عيلتى، وأمى سندى بالحياة، ووجودى ضمن فريق دبكة شعبية غيّر من نفسيتي».
استحضرت سناء شريط الألم والرعب وهى تروى كيف انتُشلت من بين أنقاض منزلها الذى دكّه القصف الإسرائيلى قائلة: «بيتنا انقصف وإحنا جوّاته، ما قدرت أتحرك وسط الركام، صرخت على أمى كانت جنبى تحت الأنقاض. صرت أصرخ وأبكى، تبولت على نفسى من شدة الخوف، ماما كانت تحكيلى «تنفّسى.. أنا جنبك»، ولما ما إجى حدا ينقذنا، قالتلى «تشهدى يا سناء.. قولي: أشهد أن لا إله إلا الله».
لم تمت.. ولكنها لم تعد كما كانت! هذا ما أكدته الطفلة الفلسطينية وهى تروى لحظاتٍ اختلط فيها التراب بالدم قائلة: «طلعونا بعد ربع ساعة، فقدت الوعى وما قدرت أنطق بكلمة، لما شفت أمى حضنتها، لكن فرحتى كانت ناقصة 6 من عيلتى استشهدوا، أهل البيت كانوا على الأرض ما بين شهيد وجريح، وبيت الجيران كان بركة دم، وسيارات الإسعاف ما دخلت لأنها منطقة حمراء.. من يومها ما بقدر أنام غير بحضن أمى، وما زلت أخاف عند سماع صوت الطائرات والقصف».
وتابعت: «نزحنا أكثر من مرة والقصف فوق رؤوسنا، عِشنا بشمال غزة مجاعة كبيرة، كنا نتمنى لقمة خبز وشربة ماء نظيفة.. لم ننزح للجنوب فالحياة فى المخيمات صعبة جدًا؛ لا نظافة ولا مساحات للأطفال.. نِمنا بأماكن مهدّمة، ٤٠ شخصا فى غرفة صغيرة جدًا، فقدنا طفولتنا، صرنا نحمل مسئوليات أكبر من عمرنا، أنا بنت الـ١٥ سنة، أحمل مياها وأطبخ على النار.. عن أى طفولة بنحكي؟ إحنا ما عشناها أصلًا، حتى متنفسنا الوحيد المدرسة اتدمرت، أوقات قليلة قدرنا ندرس فى خيم تعليمية، لكن ما استمرت قصفوها.. دراستى توقفت بالصف التاسع، أحلم أكمل تعليمى وأرجع ألبس مريولى وأفتح كتابى وأعيش حلمى البسيط «أكون طبيبة» أداوى الجرحى وأساعد الناس اللى فقدوا الأمل».
أنهت «سناء» حديثها قائلة: «بِدّى أتعلم اللغة الإنجليزية ليسمع العالم صوتي: «نحن أطفال غزة نريد الحياة، من حقنا نعيش ونضحك ونلعب وننام بأمان».. حياتنا صارت مدرسة قاسية، نحن أكثر أطفال العالم نستحقّ نتعلم، لأننا تعلّمنا الألم قبل الأحرف».
منة نادر: أرجوحة من الخوف.. وطائرة من الأمل
بين ركام منزلها ودخان الطائرات التى لا تغيب عن سماء غزة فقدت ابنة الـ14 عامًا «منة نادر حمدان» شقيقيها وطفولتها دفعة واحدة.
ورغم الخوف والجوع والموت صنعت لنفسها أرجوحة من قماشٍ وأسلاكٍ ممزقة وطائرة ورقية تطيرها فى وجه القصف، وكأنها تقاوم بطريقتها «لا لتنتصر.. بل لتبقى!».
روت «منة» معاناتها لـ«تواصل» وكأنها ترويها للحياة قائلة: «الحرب غيّرتنى، أثّرت على سلوكى ما عدت زى قبل، صِرت عصبية ما بتحمل أى صوت، ما بقدر ألعب، وبحس دايمًا بالحزن، جسمى مرهق وقلبى خائف طول الوقت، ما بحس بالأمان، الشيء الوحيد اللى يساعدنى أتكيف شوية هو لما بشوف الأطفال يلعبوا، لما أشوفهم يضحكوا بنسى الخوف للحظات، ولما أهلى يطمنونى ويحضنونى بحس بدفا رغم كل البرد اللى جوّاى، أصعب شيء مرّ علينا هو النزوح؛ نزحنا أكتر من عشر مرات من بداية الحرب، إحنا ساكنين بأطراف مخيم البريج، بلوك ١٢، أول مرة رحنا على بيت عمتى بنفس المخيم، تانى يوم تفرّقنا: أنا وأمى وإخوتى الصغار رحنا على بيت خالتى فى المغازى، وإخوتى الكبار راحوا مع بابا على بيت عمتى فى النصيرات.. ما ضلينا هناك كتير، رجعنا تانى على البريج، على مركز إيواء «أبو حلو» بمدرسة البنات، ضلّينا هناك لفترة طويلة، بس لما بلش الهجوم البرى على البريج، رجعنا نزحنا مرة تانية على المغازى، وإخوتى الكبار انتقلوا لخيمة فى دير البلح، ومن هون تغيّرت حياتنا للأبد! فقدنا إخوتى الكبار وفقدنا بيتنا».
وأكملت: «المركز مليء بالنازحين، والمخيم غير مريح بالمرة، ما فى خصوصية، وبنفس مكان نومنا توجد أغراض المطبخ، وملابسنا الصيفية والشتوية المخزنة فى أكياس النايلون، الوضع الصحى سيئ جدًا، روائح كريهة وحمامات مزدحمة، أُصبت أنا وأهلى باليرقان «التهاب الكبد»، وانتشرت الأمراض الجلدية بسبب الحشرات والبعوض والصراصير.. شعرت بالمخيم أنى كبرت بسرعة، لا مكان للعب حتى ساحة المدرسة صارت مليئة خيام.. ما حسّيت إنى طفلة، كنت أساعد أمى فى تعبئة المياه وغسل الملابس ورعاية أخى الصغير».
كنت فى الصف الخامس من المتفوقات، أحب الرياضيات ومعلماتى، لما رجعنا البريج بعد الاجتياح لقيت مدرستى ركام.. أصحابى تشتتوا ومنهم من استشهد، أتمنى لما أكبر أكون ممرضة مثل أبى وأخى لأساعد المصابين وأطمئن قلوبهم.
وأضافت: «لما بسمع صوت قصف برتعش وبصرخ، بتخيّل حالى مُت، كل لحظة بتمر نتشهّد على روحنا وبتذكر إخوتى سائد وإبراهيم فقدناهم وهمّا حاملين كيس الدقيق وقت الغلاء والجوع ليطعمونا، كانوا يسارعون لينقذوا المصابين ويرجعوا بثياب ملطخة بالدم، تفاجأنا بخبر استشهادهم، كنا نظنهم مصابين أو أسرى اندفنوا بقبر جماعى ما ودّعناهم حتى!».
وأضافت: «فى مرة انقصف مدخل مخيمنا، الممرات امتلأت بالجرحى، شفت أطفال متقطعين قدامى فى منظر مرعب، لما رجعنا نشوف بيتنا فى الهدنة ما لقينا شيء، كان كله دمار، ما طلعنا إلا بصور محروقة وممزقة كنا نسيناها داخل خزانة أمى، بدعى توقف الحرب، نفسى أرجع أعيش مثل باقى الأطفال، الحرب سرقت طفولتنا، بس لسه عندنا أمل، كل يوم أصنع أرجوحة من القماش والأسلاك الممزقة وطائرة ورقية لى ولأخى نطيّرها بجوار مخيم الإيواء، وأضحك؛ لأنى بِدّى أعيش.. وأحلم».
المتحدث باسم اليونيسيف:
أطفال غزة يعيشون بين شبح اليتم والإعاقة
فى قلب الحروب يتجرع الأطفال أشدّ أنواع الألم، وبغزة تحديدًا تصبح الأرقام شاهدًا على كارثة إنسانية يفوق تحمّلها أى ضمير حى.
فى هذا الصدد، أفاد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» فى فلسطين، لـ«تواصل»، بأنه منذ السابع من أكتوبر 2023، وبحسب التقديرات المتاحة، قُتل 15,613 طفلا فى القطاع، وهذا الرقم لا يشمل الأطفال الذين لا يزالون تحت الأنقاض، والذين لا يعلم عددهم إلا الله فى ظل صعوبات بالغة للوصول إليهم.. أما الجرحى من الأطفال فقد تجاوز عددهم 34,173 طفلًا.
وأضاف متحدث اليونيسيف: «هناك أطفال كثيرون فقدوا أطرافهم ومنهم من أُصيب بإعاقات دائمة نتيجة القصف، وما يُفاقم الكارثة أن الجريمة لا أحد يستطيع توثيقها؛ فالصحفيون ممنوعون من دخول القطاع، وكذلك فرق الإنقاذ الدولية والباحثون المتخصصون بجمع البيانات مُنعوا أيضًا، حتى المساعدات الإنسانية نفسها تُحاصر على الأبواب».
واستطرد: مرّ أكثر من 18 شهرًا على بدء الحرب بقطاع غزة، وما زالت الحمم تتساقط فوق رؤوس المدنيين دون هوادة.. صحيح أن هناك فترة هدنة قصيرة مرت، لكنها كانت كالحلم العابر بالنسبة للأهالى وخصوصًا الأطفال، خلال هذه الهدنة، كنتُ على تواصل دائم مع زملائى الذين يتجوّلون بين خيام النزوح كانوا يحكون عن نظرات الأطفال الزائغة، سؤال واحد يتكرر على ألسنتهم: «هل ستعود الحرب؟»؛ وذلك لهول ما رأوه خلال أشهر طويلة من القصف والدمار، وبعد انتهاء الهدنة عادت الحرب بكل قسوتها، ولكن هذه المرة، أضيفت مأساة جديدة: انقطاع المساعدات الإنسانية تمامًا منذ الثانى من مارس، وهذه أطول فترة يُمنع فيها دخول أى شكل من أشكال الإغاثة إلى غزة؛ لا طعام، لا دواء، لا ماء، لا حفاضات، ولا مكملات غذائية للأطفال.. بل حتى قطع الغيار اللازمة لمحطات تحلية المياه لا يُسمح بدخولها، ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، فقد تعرضت بعض محطات التحلية للقصف المباشر، وقُطعت الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسة فى دير البلح، ما أدى لانخفاض إنتاج المياه الصالحة للشرب بنسبة 85%، وهو ما أثّر على أكثر من مليون إنسان، بينهم ما لا يقل عن 400 ألف طفل.
وأكمل: الأطفال فى غزة لا ينجون من الحرب، فمن لم يُقتل منهم جُرح، ومن لم يُجرح فقد أحد والديه أو كليهما، أو عاش تجربة تسرق منه الطفولة إلى الأبد.. الإصابات ليست دائمًا بسيطة؛ كثير منها يتحوّل لإعاقة دائمة؛ بسبب نقص الرعاية الطبية وغياب الأدوات الجراحية اللازمة، أذكر أن طفلة أُصيبت فى قدمها وبسبب نقص الأدوات الطبية تفاقم الجرح وخضعت لثلاث عمليات بتر تدريجية، وهذا مجرد مثال من آلاف الأمثلة التى تؤكد أن أطفال غزة يعيشون بين شبح الموت والإعاقة، أو اليُتم والفقد.. والقطاع الذى كان يُوصف لسنوات طويلة بأنه «سجن مفتوح» تحوّل اليوم إلى مقبرة جماعية، لا أماكن آمنة، حتى العاملون فى المجال الإنسانى لم يسلموا، فبحسب آخر التقديرات، قُتل 408 منهم خلال الحرب، منهم 300 موظف أممى، أى أن ما خسرته الأمم المتحدة من موظفين فى هذه الحرب وحدها يفوق عدد ما خسرته فى كل النزاعات والحروب السابقة مجتمعة منذ تأسيسها.
وأضاف كاظم أبو خلف أن الأطفال فى غزة يشكّلون 50% من عدد السكان، وجميعهم بلا استثناء يحتاجون إلى دعم نفسى مكثف يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، فهناك أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حُرموا من عام دراسى كامل، وقد يخسرون عامًا آخر، ما يعنى أن مستقبل جيلٍ كامل بات معلقًا بين الأنقاض والدمار، ولذلك تحاول اليونيسف إقامة «مساحات مؤقتة للتعليم» – وهى خيام كبيرة تُنصب فى وسط مخيمات النزوح – لمحاولة خلق بيئة بديلة تشبه المدارس، لكن سرعان ما تسقط هذه المبادرات تحت نيران الإخلاء؛ إذ إن أكثر من 80% من مساحة القطاع أصبحت ضمن مناطق الإخلاء القسرى، فبعض العائلات نزحت 19 مرة، كلما استقرّوا فى بقعة تحوّلت إلى دائرة حمراء جديدة، بين أمر إخلاء عاجل أو قصف متوقع.
وأشار: لا يوجد مستشفى واحد يعمل بشكل كامل من أصل 36، و20 فقط تعمل جزئيًا وتقدم خدمات لا تتجاوز مستوى العيادات الصغيرة، وهناك أكثر من 15 ألف حالة حرجة بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقى العلاج، من بينهم 4500 طفل، بينما لم يُسمح سوى لـ2000 فقط بالخروج، ومن أصعب الحالات كانت حالة الطفل إسلام، مريض سرطان لم يُسمح له بالخروج للعلاج وفارق الحياة بعد ست محاولات فاشلة، وآخر أُصيب بشظية فى فقرته العنقية الثالثة جعلته مشلولًا ولا يتنفس إلا عبر جهاز تنفس صناعى وهو واحد من ثلاثة أجهزة فقط بقيت عاملة فى غزة بعد تدمير 47 جهازًا من أصل 50 بفعل القصف، ومع هذا النقص الحاد يتقاسم الأطفال أجهزة التنفس مع حديثى الولادة.. ما يحتم على الطواقم الطبية اتخاذ قرار قاسٍ: من يُعطى الجهاز؟ ومن يُترك للموت؟
وتابع: «الأطفال فى غزة يتحدثون عن أنواع الطائرات والأسلحة ويحلّلون الأحداث السياسية كالكبار، أحد الأطفال فى بداية الحرب قُصفت عائلته، واستُشهد عدد من أبناء عمومته فى لحظة ارتباك أُخرجت جثامين الشهداء من ثلاجة الموتى وكان الطفل حاضرًا تلك اللحظة، منذ ذلك الوقت لم يعد يقترب من ثلاجة البيت؛ لأن ذاكرته ربطت الثلاجات بالموت لا بالطعام.. هذه قصة من بين آلاف القصص النفسية المؤلمة التى تعكس مدى حاجة هؤلاء الأطفال لرعاية نفسية شاملة وعاجلة
أما على صعيد النزوح -والكلام لأبو خلف- فالمأساة لا تقل قسوة، فبحسب الأمم المتحدة، هناك ما يقرب من مليون و900 ألف نازح داخل قطاع غزة، من أصل عدد سكان يُقدّر بمليونى و300 ألف؛ أى أن الغالبية العظمى من السكان اضطروا للنزوح بأطفالهم تحت القصف، ومن بين هؤلاء يُقدّر عدد الأطفال الذين فقدوا أهلهم أو انفصلوا عنهم – ما بين 17 إلى 19 ألف طفل، وتحاول منظمة اليونيسف قدر المستطاع لم شمل هؤلاء الأطفال بعائلاتهم، وقد نجحت فى إعادة 300 طفل فقط إلى ذويهم، لكن هذا الرقم لا يُقارن بحجم الكارثة؛ فهى متاهة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ متاهة من الموت والفقد والشتات والألم النفسى والنزوح القسري».
وأفاد الناطق باسم اليونيسيف: بالهدنة حاولنا إخراج الأطفال من دائرة سوء التغذية التى سقط فيها الآلاف على مدار الحرب، لكن مع انقطاع المساعدات انتكس الوضع من جديد؛ على سبيل المثال لم يتبق من تركيبات الرُّضع الغذائية الجاهزة للاستخدام فى مخازن اليونيسف ما يكفى لأكثر من 200 طفل ولمدة لا تتجاوز3 أسابيع فقط، ووحدات العناية المركزة لحديثى الولادة تعانى نقصًا كارثيًّا فى الأدوية والمعدات والمغذيات، بل تشير البيانات الميدانية التى جمعتها الفرق الطبية الأمامية إلى ازدياد معدلات الأمراض والوفيات بين حديثى الولادة؛ فقبل شهر، توفى 13 طفلًا بسبب انخفاض درجة الحرارة، كما توفى 37 شخصًا – معظمهم من الأطفال – نتيجة سوء التغذية.. فى ظل هذا، نُصرّ على أن وقف إطلاق النار ضرورة إنسانية عاجلة، ليتيح لنا – كمنظمات عاملة فى الإغاثة – أن نضاعف تدخلاتنا ونقوم باستجابة إنسانية شاملة، بدلًا من أن تُشلّ حركتنا كلما استؤنف القصف، فاستمرار الحرب يمنع وصول فرق الإغاثة، ويهدد حياة العاملين فى الميدان تمامًا كما يهدد حياة المدنيين.
وأضاف: قطاع غزة هو أسوأ مكان يمكن أن يعيش فيه طفل، فهو قاسٍ على المدنيين والأطفال، حتى على من يحاول مساعدتهم، وكأن الأمر ممنهج، فى 2 مارس توقفت المساعدات كليًا، وفى 9 مارس انقطعت الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسة بالجنوب وبذلك انخفضت حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب من الحد الأدنى المقبول عالميًا (15 لترًا فى اليوم) إلى ما بين 4 إلى 6 لترات فقط، وفى 18 مارس انهار وقف إطلاق النار بشكل تام، واستؤنف العدوان، وفى 27 مارس، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية – بالإجماع – التماسات منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية، كانت تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأصبحت المساعدات الإنسانية ورقة مساومة سياسية فى المفاوضات، رغم أن القانون الدولى واضح: المساعدات يجب أن تدخل حتى أثناء الحروب، والمرافق المدنية يجب أن تُحمى لا تُستهدف.
واختتم «أبو خلف» حديثه قائلًا: ومع تواصل الانتهاكات، نجد أن 95.02% من المدارس فى قطاع غزة تعرضت لأضرار متفاوتة من جزئية إلى دمار كامل، وبعضها قُصف أكثر من مرة، وما تبقى منها تحول إلى مراكز إيواء مكتظة بالنازحين.. وفى فترة الهدنة القليلة أطلقنا حملة تطعيم واسعة ضد شلل الأطفال، واستطعنا الوصول إلى 603 آلاف طفل دون سن العاشرة، لكن هذه الجهود مجرد محاولات إنقاذ فى لحظات هدنة نادرة، بينما العمل الحربى استؤنف ولم يتوقف، ونرى المرارة فى عيون الغزيين، ونشعر بيأسهم المتزايد من العالم، وأصبح لديهم يقين بأن العالم تخلّى عنهم، وأن المجتمع الدولى لم ينقذهم، وهم محقّون.. فهم لا يحتاجون فقط إلى الغذاء والدواء.. بل يحتاجون لوقف شلال الدم، واستعادة حقهم فى الحياة.
الحروب تصيب بالأطفال بالأمراض النفسية والعلاج ضرورة مثل الطعام
«ليست كل الجراح تُرى» فبعضها يسكن الروح ويظهر فى نظرات الطفولة التى شبّت على الخوف والفقد، وحول هذا الواقع النفسى المعقّد، تحدثنا مع الدكتورة أميرة حسن، معالج نفسى إكلينيكى واستشارى أسرى وتربوى، عن تأثير الحروب على نفسية الطفل، قائلة إن الحروب تسبب قلقًا مزمنًا وانعدام الشعور بالأمان والخوف من الموت والفقد، هذه المشاعر السلبية قد تُفقد الطفل الثقة بالعالم من حوله، ففى ظل القصف والدمار يتعرض الأطفال لأنواع مختلفة من الصدمات، منها اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) – ومن أعراضه الكوابيس المتكررة التى تدور عن نفس مشاهد الصدمة، والتجنب لأماكن أو الأصوات التى تُذكره بها، ونوبات غضب وانهيار وبكاء غير مبرر، وصعوبة التركيز أو التلعثم فى الكلام أو رفض الكلام نهائى – بالإضافة للصدمات النفسية المرتبطة بفقدان الأحبة ورؤية المشاهد الدموية فى اليقظة والنوم، والاكتئاب وقلق الفقد، وصدمات التفكك (حيث يشعر الطفل بأن العالم غير حقيقى).
وأضافت: هناك تغيرات قد تظهر على الأطفال مثل التبول اللاإرادى، والعودة إلى سلوكيات عمرية أصغر «مثل النوم فى وضع الجنين أو مص الأصابع أو الالتصاق بالأم»، أو العدوانية الشديدة والانسحاب الاجتماعى والانطوائية، وقد يصل الأمر إلى مشكلات عقلية أو عاطفية طويلة المدى تُسبب اضطرابات القلق المعمم، وصعوبة تكوين العلاقات فى المستقبل خوفًا من الفقد والانفصال، وصعوبة التكيف مع العالم المحيط.
وتطرقت استشارى الصحة النفسية إلى تأثير فقدان المنزل أو الأهل على شعور الطفل بالأمان، قائلة إن الطفل فى هذه الحالة يفقد الإحساس بالانتماء، وقد يشعر بالذنب لكونه نجا وأحد أفراد أسرته لم ينجُ، والخوف من الهجر يصبح مسيطرًا خاصة إذا فقد والديه.. وقد ينعكس أثر رؤية القصف أو الخروج من تحت الأنقاض على وعى الطفل بذاته وبالعالم، حيث إن الأطفال – والبالغين أيضًا – يستخدمون آليات من الدفاع مثل الإنكار للأحداث والمشاهد أو الإصابة بتشوهات فى إدراك العالم المحيط كالوقت والواقع المؤلم.
وفيما يتعلق بالمخاطر النفسية للنزوح والحصار، نوّهت «د. أميرة حسن» إلى أن الأطفال فى هذه الحالة ينتابهم شعور بفقدان الهوية والانتماء، والعديد من الاضطرابات بسبب فقدان الروتين اليومى والمكان الآمن، وفقدان أبسط الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج، فضلًا عن سوء التغذية الذى قد يؤثر على الصحة العقلية، ومن هنا تبرز الحاجة لدور الأسرة فى دعم الطفل، فهو من أكبر العوامل المساعدة حيث تبدأ بالاستماع له دون إجباره على الكلام، وإشعاره بالأمان عبر الاحتضان وتكرار معنى «أنت فى أمان معنا»، وفى حالة فقدان الطفل لأسرته فإنه يجب توفير رعاية بديلة مستقرة، وربطه بمجتمع داعم (مدارس، مراكز إيواء، جماعات دعم).
وتابعت: ما تحتاجه غزة اليوم لإنقاذ أطفالها هو وقف الحرب وإنشاء مراكز دعم نفسى عاجلة، وتدريب كوادر محلية على الإسعاف النفسى، وتوفير مساحات آمنة لهم؛ فالأطفال فى الحروب ليسوا ضحايا عابرين، بل هم ناجون يحتاجون لدعم طويل الأمد.
والتقط أطراف الحديث الدكتور عبدالعزيز آدم، أخصائى علم النفس السلوكى وعضو الاتحاد العالمى للصحة النفسية، مشيرًا إلى الطفل الفلسطينى محاصر بين الذاكرة المثقلة والسلوك المرتبك، ولذلك فإن السلوك العدوانى أو الانطواء يعتبر رد فعل نفسيا طبيعيا على تجربة غير طبيعية، ويمكن استخدام بعض الأنشطة البسيطة مع الأطفال الفلسطينيين لمساعدتهم على تعديل سلوكهم مثل الرسم والتلوين واللعب الجماعى والغناء والتمثيل والألعاب الحركية، كل هذه الأشياء تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره، وأيضًا القصص تساعدهم فى تفريغ المشاعر والمخاوف دون الحاجة للتعبير اللفظى المباشر، فالدعم الجماعى يخلق مساحة آمنة للطفل تُشعره أنه ليس وحيدًا.
ووجه «آدم» رسالة للعالم قائلا: إن أطفال فلسطين يستحقون أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من أطفال العالم؛ من حقهم اللعب والتعلم والشعور بالأمان، وأناشد العالم أن يقف مع معهم ليس فقط بالمساعدات الإنسانية، بل بدعم حقيقى لحقهم فى الحياة والنمو والحلم والاستقلال، فالطفل الفلسطينى بحاجة لبيئة مستقرة ودعم نفسى مستمر ونظام تعليمى داعم وأسر حاضنة وبرامج علاجية نفسية متخصصة، ولكن قبل كل شيء يحتاج إلى وقف دائم للعدوان؛ لأن الطفولة لا تزدهر تحت القصف والدمار والنيران.
استهداف الأطفال جريمة حرب
فى خضم هذا المشهد الكارثى، أطلقت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صرخة قانونية قائلة: إن حماية الأطفال ليست خيارًا بل التزام يُحاسب عليه الجميع؛ فالصمت تواطؤ والتقاعس عن تطبيق القانون الدولى يُشجع على الإفلات من العقاب.. وما يحدث فى قطاع غزة أسوأ مما تعرض له اليهود على يد هتلر، فإسرائيل تكرر ما فعله هتلر وكأنها تنتقم.. ولكن مِمن؟؟ من أطفال عزل! رضع!.. هذا جنون وعليها أن تحاول علاج أمراضها النفسية التى ورثتها منذ عقود، فلا مبرر نهائيا لوحشيتها سوى أنها تعانى الدموية وأى حديث عن السلام ورغبتهم فيه عبث.
وأكدت: ما يتعرض له أطفال غزة من قصف وقتل وإصابة وتشريد يُصنّفه القانون الدولى «بالانتهاكات الجسيمة»؛ والتى تعتبر ضمن جرائم الحرب طبقًا لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، كما أنها جرائم ضد الإنسانية إذا كانت منهجية ومُنتظمة (المادة 7)، وهى انتهاك لحقوق الأطفال التى أقرتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الخاص بالنزاعات المسلحة.. ومن ثم فإن استهداف الأطفال عمدًا فى النزاعات المسلحة يُعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8(2)(b)(i) من نظام روما – خاصة إذا كان الهجوم مُباشرًا على مدنيين أو تم باستخدام أسلحة غير مُتكافئة (مثل القصف العشوائي)، أو انتهك مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
وحول دلالة استهداف المدارس والملاجئ على الصعيد القانونى قالت: هذا انتهاك مزدوج: للمادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة (حماية المبانى المدنية)، وانتهاك لحق الطفل فى التعليم (المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل) والحياة الآمنة، ويُعد جريمة مضاعفة إذا استُخدمت المدارس كملاجئ (حماية خاصة بموجب القانون الدولى الإنساني).. ويمكن ملاحقة الاحتلال قانونيًّا بسبب ما ارتكبه بحق الأطفال من خلال المحكمة الجنائية الدولية التى فتحت تحقيقًا فى فلسطين منذ 2021 (بموجب الاختصاص الإقليمي)، ومن خلال محكمة العدل الدولية لمحاكمة الدول (مثل قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 2024، والاختصاص العالمى مثل محاكم وطنية فى دول أخرى (مثل إسبانيا أو ألمانيا) بناءً على مبدأ الاختصاص العالمى لجرائم الحرب.
أزهرى: فلسطين فى رقبة كل مسلم.. والصامتون عن دم أطفالها ليسوا منّا
حينما تُذبح الطفولة على عتبات الصمت، يتردّد صوتٌ من منابر الأزهر الشريف ناصحًا ومنذرًا، ليرفع راية الحق ويُوقظ الضمير الغافل
وأطلق هذا الصوت الشيخ عبدالسميع محمد أمين، من علماء الأزهر الشريف، قائلا: إن اعتداء المجرمين على أصحاب بلد لم يفعلوا شيئًا سوى دفاعهم عن أرضهم وأوطانهم هو وحشية لا تعرف الإنسانية؛ فقد طال الجُرم النساء والأطفال من أهل غزة، وهم الذين جعل الإسلام لهم سياجًا يحوطهم ويرعاهم حتى فى الحروب وإن كانوا غير مسلمين، وذلك واضح فى قوله صلى الله عليه وسلم لقادة الحروب وللجيوش «اغزوا باسم الله فى سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا»، فلقد حرم الإسلام الاعتداء بكل أنواعه على هؤلاء المسالمين، فما بالنا بأصحاب أرض وعرض يتعرضون لإبادة جماعية لا لقتال نزيه أو مكافئة قتالية بأسلحة واحدة؟!
وأضاف: ما نراه اليوم لا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية، مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية كلها ملزمة بحماية أطفال غزة من هذا العدوان الغاشم، ويجب عليها الاتحاد لصد هذا الأذى، وصدق النبى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: «لا يقفن أحدكم موقفًا يقتل فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره; حيث لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحدكم موقفًا يضرب فيه رجل ظلمًا; فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه”.
واختتم «عبدالسميع» حديثه قائلا: «الإسلام يعتنى بالأطفال وينادى بحفظهم ورعايتهم؛ لأنهم ركيزة المجتمع، وعلى أمة الإسلام الحذر من التهاون فى نصرة الفلسطينيين والدفاع عنهم فإن هذه المقدسات فى رقبة كل مسلم؛ بل فى رقبة كل عربى، فوعد الله آت لا محالة والسعيد من ناصرهم سواء كان بالدعاء أو مقاطعة منتجات، وتهيئة النفس للدفاع عنهم عند إتاحة ذلك تحت راية ظاهرة يجتمع فيها صف هذه الأمة، وتعليم الأجيال الحالية والقادمة عروبة فلسطين وتاريخها، وكيف نهتم بأمرهم فهم منا ونحن منهم».