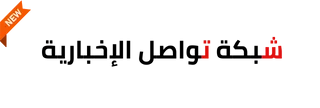منال الشرقاوي تتناول: كيف تتلاشى السنوات في عدسة الكاميرا؟

الزمن في السينما ليس عقرباً يدور على شاشة سوداء، ولا هو سطر يخبرنا أن “خمس سنوات قد مضت”. الزمن في السينما شعور، ظل يطول أو يقصر، دون أن يُرى.
كيف يمكن لفيلم أن يجعلنا نحس بأن السنوات قد مرّت، دون أن يخبرنا؟ كيف تنتقل بنا الصورة من الطفولة إلى الشيخوخة، من لحظة حب إلى عمر من الفقد، دون كلمة تُقال؟هنا تتجلى براعة السينما في تحويل الزمن إلى تجربة محسوسة، تتسلل عبر الضوء والإيقاع والتفاصيل، دون حاجة إلى كلمات أو تواريخ.ثمة مفهوم مفتاحي لفهم هذه الطريقة في تصوير الوقت، وهو ما يُعرف بـ”الزمن البصري”. ما نعنيه بـ”الزمن البصري” هو الطريقة التي تعبر بها الصورة السينمائية عن مرور الوقت دون استخدام كلمات أو عناوين زمنية. هو كيف يفهم المشاهد أن الأحداث تغيرت، أو أن السنوات انقضت، من خلال الإيقاع، الضوء، المونتاج، الحركة، اللون، وحتى الصمت.السينما، تلك الساحرة العمياء التي ترى بعيوننا، تمتلك أدواتها الخاصة لقول ما لا يُقال. لا تحتاج لتاريخ مكتوب في زاوية الشاشة لتُقنعنا أن طفلاً قد صار رجلاً، أو أن عاشقَين قد افترقا دهراً. تكفي نظرة، غروب شمس متكرر، يد ترتجف فوق صورة قديمة، أو عين فقدت لمعتها دون أن نلاحظ متى.من أبرز الأمثلة على التعبير البصري عن الزمن دون اللجوء إلى التوضيح اللفظي، فيلم The Tree of Life (شجرة الحياة) للمخرج تيرينس ماليك، إنتاج عام 2011، من بطولة براد بيت، جيسيكا تشاستين، وشون بن. لا يتبع الفيلم مسارًا زمنيًا تقليديًا، لكنه يختار بنية سردية مفتوحة، يتداخل فيها الحاضر بالماضي، والذكرى بالتأمل، والمشهد العائلي البسيط بصور كونية واسعة عن نشأة الكون وتطور الحياة. يمر الزمن في الفيلم عبر الصور التي تتبدل دون إنذار، عبر التغير التدريجي في الوجوه، في الضوء، وفي الإيقاع العاطفي للمشهد.تنبثق الحكاية من أضلع الطفولة، فنرى طفل يعيش مع والديه في تكساس الخمسينيات، يفقد أخاه لاحقًا، ويحمل هذا الفقد معه إلى سنوات النضج. لكن الحكاية لا تُروى كما تُروى القصص، وإنما تُبنى كما تُبنى الذكريات؛ بمزاج داخلي، بخيط شعوري. لقطة الطفل وهو يلمس الشجرة في فناء البيت لا تختلف من حيث الوزن عن مشهد خلق النجوم، أو نظرة الأم الحزينة التي لا نعرف متى التُقطت، لكنها تضعنا داخل زمن لا يمكن قياسه بالساعة. إنه الزمن الذي يعيشه الإنسان حين يتذكر، حين يحنّ، حين يحاول فهم ما فاته.ماليك لا يشرح؛ فهو يترك الصورة تعمل عملها الكامل. يستخدم الكاميرا كعين داخلية تراقب وتشعر. حركة العدسة، زوايا الالتقاط، دخول الضوء عبر النوافذ، كل ذلك يُراكم الإحساس بالتحول المستمر دون أن يقول “لقد مرت سنوات”. حتى الموت في الفيلم يأتي كتحول هادئ، كما لو أن الزمن لا يقطع الأشياء وإنما يُعيد تشكيلها.الزمن في The Tree of Life هو الحكاية نفسها. عبر توالي الصور، وتكرار بعض الحركات البسيطة، وتغير الأجواء النفسية، يشعر المشاهد أنه انتقل من لحظة إلى أخرى، لا لأنه أُخبر بذلك، ولكن -ببساطة- لأنه عاش ذلك. الفيلم يمنحنا تجربة شعورية متصلة، فهو يعيد تعريف الزمن كما يحدث في الذاكرة، مبعثر، موجع، جميل، ومع ذلك، لا يمكن الإمساك به.كثير من الأفلام تضع على الشاشة جملة “بعد عشر سنوات”، فنعرف ذلك بعقلنا فقط. أما السينما البصرية الحقيقية، فتجعلنا نعرف بعاطفتنا، حين نجد أنفسنا نشتاق مع البطل، أو نندهش من تغيره، أو نشعر أن ما كان لم يعد.في فيلم Up من إنتاج بيكسار (2009)، يمر شريط حياة كاملة في دقائق معدودة، دون كلمة واحدة. عبر مونتاج صامت، مشغول بعناية كأن الزمن نفسه هو من حرره، نشهد قصة زواج تمتد لعقود، تُروى لا بالحوار ولا بالتعليق، وإنما بتبدل الأثاثات في المنزل، بتغير الضوء الداخل من النوافذ، بشعر يبيض بخُطى وادعة، وبعلب أدوية تظهر فجأة على الطاولة، كرسائل صامتة تقول إن العمر بدأ يطوي أيامه. الأحلام لا تسقط فجأة… هي فقط تُنحى جانبًا، ككتاب نضعه على الرف وننسى العودة إليه. الحياة تفعل ذلك دون ضجيج. سنوات من الحميمة تُحكى بلقطة يد تمسك أخرى في صمت المستشفى، ثم تُفلتها. هذه اللقطة وحدها تكثف عمراً، وتحمل من الزمن أكثر مما تفعل عشرات المشاهد. ليست المشاعر وحدها من تتحرك في هذا المونتاج، وإنما الزمن نفسه. لا تظهر أي عبارة تقول “مرت أربعون سنة”، لكننا نراها تُروى في تفاصيل المعيشة اليومية، في الأوراق التي تملأ الأدراج، في العجز المتسلل بين الخطى.الزمن البصري هنا في لعبة الإيقاع. كيف يتسارع المشهد في لحظات السعادة، ثم يبطؤ في لحظات الخسارة. السرعة والبُطء يتحكمان بطريقة إحساسنا بمرور الأيام. في مشهد قصير واحد، ينتقل الفيلم من الطفولة المشتركة إلى الشيخوخة، ومن الحلم إلى الفقد، دون أن يُشعرنا بالقفز أو الانقطاع، و كأننا عشنا العمر معهم. هكذا، يُقدم Up درسًا بالغ البساطة والعمق.إن السينما الجيدة تثق بالمشاهد؛ فهي لا تملي عليه المعلومات، وإنما تدعوه ليكتشفها. تُشبه في ذلك الشعر أكثر من الرواية، تلمح ولا تصرح، توحي ولا تُفصل. والملفت أن مرور الزمن قد يُستشف أحياناً مما لا يظهره الفيلم على نحو مباشر. لقطة يغيب عنها عنصر اعتدناه، عادة تتكرر بصمت، أو فراغ في المشهد لا نعرف متى وُجد. كل ذلك يخلق شعورًا بأن الزمن قد عبر، دون أن يُقال ذلك صراحة، فالصورة تحكي بما تُظهر وتبوح أيضًا بما تُخفي. لا يقتصر الزمن البصري على البنية السردية وحدها، فهو يُصاغ أيضًا من خلال الأدوات السينمائية الدقيقة، فالإضاءة مثلًا، حين تتحول من دفء أصفر في بداية العلاقة إلى برودة زرقاء مع تلاشيها، تُشعرنا بأن الزمن قد تبدل -عاطفيًا أو عمليًا-. في فيلم 1984 المأخوذ عن رواية جورج أورويل، تُستخدم الإضاءة الباردة الشاحبة مع التقدم في الأحداث لتجسيد التدهور النفسي والجسدي في مجتمع المراقبة، حيث يبدو الزمن وكأنه يسحب الحياة من الوجوه والجدران على حد سواء. كذلك في Children of Men، تتحول الإضاءة تدريجيًا من ضوء رمادي خافت إلى ألوان باهتة (مغسولة)، لتأكيد الإحساس بزمن مُتآكل، لا يحمل وعودًا، يكرر نفسه في دائرة من الجمود والانهيار البطيء.الزمن البصري هو لغة الذاكرة، لا التقويم؛ هو كيف تبهت الألوان، أو تتكرر العادات، أو يُفتح باب غرفة في توقيت مختلف عن العادة.ما يجعل الزمن السينمائي مختلفًا عن الزمن الواقعي هو قدرته على الانحناء. في الحياة، نمضي لحظة بلحظة، لكن في الفيلم يمكن أن نعيش عاماً في دقيقة، أو نقف على لحظة واحدة فنستخرج منها دهراً من المعنى. السينما تعيد تشكيل إدراكنا للزمن، لقطة متكررة من زاوية واحدة تخلق إحساسًا بالديمومة، بينما تقطيع سريع لمشاهد متتالية يمنحنا توتر السرعة وضيق الوقت. وهكذا، يتجلى الزمن في السينما كتركيب جمالي داخلي، يخدم الشعور لا التسلسل.أحياناً، يكفي ظل شجرة تغير مكانه على الحائط، أو نبتة ذابلة بجوار نافذة، لنفهم أن الوقت قد عبر. وأحياناً، لا ندرك أن الزمن قد مر إلا حين نرى من نحب وقد تغير، لا لأن الفيلم أخبرنا، ولكن لأننا أحسسنا بذلك.وهكذا، لا تصف السينما الزمن بقدر ما تجعله يُعاش. لا تحتاج إلى أرقام أو تقويمات لتقول إن الوقت قد مضى؛ يكفي أن يتغير الضوء، أن تسكن نظرة، أن تتبدل نبرة المشهد. في السينما، لا يُقاس الزمن بالساعات، ولكن بما يتركه في النفس من أثر، بما يحمله الجسد من تغير، وبما تخبئه الصورة من صمت لم يكن هناك من قبل. الزمن في الفيلم يُقدم كنبض يتسع وينكمش مع كل لحظة. وهنا يكمن الفارق بين السينما التي “تُخبرنا” والسينما التي “تجعلنا نشعر”.