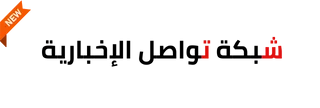من ينتهك هوية مصر؟

ليست كل الحروب تُخاض بالبندقية. بعضُها أكثر مكراً، تُدار بالكلمة والصورة والسينما، وتُبنى فيها المعارك على أرض الوعي، ويُقصف فيها التاريخ بنيران “الرواية”، وتُنتزع فيها الجغرافيا من جذورها دون قطرة دم.
ذلك ما نشهده اليوم ونحن نقف على أعتاب معركة ناعمة تُدار ضد هوية مصر، وتُستخدم فيها أدوات الفن والإعلام تحت راية حركة تُدعى “الأفروسنتريك”؛ حركة تحمل في ظاهرها خطاب الانتماء والانتصار للهوية السوداء، لكنها في جوهرها تستبدل التاريخ بالأسطورة، والعلم بالهتاف، وتستبدل السؤال النبيل عن “الجذور” بمحاولة قسرية لاقتلاع الجذور الأصلية للآخرين. هكذا جاءتنا تلك المخرجة السنغالية – التي لا يعرفها جمهور الفن ولا سجلات السينما – لتقف على منصة مهرجان القاهرة السينمائي، في قلب العاصمة التي عرفت الفن قبل أن تولد كثير من الحركات والتيارات، وتقول دون تلعثم: “الفراعنة كانوا سودًا”، وكأنها تُلقي حقًّا لا يحتمل النقاش، لا رأيًا. هي لم تكن تخاطب المصريين، بل كانت توجه خطابها إلى جمهورها الحقيقي، أولئك الذين يصفقون في صمت الإنترنت، ويعيدون نشر الأكاذيب، ويصنعون من السرد بديلاً للحقيقة.لكن ما قالته لم يكن زلة لسان، ولا رأيًا طائشًا في جلسة حوار، بل كان جزءًا من خطاب أكبر، وتيار متنامٍ، يُعيد منذ سنوات رسم ملامح التاريخ المصري، ويُسقِط عنها ملامحها العربية والأفريقية والبحر متوسطية، ليعيد طلاءها بلون واحد، لا يحتمل التعدد، ولا يقبل إلا برواية واحدة: أن كل ما بُني على هذه الأرض إنما بناه قوم غرباء عنّا، وأننا – نحن المصريين – مجرد دخلاء على أرضٍ لا تخصنا. يا لها من مفارقة مؤلمة… فبينما كنا نظن أن معارك التاريخ قد حُسمت بالعلم، وإذا بنا نُفاجأ بعودة الحكاية من نافذة السينما، لا بوصفها مرآة للواقع، بل بوصفها مطرقة تهشّم الوقائع.هل كانت تلك المخرجة تدرك فداحة ما قالت؟ ربما. وربما كانت، مثل غيرها، تحتمي بخطاب الضحية، وتُحركها نزعة ردّ الاعتبار، لكنها – في كل الأحوال – لم تكتف بإعادة التأويل، بل ذهبت إلى حدّ التزوير. فالمعركة ليست عن ألوان بشرة أو أطياف ملوك، بل عن من يحق له أن يروي القصة، ومن تُكتب باسمه ملحمة الأهرامات والنيل ومراكب الشمس وكنوز توت عنخ آمون. المؤلم في كل ذلك أن أرض المعركة لم تكن شاشة بعيدة، ولا قاعة مؤتمر أوروبي، بل كانت قلب القاهرة، على منصة تُفترض فيها الحفاوة بالتاريخ، لا نزع ملامحه.والأخطر من ذلك، أن هذه ليست الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة. لقد تحولت المتاحف إلى مسارح خفية تُعاد فيها كتابة الحكاية على مسامع السيّاح، ويُقال فيها ما لا يُصدق عن نسب الملوك وأصولهم، ويُقدَّم للمارة من أبناء الغرب – في صمت تام – رواية مزورة تقول: “هؤلاء الفراعنة كانوا سودًا، وأنتم – أيها المصريون – لا علاقة لكم بهم”.إننا لا نعترض هنا على كون مصر أفريقية، ولا ننكر امتدادها الجغرافي ولا تنوع دمها، بل نعترض على أن تُختزل حضارة عمرها سبعة آلاف عام في لون واحد، أو تُختطف من أهلها باسم إنصاف الآخر، وكأن العدل لا يتحقق إلا إذا جُرّدنا من ماضينا، وسُلِبت أعمدة هويتنا حجرًا حجرًا. لقد جاءت حركة “الأفروسنتريك” في الأصل كرد فعل على اضطهاد تاريخي، وربما بوحي من رغبة حقيقية في البحث عن الجذور، لكنهم – في لهاثهم وراء الانتماء – سقطوا في فخ نفي الآخرين، واستبدلوا الاستعمار القديم باستعمار سردي جديد، يُخضع الآخر للهوية التي يريدونها هم، لا التي صاغها الزمان والجغرافيا والدم.إن الفراعنة لم يكونوا سودًا، ولم يكونوا بيضًا، كانوا مصريين، كما عرفناهم من جدارياتهم، ومومياواتهم، ونقوش معابدهم. ملامحهم ليست لغزًا، بل حقيقة مثبتة بعشرات الأدلة الأثرية والعلمية، وكل محاولة لمحو هذه الحقيقة ليست سوى محاولة لبناء مجد زائف على أنقاض حضارة قائمة.ولعل السؤال الأهم هنا: لماذا نسمح لهذه الروايات أن تمر؟ لماذا نصمت حين تُلقَى الأكاذيب في مؤتمراتنا الثقافية؟ لماذا لا نواجه هذا التيار بمثله، روايةً برواية، وفيلمًا بفيلم، ودليلًا بدليل؟ لسنا بحاجة إلى غضب شعبي، ولا إلى منابر تَشجب وتُندد، بل إلى مشروع ثقافي حقيقي، طويل النفس، يعرف أن معركة الرواية لا تُخاض بالصراخ، بل بالصبر والاحتراف والعلم.صحيح أن الدولة ليست مسؤولة عن كل رأي يُقال، لكن من واجبها أن تحمي ذاكرة شعبها، لا بالصوت العالي، بل بالمؤسسات التي تُدرّب وتنتج وتُصوّب. فالتاريخ حين يُترك فارغًا، سيملؤه غيرك، وأولئك الذين يسرقون وجهك، سيمنحونه ملامح جديدة، ثم يبيعونه لك على هيئة فيلم أو مسلسل أو كتاب مدرسي في مدارس بعيدة.إن الهوية لا تُهدى، ولا تُستعاد بالنداء، بل تُبنى كل يوم، وتُصان بالرواية الصادقة. ومصر التي بنت الهرم لا تخاف من أكذوبة، لكنها لا تسمح أن يعلو صوت الكذب في ساحتها دون ردّ.نقولها لا نعتذر عنها: مصر ليست قصة يتنازعها الغرباء، ولا سردية تُلوَّن وفق هوى من يريد أن يرى في مرآتها وجهًا شبيها به. مصر حكاية أكبر من أن تُختزل في لون، أو تُسلب باسم العدالة الزائفة.إن ما حدث في مهرجان القاهرة ليس عابرًا، ولا ينبغي أن يُمرر وكأنه زلة لسان من ضيفة. بل هو ناقوس يُدق، لا لزرع الخوف، بل لإيقاظ الوعي.فمن لا يدافع عن حكايته، يقرأها لاحقًا بلغات الآخرين.