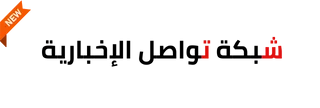محمد سعد عبد اللطيف: قصة قصيرة.. على رصيف الغياب

محمد سعد عبد اللطيف
من قطار الشرق المتجه من ميلانو إلى برلين، عبر جبال الألب السويسرية، بدأت الرحلة دون وعد، ودون يقين بما ينتظرني عند المحطة الأخيرة. كان الشتاء في أشد سطوته، والثلج يكسو القمم البعيدة، بينما تتلوى القضبان بين الأنفاق والأنهار المتجمدة، حاملةً مسافرين من شتات الروح والمنافي.في عربة القطار التي غابت فيها أصوات المحطات خلف هدير العجلات، جلستُ أمامها للمرة الأولى. كانت تحمل في يدها حقيبة جلدية صغيرة، وعلى صدرها حرف “A” منمّق، كأنه توقيعٌ لمصيرٍ مُعدّ سلفًا. نظرتُ إليها، فالتقطتُ لمحة من تلك الغصة الدفينة في عينيها؛ عينان سوداوان، تشعّان تعبًا وحكايا لا يفسرها الكلام.
وُلدتْ عايدة في مخيم صبرا وشاتيلا، وترعرعت بين جدرانه التي شهدت على أحلامٍ ضائعة ووجعٍ لا يبرأ. سمعتُ قصتها للمرة الأولى حين اعترفتْ لي ــ بين همستين وثغاء عربةٍ خرساء ــ بأن زوجها كان من بين شهداء الضربة الجوية الإسرائيلية على مقرّ منظمة التحرير في شطّ الحمامات،فؤ تونس حيث مزق المساء رياحًا من الغدر والحزن. وبعد شهورٍ من الانكسار، قررت أن تنطلق من تونس إلى ألمانيا، باحثةً عن صمتٍ جديدٍ يواسي روحها المنكوبة.لم يكن لقاؤنا مخططًا. التقيتُ بها في محطة ميونيخ؛ أنا قادمٌ من قلب الألب، وهي رافضةٌ أن تستسلم للغربة. نهضتُ مسرعًا لأساعدها في جرّ حقيبتها، وكدتُ أتعثّر حين لاحظتُ دموعها تخطّ مسارها على وجنتيها، بينما كانت تفتح هاتفها على أغنية “أول قضية حب” لوردة. فجأة، ارتجف قلبي معها؛ كأن موسيقاها استدعت غيمة حنينٍ أبدية.
طوال الرحلة إلى برلين، لم نتبادل سوى جملٍ قليلة؛ كلماتُنا كانت تسترق طريقها من بين أطراف الأصابع. لكن صمتنا كان أعمق ألف مرة؛ فقد صار لعاب القطار أول راوٍ يصغي إلى همساتنا الداخلية. رأيتها تلتفت نحوي حين مررتُ يدي على زجاج النافذة لأمسح قطرات الماء؛ نظرةٌ من يعرف تمامًا أن خلف الصمت كنوزًا لا تعالجها الكلمات.حين وصلنا إلى برلين، ارتسمت على شفتيها ابتسامة هزيلة، كأنها تقول: “هذه المدينة ستحتوينا، لكنها لن تمنحنا إلا بدايةً ثانيةً من الجرح.” مشينا سويًّا نحو حيّ كرويتسبرغ، حيث وقع وجه المدينة بين دفاتر رسوماتها وأوراقي المتناثرة. وفي مقهى صغير على زاوية شارعٍ ضيّق، شاركتني قصصها عن النساء اللواتي صبرن في المخيم، ثم عن حزنها الذي وُلِد من وداعٍ لم يكتمل.سألتُها، بنبرةٍ حاولتُ أن أخفي فيها دَوْرَة الأسى: — وهل تعتقدين أن الحياة تمنحنا فرصًا ثالثة..؟
نظرت إليّ ببطء، وأغمضت عينيها للحظة، قبل أن تردّ: — الحياة لا تعيد كتابتها، لكنها تسمح لنا باقتطاع فصولٍ جديدة من بين سطور الألم.تعالت ضحكتها خافتةً حين طلبتُ منها أن تُقدّمني إلى بيتها المؤقت، فكانت شقتها برج الأزهار المهشّمة في شارع كارل ماركس، شارع حيوي. هناك، أمام نافذةٍ مطلة على أشجارٍ لا تعرف الغياب، سردتْ لي كيف تذكرتْ أمها وأختها في كل مرةٍ تسمع فيها “أول قضية حب”، وكيف أن الموسيقى كانت الملجأ الوحيد لصوتٍ بداخلهما لم يمت.في تلك اللحظة، أدركتُ أننا، أنا وعايدة، كنّا ثالثَ شخصٍ لم يولد — شخصًا جمع بين ذاكرةٍ ترفض الانكسار، ورغبةٍ لا تهدأ في الكتابة عن الحب الصامت الذي يعبر الحدود ويهوى الصدف. رفعتُ قلمي ورصفتُ الدفاتر أمامها، وأخبرتها: — دعينا نكتب هذه اللحظة. لا نتركها تفلت من بين أناملنا.
فتحتْ دفترها، وبدأنا معًا ننسج حكايانا: هي بحروف ألمها، وأنا بأحرف اشتياقي. سطرنا فيها بداية روايةٍ لم تبدأ بعد، روايةً عن لقاءٍ ثالثٍ يجمع بين قلبين أثقلهما الصمت، لكنه بدا في تلك الليلة أكثر وفاءً من أي كلام.في رحاب الصمت
ظلّ ضوء المصابيح الخافتة ينساب عبر نوافذ العربة، يرسم خيوطًا من الدفء على وجهي المتعب. لم تكن المحطات سوى أسماءٍ عابرةٍ في دفتر الحنين، وأصواتها لا تصلُ إلا كأنها صدى بعيدٍ يطفئه هدير العجلات. جلستُ في المقعد الأخير، أسترق النظر إلى ظهور الركاب، متمشيًا مع خيالي في دروب الغياب.كان يغمرني شعورٌ بأن هذه الرحلة خرجت عن سياقها اليوميّ، كأنها طقسٌ قديمٌ يكرره القدر في أحلك ليالي الشتاء. لم تكد تمرّ دقيقةٌ حتى استقرّت عيناي على صورةٍ مألوفة في قلبي: المعطف الرمادي، الكتاب المطوي بين يديها، ونظرة تبحث عن أمنٍ صامت. في تلك اللحظة، شعرتُ أن صمت العربة تحوّل إلى جسرٍ يربط قلبي بها من أول نظرة.رفعتْ عينيها نحوي بلطف، فارتبكتُ كما لو كنتُ طفلًا يسأل عن اسمه لأول مرة. توقف الزمن للحظةٍ واحدة، وسرت بيننا أنفاسٌ خفيفةٌ تتوارى بين خيوط الدخان المتصاعدة من فنجاني الشاي. لم تتكلم، وكأن كلماتها استودعتها في صندوقٍ يمتلئ بالحلم. ابتسمتُ برهة، ثم همستُ في داخلي: “ربما يكفي الصمت ليقول كل ما لا يجرؤ الكلام على اعترافه.”
حين وصلنا إلى برلين، بدا لها أن المحطة رأفت بنا، فترددنا في النهوض، كأننا نرتجف من خوفٍ جميل لم نعهدْه. جمعتْ كتابها ببطء، وأدركتُ حينها أن هذا اللقاء لم يكن صدفة، بل قدرًا باذخًا، يكتب فصوله بخطوطٍ من نورٍ وصمت. خرجنا معًا من العربة، وامتدّ أمامنا رصيفٌ يبحر في ضباب المدينة، يحمل في ثناياه أجنحة الأمل والألم معًا — بدايةً لروايةٍ لم تُكتَب بعد: الوداع الأخير في محطة برلين….عدتُ وحيدًا إلى هامبورغ، محملًا بذكريات لم تكتمل، وحنينٍ لم ينتهِ.
في مقعدي بجوار نافذة القطار، كان الثلج يتساقط ببطء، وكأنه يغسل آخر لحظات الوداع عن الأرصفة.
كانت عايدة تقف هناك، على مدخل المحطة، وعيناها تقولان كل ما عجزت الكلمات عن البوح به.
لحظة وداع جمعتنا بالصدفة… وقطار فرقنا إلى الأبد.
لم تكن لحظة رومانسية كما في الأفلام، بل لحظة كاشفة، صامتة، فيها من الألم أكثر مما تحتمل الروح.
لم أدرِ وقتها إن كنت أودّع عايدة… أم أودّع جزءًا مني.في مرآة الزجاج المرتجف، لمحتُ ملامحي كما لو كنتُ شابًا في مقتبل العمر، يسافر لأول مرة، لا إلى مدينة… بل إلى حياته.
وها أنا، في المنفى، أكتشف أنني لم أكن أبحث عن وطن… بل عن وجهٍ يطمئنني أنني لست وحدي.
.ما زالت أغنية وردة تُحاصرني:
“غلاب يا حكم القدر…
مش هقولك الوداع…
لا تختبر دمعي.”
ورائحة نصف التفاحة التي اقتسمناها في القطار…
ما زالت تُشعل دفئًا في أصابعي، كلما تذكرتُ أنني كنتُ يومًا حيًّا،
على متن قطار، بلا قضبان… سائقه مات، وينتظر الارتطام….!!
محمد سعد عبد اللطيف ،كاتب وباحث مصري