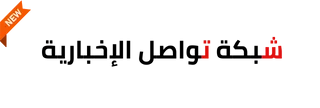حميد عقبي: الشاعرة نادية يونس: طقوس يومية فلسطينية في زمن العطب وبحث عن بقايا حياة

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
حميد عقبي
في نصها الشعري والذي نشرته مؤخرًا لم تتحدث الشاعرة الفلسطينية نادية يونس عن الحرب، لكنها تضع القارئ في مواجهتها دون أن تقول الكلمة صراحة. هنا، امرأة تعيش في منطقة ظلّ، حيث الخوف لا يُعلَن، والحرب تُعاش مع كل شهيق وزفير. تحضر في هذا النص مع كل تفصيل صغير: في نصيحة طبيب، في صوت بائع القهوة، في حكمة جارّةٍ متعبة، في ملامح مدينةٍ ترفع رأسها رغم الأيدي المبتورة.
القصيدة لا تصرخ، لكنها تكتفي بأن تهمس ببطء وألم. لقطات سريعة، تقطعها الكاتبة كما تُقطع الحياة في لحظات الترقب والخسارة. لا مناجاة ولا ترجٍّ، لا خطابات مباشرة أو استعطافية، فقط سلسلة من الطقوس اليومية، التي تتحوّل، تحت وطأة الزمن والانكسار، إلى طقوس رغبة في النجاة المؤقتة.
تمارس المرأة هنا نوعًا من المراوغة مع الحياة، إذ تواري رعبها خلف أقنعة التفاصيل: تنظيف، صبغات، ملح، قطط، وخبز. تسرد اليومي كأنها تمارس طقسًا دفاعيًا ضد الانهيار، تفتح أبواب الفقد ولا تدخله، تلامسه فقط بظهر الكف.
وهكذا، يتحول النص إلى كولاج شعري للحياة في زمن العطب، حيث تُمسي القصيدة مظهرًا من مظاهر تصوير الواقع والاحتجاج عليه. هنا، الحب يحتاج إلى شيء من مذاق الحياة، يقف الحبيب في طابور الخبز، وقد لا يعود سليمًا.
نص للشاعرة الفلسطينية نادية يونس:
اتبع رغبتي بالتخلص من الألم
طبيب الجلد ينصحني بالصبر
وبائع القهوة على زاوية الشارع
تحت الشمس،
المرأة التي أصابها الفقد بالجنون
وتكتسب الحكمة كالآخرين
حين لا يتعلق الألم بها مباشرة
المدينة التي تخرج رأسها لتستعيد بيدين مبتورتين الأشلاء
التي قسمها الله
على الريح والوقت
النجار الذي يعدك ببعض الترميم
واستبدال ألواحك كما لو كنتَ سفينة ثيسيوس
دون أن يلتفت إلى الجدال الفلسفي
حول ما إذا كانت السفينة تبقى ذاتها بعد كل هذا
جارتي التي تستخدم الصبغات أكثر من الكلام
والحلاوة أكثر من الأرز
ومنتجات العناية بالعمر حيث تبدو النجاة ممكنة
السيدة التي تنظف البيت كأنها تفعل للمرة الأولى
التي تخرج الملابس الداخلية من تحت السرير كما لو كانت تمارس طقسًا مقدسًا
وترش الملح عن الكتف درءًا للحسد
وقلة البخت
وحبيبي الواقف في طابور الخبز
أتبع رغبتي ثم أبحث
عن مسكّن موضعي
بينما أنشغل بالقطط التي رموها هناك
تحت الشمس.
في نصها الشعري، تكتب نادية يونس من قلب التراجيديا الفلسطينية، لم تلجأ إلى البكائيات أو الشعارات، وسنلاحظ أنها فتحت لنا نافذة صامتة على واقع مهتز ومليء بالخوف والانتظار. لم تحاول الشاعرة أن تجمّل الألم أو تستسلم له وتقبله كقَدَرٍ حتمي، ولا أن ترفعه إلى مقام البلاغة، بل سردته كما هو: يحضر في الهواء، في وجوه الناس، في روتينهم اليومي، في الطقوس الصغيرة التي تُمارس كنوع من النجاة المؤقتة والبحث عن ذرة حظ وحياة.
القصيدة قائمة على بنية أشبه بـ”الكولاج الشعري”، حيث تتعاقب مشاهد قصيرة جدًا، لقطات يومية خاطفة، شخصيات هامشية: طبيب، بائع، امرأة جارّة، نجّار، جارة تضع الصبغات، حبيب في طابور الخبز… كلهم يمثلون شظايا من هذا الواقع. سنجد أن حضورهم يُظهر كيف يتسلل العطب الكبير في تفاصيل الحياة اليومية الصغيرة. لا نجد حديثًا مباشرًا عن الحرب، لكن الحرب حاضرة في كل سطر، في كل صوت، في كل همسة عابرة، وحتى في القطط المهملة تحت الشمس.
من خلال كل هذه التفاصيل، سنجد أن النص يدين الواقع القاسي، لا عبر صراخ أو استغاثات لكسب الشفقة، ولكن من خلال إصراره على توثيق ما يحدث، على تسمية الأشياء بأسمائها، دون تجميل أو تهويل. النص يُدين من صنع هذا الواقع، ليس باحتجاج غاضب مباشر، بل بإظهار أثره على الإنسان العادي، على النساء اللواتي يختبئن خلف التنظيف أو الصبغات أو الخرافات الصغيرة، وعلى المدن التي تحاول لملمة أشلائها بأيدٍ مبتورة.
وبين كل هذه الصور، تقف المرأة – صوت النص – كراوية ومراقبة، تمارس طقس المواربة، لا لتخفي الألم بل لتُبقي على احتمال النجاة. لا تبحث عن الخلاص الكامل، بل عن مسكّن موضعي، عن طريقة للعبور من يوم إلى آخر.
النص خالٍ من التكلّف، لم يستخدم اللغة كأداة بلاغية، بل كمرآة شفافة للواقع. جماله يكمن في بساطته، وفي فنيته المتقشفة، دون الوقوع في السطحية. بهذا المعنى، تصبح قصيدة نادية يونس من الوثائق الشعرية الحية، التي تلتقط طقوس الحرب والخوف، وتواجه الموت بالصبر والتوثيق، لا بالاستجداء.
في ظل المأزق التراجيدي والمأساوي الذي تعيشه فلسطين وبلدان أخرى أصابتها نكبة الحرب، تصبح الكتابة فعلًا وجوديًا، ومسؤولية أخلاقية. من هنا، تأتي أهمية قراءة وتوثيق ما يكتبه شعراء وشاعرات فلسطين وهذه البلدان، خاصة في هذه اللحظات الحرجة. هذه النصوص لا تروّج للحرب، لكنها تُدينها بصدق، تبحث عن القليل من الحياة، وتحتفي بالحب كوسيلة للمقاومة.
لا أحد يريد الحرب والموت، فالحرب هنا أشبه بطاعون مدمر، يعصف بكل شيء، ولا يترك إلا الألم والخراب. إن الإصغاء لهذه الأصوات هو ضرورة إنسانية لفهم الحقيقة من داخلها.