د. إشيب ولد أباتي: موريتانيا: لماذا لم تستطع النظم السياسية رفض التبعية للبناء الاجتماعي.. وقوى الخارج؟!
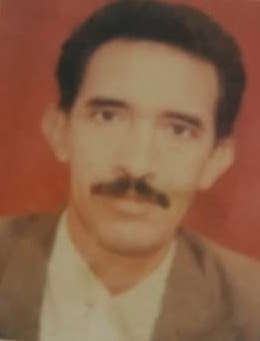
د. إشيب ولد أباتي
لأن قيادة النظام السياسي،غداة الاستقلال الوطني سنة ١٩٦٠م، وجدت نفسها مدفوعة بتيار استسهل المقاربة الممكنة في إيجاد مركب اجتماعي في مدينة العاصمة التي اختير لها موقع على شاطئ الاطلس، لتترسخ هويته العربية، بواحدة من عواصم العرب في المغرب العربي، وهذه الإضافة للهوية، ربما كانت إسمية فحسب، لكنها اليوم، تجاوزت الرمزية السابقة، لمؤثرات سيأتي الحديث عنها في موضوع آخر..
والجواب على السؤال، يحيل إلى اتجاهات الرأي الوطني العام، في وسائل التواصل الاجتماعي عن النظام السياسي، وما أسس عليه
من الوزارات الاسمية لتشكيل قواعد لدولة حديثة، و لازال معظم بناءاتها موجودا قبل ستين عاما، ووضعها يشف عن عزيمة من فكروا في تدشين مشروع الدولة في تلك العنابر المنفصلة عن بعضها البعض، ولو أنها متقاربة،،
وبدأ القادة يسحبون الساكنة من المناطق، كما استجلبوا بعض الأطر الذي شكلت نواة للمهاجرين، ولقادتهم السياسيين للإثنية الثانية في المجتمع الموريتاني الجديد،، وقد اندمجوا، هم، وكذلك حال احفاداهم، وامتدادتهم الأخرى خلال ستين سنة من عمر جيلين، سعيا لإعادة تركيبة المجتمع، وبنائه، بما يجعل البناء الاجتماعي، يكاد يصبح مشلولا في هيكله، ليظهر، وكأن الشلل نتيجة ترضخ أصاب نخاعه الشوكي، وليس نتيجة تركيب لطرف اصطناعي، هو ما تمثله هذه الإثنية الموازية للمجتمع العربي في موريتانيا الذي يراد له اليوم إعادة التركيبة الاجتماعية في بنائه العام..وهذا لن يمر كما يتصور المغامرون، ولعل ما شجعهم على ذلك بعض العوامل المؤدية للضعف العام في الجسم الاجتماعي ابتداء من النظم السياسية السابقة، وهي في واقع الأمر نظام سياسي واحد، رغم تعدد رؤسائه لظروف داخلية، وبعضها مرتبط بالتدخل الفرنسي، وتعسفه في فرض نفوذه الاستماري على نظام الحكم…!
لكن ذلك لم يمنع من الرؤية التي حكمت سلوك القادة، وهي أقل ما يمكن أن يقال بشأنها، هو الساذجة إذا جاز التوصيف فيما يزعمه بعض الدارسين، ويؤكده تسلسل الأحداث، فالرئيس الأول، الراحل المختار ولد داداه رحمه الله تعالى، توقع خطأا، أنه اشترى من فرنسا حرية التصرف في نظامه، وانه سيواجهه أهل زوجته بالسكوت، ولو على مضض، فقام باصلاحات ضرورية، كتأمينه لشركة الحديد، وصك العملة الوطنية،، وكان تفكيره عربيا صرفا في ذلك التوقع الساذج الذي لا زال موجودا في العقل الجمعي في مجتمعاتنا العربية.. ذلك أنه حين يتزوج الرجل من جهة خارج محيطه الاجتماعي، فإن انسابه يغضون الطرف عما يبدر من سلوكه المفاجئ لهم..
إن تعزيز دور السيدة الأولى ذات الهوية الفرنسية، يستحضر نوعا من محاولة إسكات فرنسا، عما قام به زوجها في تسيير نظام موريتانيا، ولأن السيدة، كانت حاضرة بثقافتها الحقوقية في وضع الدستور، وقيادتها لحزب الشعب، وتأثيرها على شباب الحزب، و في تحويل الماركسيين” الكادحين” – الاسم الذين اختاروه، لأنفسهم لإضفاء الصبغة الاجتماعية، واضعاف خصوم الملحدين الماركسيين في مجتمع ثقافته الدينية، تشكل اقصاء لهم، رغم ترويج بعض العبارات الماركسية التي لم يدرك الرأي العام معناها حينىذ، كقول ماركس :” إن ثورتنا في الأرض، وليست في السماء”؛ وعملت سياسة الغموض، والتخفي وراء الاسماء، ومأسسة النظام والحزب معا، ونظرا لتأثير السيدة الأولى التي فرضت رؤية الاشتراكيين الفرنسيين على الكادحين..
بينما النظام السياسي، لم يحمل نفسه مسئولية قيادة مشروع للتغيير، وإنما اقتصر تطلعه على إيجاد مجتمع مصغر من المجتمع العام لقيادة كيان سياسي مندمج في البناء الاجتماعي العام، كاقصى ما كان يطمح اليه قادته..
ولذلك لم يحصل بين النظام السياسي، وبين التركيبة القبلية، ووحداتها، صراع بين الهويات الفرعية، وبينه على المصالح، بل إن الهوية القبلية العامة، كانت الهوية المميزة للنظام على تلك الأنتماءات الفرعية…
و هذا يؤكده سعي النظام منذ البداية للحصول على من يتبناه،، رغم ما يظهر على السطح من قيادة سياسية، وتكوين مؤسسات إدارية، وقضائية، وتشريعية، واجهت نفسها، بمعاول الهدم في العدول عن المشاركة في العمل السياسي خارج نظام الحكم، كما حصل مع القيادي الراحل ” بوياكي” رحمه الله تعالى، ومنع التعددية الحزبية، إذ أصبح النظام شموليا، رغم الطابع المدني له دون ان يتبى مشاريع التغيير الاجتماعي، كأساس للتغيير السياسي…
كما حصل في “كنبوديا”، ورغم المآسي التي واجهتها المجتمعات القبلية أثناء التحولات السياسية الكبرى في مختلف المجتمعات المتخلفة حضاريا..
وذلك لصعوبة ” تكيفها”، مع التغيير السياسي والاجتماعي، وإقامة نظم سباسية، شكلت، وتشكل الوزارات قطاعات أولية لشكل النظام البديل لتركيبة البناء الاجتماعي القبلي، والفئوي، كالذي في موريتانيا كان سائدا منذ القرن الثامن عشر حسب المصادار التاريخية..
نعم عانى المجتمع ” الكمبودي” من مرارة التجربة الماركسية، ومن المآسي الفظيعة، وسواء، أكانت تلك المآسي هي الذدتي أفشلتها، أم غيرها، لكن التغيير الاجتماعي، لابد من دفع ثمنه على إحدى الواجهتين: الاجتماعية، أو السياسية،،
فمهادنة النظام السياسي السابق في ليبيا، وتسيد الدور القبلي في كل مناشط الحياة بما فيه التشريع التشريع العرفي غير المكتوب، على التشريع العام،، انتهى في آخر المطاف إلى تفكك المجتمع في بعده الحداثي، ومساعدة القبلي لقوى الخارج لإسقاط النظام السياسي، رغم أن العواقب كانت مشتركة على النظام الاجتماعي، والسياسي معا…
وموازات ذلك، خلال مرحلة الستينيات، حصلت تجارب عديدة تأسست خلالها انظم سياسية مدنية، وعسكرية،، ولكن ما جرى في موريتانيا، كان يجترح حلوله الخاصة من اللاحلول ، إذا جاز العبير، في نظر الباحث الاجتماعي للأوضاع العامة، وتنامي النفوذ القبلي، وتراجع دور النظام السياسي عن مشروع التحديث ، فقد يكون جهل الرؤساء العسكريين مسئولا واللااستقرار السياسي، واحدا من عديد العوامل، وفي كل الاحوال، فقد ارتفع الضجيج لغاية الإلهاء، والتهويم، من حناجر ثقافة الأعراف الاجتماعية، والعادات البالية، وفي ذات الوقت غاب، أو غيب دور الفرد، ودجنت النخبة المتعلمة، وتحولت الى” سدنة”، متهافتة، تتشدق بعبارات الولاء الاستحماري في تبرير سوء التدبير العام…
بينما تسيد نفوذ رموز العوائل، والأسر مما عزز قيم “الثبات” ، واقصى قيم ” التغيير السياسي” السابقة على الحداثة بقرون في مجتمعات اليوم، مهما قيل عن سياسة حرق المراحل، واختزل التحديث في المظاهر الملبوسة، والنقل الخاص، و الموضة في الاصطياف في الدول الغربية، والتهجي بالفرنكفونية في الإدارة، ومؤسسات النظام، واخضاع الجميع لسياسة واقع الحال من اكراهات فرضت النظام السياسي باعتباره ” معادلا موضوعيا ” يعتاش على فتاته رموز المجتمع في مدنه، وقراه، كما في هرم نظامه السياسي..
…….
ولكن متى، ستبقى هذه الأوضاع قابلة للأستمرار في ظل النمو الديموغرافي الحاصل، وقد يشكل في المستقبل القريب اختلالا في التركيبة الاجتماعية العامة التي هي بمثابة قطب الرحى للمجتمع، و للفئات الاجتماعية التي تسعى للخروج من نمطية المجتمع الفئوي، بل تزعم الحراك السياسي بعد نكبته التي حصلت منذ الثمانينيات، حيث ظهرت تيارات القومية العربية منذ السبعينيات، والتيار الماركسي الذي انتهت به البراغماتية إلى الاندماج في حزب الشعب، ومن ثم توجيه عسف سياسة الدولة العميقة، وتحين الفرص، وظهور الإجرام السياسي في الحسابات السياسية التآمرية، ووضع الخطط لتصفية القوى الحية في الحراك السياسي العروبي في المجتمع الموريتاني،،،
واستبدال الحراك الوطني والقومي باحزاب قبلية، وجهوية، وعرقية، وفئوية، وهي اليوم اركان النظام السياسي “دار لقمان”، الذي بقي على حاله، يستقطع من النظام القبلي رموزه، كنماذج مطلوبة، ويدار تفعيلها واخراحها من قمامة السياسة بعد التقاعد للتسيير السياسي بالتوزير، والاستشارية، كالإشراف على الحوار السياسي الذي اعلن عنه، وكذلك لاسناد حزب (الإنصاف) الحاكم، كواحد من أركان الحكم المعتمد على التجار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين – وطالما ردد هذه العبارة مسئولو النظام –
وقد ينظر البعض إلى هذه العناصر المتصالحة مع نفسها، كلاعبي سرك في مدينته المتنقلة، حيث تطغى مواسم مهرجانات الانتخابات البلدية، والتشريعية، والرئاسية، والجميع اقرب الى مهرجين السرك في الرقص، والغناء ، والحبور، وغيرها من مظاهر الترف، والبذخ، ولعلها مظاهر معبرة عن الهروب من واقع اجتماعي مأساوي، جراء الفساد المستشري إداريا، وماليا، مع غياب التخطيط، وبناء مشاريع التنمية الاجتماعية.
لذلك ارتفع الاحتقان إلى أعلى درجاته في تصريحات المستطلعين، من قادة الفئة الاجتماعية ” لحراطين”، وهي الفئة الأكثر تضررا جراء تجريم العبودية قانونيا في أول قانون في بداية الستينيات، ونظرا للجفاف العام خلال العشرين سنة ، وارتفاع نسبة العمالة اليدوية الرخيصة من مالي والسنغال،،
يضاف لذلك ظهور رموز سياسيين، استغلوا أصوات فئة” لحراطين” انتخابيا…
وكون التفكك الاجتماعي، هو جزء من سياسة فرنسا، كان معروفات أن فرنسا ستتبنى هذه الرموز الانتهازية، وتدافع بهم عن مصالحها، لذلك فهم سيفاد في لتهديد النظام السياسي..
وبعض هؤلاء الانتهازين من فئة لحراطين الذين تحالفوا مؤخرا مع العنصريين في الإثنية الأخرى، ليظهروا ، ك ” نوابت” – بمفهوم ابو بكر الباجي في( تدبير المتوحد) – من الأعشاب، لكنهم مهيأون لقيادة هذا التكتل الفئوي – العرقي، وهو يشكل في مجموعه عصبية صاعدة – بالتحليل الخلدون – ستكون هي المشروع التفتيتي، وليس التغيير السياسي، لأن ليس له رؤية لذلك،، ولكونه واضح الهدف في انتهاج سياسة التدمير للبناء الاجتماعي عموديا، وأفقيا، لذلك وجد هذا التحالف العنصري اسنادا من الداخل والخارج معا، وذلك منذ بداية سنة ٢٠٢٥م حين توالت موجات الهجرة غير النظامية التي حركتها المنظمات الأوروبية التبشيرية، والسياسية، والهيئات الحقوقية العنصرية في الدول الاقليمية، كما في موريتانيا، حيث ركزت المنظمة الحقوقية الموريتانية على التشنيع، والتظلم نيابة عن المرجعين إلى اوطانهم من الماليين، والسنغاليين،
وهذا التنديد التعسفي ليس له ما يؤكده في الواقع بعد أن أكد مؤخرا مسئول الأمم المتحدة في العاصمة، أنه اشرف في زيارته المتعددة لمراكز التهجير على الترحيل الذي احترم كل الحقوق المنصوص عليها وطنيا، وداليا..
لأن النظام السياسي واجه الهجرة باسلوب مرن، وقانوني، لكن في نظر رئيسة هيئة الحقوق الموريتانية ذات الوعي السياسي العنصري، تنظر للتهجير من حيث المبدأ،على انه غير قانوني، ويخالف تصوراتها السياسية، وليس الأعراف الدولية، لأن أي اختلال في التركيبة الاجتماعية الموريتانيا، يحقق للهيئة مآربها على مستوى تغيير هوية البلاد، بعد تغيير نظامها السياسي الذي أضحى جزءا من البناء الاجتماعي القبلي..
ومن يسعى لتغييره بهذا الأسلوب، سيعمل ضرورة على تفكيك الوحدة الاجتماعية، وربما الديمغرافية، وتبعاتها، وكل منهما غير واضح النتائج للمنظرين، والموجهين للرأي الوطني العام،،
وسيبقى الوضع السياسي، والاجتماعي في موريتانيا، داعيا للقلق الشديد بسبب غياب الوعي، واجراء لدفع المخاطر بإصلاح سياسي، وإداري، ومالي، والعمل الفوري على إيجاد حلول اجتماعية، تطرح لمواجهة الغبن الاجتماعي، والتهميش، والحرمان، وارتفاع منسوب الهجرة من الوطن الى امريكا، وأوروبا.
لذلك فالمسألة الاجتماعية، تفرض نفسها كاولوية في مواجهة التحديات، واجتراح استعجالي لتذويب الفوارق الاجتماعية بين الفئات الاجتماعية التي يسعى لقيادها الانتهازيون ،،،
والسؤال الذي يبحث عن جواب عملي، هو:
هل سنشهد انتهاج سياسة تذويب الفوارق الاجتماعية على غرار تذويب الفوارق بين الطبقات في المجتمعات الطبقة، او تذويب الفوارق بين “البدوتاريا”، و”المدن تاريا” على حد تعبير الراحل عبد الفتاح اسماعيل، في حكمه الماركسي لجنوب اليمن سابق،،،؟
كاتب عربي موريتاني
