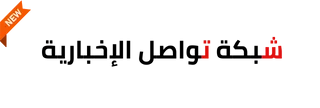معمر فارح: جربة.. السّحر والاصالة

معمر فارح
مرة أخرى، استيقظ على رحلة جديدة. نافذتي الوحيدة المفتوحة على ما يُطلق عليه، ربما بشكل خاطئ، “الخارج”. لكن، هل تونس حقًّا تمثل الخارج؟ بضعة كيلومترات، لمحة من التّاريخ، حدود لا تأبه بها ريّاح الصّحراء… وها أنا هنا على الجانب الآخر، على هذه الأرض الشقيقة التي تتحدّث لغتي، وتشارك أطباقي، وتعبيرات وجهي، وصمتي. ليست غربة، بل هي امتدادٌ لنفسي. ولكن، الآن، يجب أن أواصل سيري نحو الجزيرة السّاحرة. رحلة ستستغرق نحو ثماني ساعات.
جربة. كل عام، أبحر نحو هذه الجزيرة، هذه البقعة الهادئة في العالم، التي يجب أن أزورها كما أزور صديقة قديمة وفية. إن لم أذهب إليها، أشعر وكأنّ شيئًا ينقصني، وكأنّ عدم التوازن يتسلّل إلى نفسي. أصدقائي يفضّلون السواحل المزدحمة في الحمّامات، والفنادق اللاّمعة في سوسة، وشُرُفات ڨمرت، أو بطاقات البريد من بنزرت. يبحثون عن الراحة وضجيج الحياة، أحيانًا عن وهم حداثة مستوردة. أمّا أنا، فأبحث عن الأصالة والسّحر، وأجدهما دائمًا في هذه الجزيرة التي كان القدماء يسمّونها جزيرة اللّوتس. أرسل هوميروس أوديسيوس (Ulysse) إليها، تذكرون، في أوديسا التي لا تنتهي. هناك، وصل مع رفاقه، الذين تذوّقوا ثمار اللّوتس وفقدوا على الفور طعم العودة. هذا هو سر هذه الجزيرة: إنها تسحر القلوب. توقف الزمن، وتهمس لك بأن لا شيء في عجلة، وأن كل شيء يمكنه الانتظار. أتفهّم البحّارة اليونانيّين، الذين تشتّت أفكارهم وسط هذا الهدوء الذي يخدّر الآلام. أنا أيضًا، كلّما وطأت قدماي هذه الأرض، أنسى سباق العالم. أبدو رجلًا بسيطًا، رجلًا حرًّا. السّماء هنا أكثر قربًا، أكثر حميميّة. البحر يتحدّث، والضّوء يلتصق بالجدران البيضاء كما لو أنه لا يريد الرّحيل. نتناول الصمت كما نتناول خبزًا دافئًا، وكل حجر هنا يبدو وكأنه قد خرج من بيت شعر هوميروس.
مطر خفيف، خجول، مهذّبٌ، ينزل على الجزيرة. هو يوم المغادرة. اركب العبّارة أشعر بطعم الفراق المالح.. دموع خفيّة، تسقط من سماء متواطئة، ترافق آخر نظرة، بينما تبتعد الجزيرة في هيجان البحر. جربة تبكي بصمت، بطريقتها الفريدة: خجولة، رقيقة، لكنها تحمل في طيّاتها فرحًا غامضًا. وكأنها تقول: “عد بسرعة يا صديقي.”
وداعا جزيرتي.. مازلت اسمع خطوات أوديسيوس، وغناء اللّوتوفيجيين، ودقّات قلبي مصاحبة أنفاس الريّاح. لن يزول شيء ما دمتُ أداوم على الكتابة والحلم.
أنا أغادر… نعم.
لكن جربة، هذه الحبيبة الصامتة، لا تفارقني.
تسلّلت إليّ خفية، عبر مسام الجلد، بين خفقة وأخرى من قلبي، واستوطنتني كما تستوطن الأحلام المدى البعيد.
هي هنا… حيّة، تهمس كسرٍّ عتيق، كحكاية لا تحتاج إلى لسان يرويها. يكفي أن أغمض عيني… فتولد من جديد.
جربة… ليست مجرّد أرض تحيط بها المياه.
إنها نشيد خفي، يتردد في عمق القلب، لا يتعب، لا يشيخ.
لحن قديم يلتصق بالروح، فلا نحاول أن نتخلص منه، لأننا ندرك، في قرارة أعماقنا، أنه جزء منّا… إنّه نحن.
نظن أننا نبتعد، أننا طوينا فصلاً من الحكاية، لكن يكفي أن يعبرنا عطرٌ غامض، أو أن تلامسنا شمس خفيفة من آخر النهار، أو أن نسمع صرخة نورس ضائع، حتى نجد أنفسنا هناك… في حضنها… كما لو لم نغادر أبدًا.
جربة لا تطرق الأبواب.
تدخل كما يدخل الضوء من شقوق القلب، بهدوء، بلطف، بلا استئذان.
تنسج عشّها في زوايا الروح، وتصير مع الأيام رفيقة سفر…
نتحسّسها في المدن الرمادية، ونستدفئ بها في ليالي الشتاء الباردة، حين يغتالنا الغيّاب.
أتوقّف.
لحظة خفيفة… أترك اللّيل يتسلّل إليّ.
السّماء تشتعل فوقي كعرس صامت، والنّجوم — يا لتلك الرّفيقات العتيقات — تبتسم لي بعين من يعرف ولا يقول.
وفي هذا الصمت الذي لا يخلو من حياة، أدرك…
المسافات لا تقتل الحب. والزمن لا يمحو الذاكرة.
مهما تشعّبت بنا الدروب، ومهما ابتعدنا، سنعود في النهاية.
لأننا لا نهجر منبع الحياة فينا.
لأن جربة ليست صورة مؤطّرة على جدار الذاكرة… إنها مأوى.
ملاذ أخفيته في أعماقي، وعندما أحتاج إلى بعض الدفء… يكفيني أن أغمض عيني.
جربة… يا نعمة الايّام…
يا بيتي الذي ظلّ ينتظرني… وراء الماء.
أستسلم… للموجة التي تمرّ كهمسة، وللظلّ الذي يتراقص فوق صفحة البحر.
لا صخب، لا ضجيج.
سعادة خافتة تلمع في ذهب الشّمس السّائل، تتنفّس ملح الأزمنة القديمة، وتستقرّ هناك، في فسحة الصّمت حين يكفّ الإنسان عن ملاحقة الوقت.
وأنا أعلم…
سأعود إلى هذه الشواطئ. ربما لا يحملني جسدي، لكن روحي… ستجد طريقها إلى هنا.
سأعود إلى الجزيرة التي غسلت أمانيَّ برمالها، ومنحتني نعمة النسيان… ووهبتني فن التذكّر.
أجلس تحت نخلة وحيدة، كأنما أحتضن ظلًّا عبر القرون.
لعل “أوديسيوس” نفسه مرّ من هنا، تائهاً في وهج البحر، يرافقه رجاله، نائمون تحت دفء الثّمار النّاضجة، تسكنهم موسيقى ريحٍ لا تكفّ عن الهمس.
جربة…
ليست مكانًا، بل نَفَسٌ آخر من الزّمن، محفوظٌ في حنايا الصّمت.
هنا، تعلّمتُ أن أنصت لما لا يُقال، أن أقرأ الوجوه كما تُقرأ الخرائط القديمة، أن أسمع الحكايات المخلّدة على القوارب، و المبحوحة في حناجر الرّجال.
هنا البطء صلاة، والصّمت ديّانة لا يدخلها إلاّ من غسل قلبه من صخب العالم.
أغمض عيني…
ينهض الماضي بثيّابه القديمة.
تمرّ أم حرّاڨة اِلتقيتُ بها في شاطىء طوش، بعينين من ضباب، لا تتكلّم كثيرًا، لكن دموعها كانت تكتب رسائلها على وجه الرّيح.
ثم قدّور…
رفيق الغروب، الذي علمنا أن الجمال الحقيقي هو الذي يصمت حين تُلوّن السّماء آخر دعائها.
رحل الاثنان، لكنّني ما زلت ألمح ظلّيهما، تتمايل بين أغصان التّين، وتتنفّس في نسمات اللّيل الحانية.
هنا، المغادرون لا يرحلون.
إنهم يتحوّلون إلى جزر خفيّة في محيط الذّاكرة.
ينهار المساء بردائه الأرجواني.
“حومة السّوق” تلوّن أنفاسها بلون الطين الدافئ،
والجدران البيضاء تشتعل كشموع تتهيّأ للغرق في حضن اللّيل.
على شرفة قديمة، يتصاعد بخار النّعناع، ويعانقه صوت عودٍ حزين، كطائر يحلم بالتحليق لكنه يخشى وداع العش.
أغمض عيني…
فأجد نفسي أسبح بين ماضٍ يلوّح لي من بعيد، وغدٍ يتردّد على عتبة القلب.
وفي هذه اللّحظة المعلّقة بين سماء وأرض،
أسمعها واضحة…
دقّات قلبٍ…
حان وقت العودة إلى مادوروس.