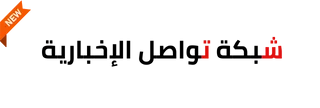زيد عيسى العتوم: “اليدين المُصَلّيتين”.. يا أبي!

زيد عيسى العتوم
أربعة عشر عاماً هي صفحات دفتري التي صرتُ فيها الحبر الذي لا يقرأ نفسه, كلماتي نَسَجَتها الظروف وسقط منها الكثير من نقط الحروف, ما زلت أكتنز ركاماً من الذكريات بين طبقات مخيّلتي عن طيب خاطر, فحتى هَمسات المارّة وجعجعة الباعة المتجولين وصوت الديك عند جارتنا لم يتركوني ولم أتركهم, في يومٍ واحدٍ أصبحتُ كهلاً ورافقتني عصا الشيخوخة عندما ودّعتُ حارتي الدمشقية القديمة, ما أشبه ذلك الوداع بانسلاخ الروح عن جسدها, كان الفناء الخلفيّ لبيتنا حصني المنيع ومسرحي المفضّل للعبِ والعراك مع رفاقي ورفاق رفاقي, كنت أحسبه المكان الأقوى أمناً والحضن الأكثر دفئاً وربما قد صار المقبرة الأكثر صمتاً من بَعدي, قيل لي إنني لو عدتُ فلربما لن أعرف الناس ولن أعرف أين تختبىء الذكريات وسأشعر بغربة الوطن, وساستغرب اختفاء الصور والتماثيل والأحصنة التي كانت فيها نظرات قاسية بلا مبرر أو عنوان, وعندما أفاقت طفولتي تسأل عن بضعِ حفرٍ قد حَفَرتها في الجدار العتيق المزركش بالياسمين, ضحك كلُّ من سمعها ثم كُشِف المستورُ من الجواب, وأخبروني أن الياسمين قد تيبّس والجدار قد وجد ضالته في التراب وأن الحفر قد تكاثرت ونضجت في الطريق المهجور.
أوقف صديقي سيارته في المرآب المخصص لزوّار متحف ألبرتينا في العاصمة النمساوية فيينا, ليس غريباً أن اسمها يحمل معنى الهواء الجميل والعبق العليل فهذا ما استنشقته كتذكرةٍ مجانية, وبين القصور المشيّدة فيها والحدائق المُعتنى بها يظهر الاقتدار وتتجلّى الأناقة, نظرتُ الى بوابة المتحف فقرأتُ المزجَ بين التاريخ الحافل والجمال الباهر, أوعز لي صديقي بضرورة النزول وطرح التأمل من الخارج جانباً فأطعته مبتسماً, بدأت أقدامنا تتجوّل كريشةِ طيرٍ سقفها السماء ومساحاتها الفضاء, كنتُ أغوص بين اللوحات المهيبة بينما أفقد السيطرة على شهقات الشغف أمام بانوراما صَنعها المَهَرةُ لا بل السَحَرة, فحتى أقدامي ضننتها قد تحوّلت الى عجلاتٍ ملساء تنساب فوق الرخام المصقول, لينبري بعد حينٍ حبلٌ من الفضول يشدّني الى لوحةٍ دعتني بأدبٍ للوقوف في حضرتها فوقفت, فاستغربتُ من بساطة تفاصيلها ثم غموض معناها فتعجّبت, يدان كبيرتان متشابكتان تشيران بزاوية الى الأعلى, تملأهما العروق التي تحاكي الشقوق, الأكمام مطوية جزئياً وصاحب الأيدي مجهول للناظر, فيأتي الفرجُ عاجلاً من شابٍ اقترب مني وحيّاني بلغته التي صرتُ أتقنها بعد لغتي وبعد سنين الغربة العجاف, أخبرني أنه يعمل مرشداً في المتحف منذ سنتين, وأنه قد لاحظ حيرتي أمام هذه اللوحة دون سواها, ثم عرض عليّ إخباري بقصتها فتمنّيت عليه ذلك وشكرته كثيراً.
الشاب: أهلاً بك يا سيدي, إن هذه اللوحة تُسمى ” اليدين المُصَلّيتين” وقد رُسمت خلال القرن الخامس عشر, ففي قرية صغيرة قرب مدينة نورمبرغ عاشت عائلة فقيرة تكونت من الأب والأم وثمانية عشر طفلا, ومع هذا العدد الهائل من الأطفال كانت ظروفهم المادية صعبة للغاية ، ورغم ذلك فقد كان للأخوين الأكبرين حلم يتحدثان عنه دائما, كان حلما صعب التحقيق بسبب الفقر, الحلم هو تعلم فن الرسم الذي كانا موهوبين وشغوفين به كثيراً، في ذلك الوقت اشتهرت في مدينة نورمبرغ أكاديمية للفنون، وقد حلم الولدان بالدراسة فيها لكن تكاليفها المادية مع تكاليف العيش في المدينة كانت فوق الاحتمال, لذا فكر الأخوان في حلٍ للوصول إلى حلمهما, وقد كانت الفكرة بأن يجريا القرعة بينهما، ومن يكسب يذهب للدراسة في كلية الفنون, ومن يخسر يذهب للعمل في المناجم ويدفع تكاليف دراسة ومعيشة أخيه لمدة أربع سنوات, ثم يتبادلان الأدوار حيث يذهب من كان يعمل في المنجم للدراسة ويتكفل من درس الفنون بمصاريفه من بيع لوحاته التي قد رسمها أو بالعمل في المناجم , أجريت القرعة وفاز بها أحدهم وذهب حسب الاتفاق للدراسة في كلية الفنون وتكفل به أخوه الذي عمل في المناجم , وبعد انقضاء أربع سنوات من دراسة أحدهم في الكلية تخرج أخيرا، وقد نال شهرة كبيرة بفضل موهبته وباع الكثير من لوحاته التي وفرت له دخلاً جيداً, وعندما عاد إلى قريته وبيته جلس مع أهله مذكراً أخاه باتفاقهما قائلا: لقد تخرجتُ يا أخي بفضل تعبك وشقائك طيلة الأربع سنوات, والآن دورك لتذهب للدراسة كما حلمت وأنا ساتكفل بكل شيء, لكن أخاه أطرق حزيناً وقال: لا أستطيع الذهاب، فأنا لا أستطيع إمساك ريشة صغيرة أو التحكم بالخطوط الدقيقة, أنظر إلى يديّ كيف أصبحتا بعد أربع سنوات من العمل الشاق ومسك المطرقة الثقيلة, لقد تهشّمت أصابعي ولم تعد قادرة على الرسم. بعد مدة وبينما كان الرسّام يمر بغرفة أخيه، كان بابها مفتوحا فشاهد أخاه يرفع يديه بالدعاء فرحاً بتخرّجه, لقد رأى يدي أخيه المضمومتين والمتعبتين في منظرٍ شدّه وألهمه وأثر فيه كثيرا, فهاتين اليدين المشققتين والمليئتين بالقروح والجروح هما من صنعتا منه فنانا, لذا قام برسم هذه اللوحة الفريدة تكريماً لأخيه الذي ضحى من أجله وسمى اللوحة باسم لوحة اليدين, لكن العالم أعاد تسميتها باسم اليدين المُصَلّيتين, هذه هي القصة يا سيدي.
تأثرتُ كثيراً بما سمعته من ذلك الشاب, وأدركتُ كم يُخفي قلمُ الرصاص خلفه وكم تستر ريشةُ الألوان تحتها رُكاماً من القصص الموجعة, قصصٌ تبقى آهاتها حيّة حتى بعد أن يطويها الموت الماحق, هي كالجمر المُكمم تحت الرماد الخجول, أو كالشاطىء الذي يتناوب المدّ والجزر على تغطية حبات رمله, شكرتُ الشاب وتمنيت له يوماً سعيداً, ثم أكملتُ رحلتي بين اللوحاتِ التي لم تعد تختلف عن بعضها أمام عينيّ, لقد تحوّلت الجبال والغيوم والحقول والبيوت والوجوه الى مجرّد يدين, وبعد قليل غادرتُ وصديقي المتحف والانبهارلا يفارقنا.
في طريق عودتنا بدأتُ أسردُ لصديقي ما سمعته عن تلك اللوحة الرائعة, كنت أعلك كلامي وأشترّه وأتردد بمضغه, وفجأة توقفتُ عن الحديث بفعلِ فراملي الروحية, وأطبق الهدوء علينا بلا استئذان, التفتَ صديقي نحوي يسألني عن سبب صمتي الغريب.
قلتُ له: لقد تذكرتُ أبي رحمه الله, لم يحتملني أنا وأخوتي أربع سنين فقط, لقد احتملنا عشرات السنين بصبرٍ ومحبة, كان قلبه وعقله يتضرّعان بالقرب من يديه في كل يوم, يفارق بيتنا قبل أن تصحو الشمس ويأتي بعد أن تفارقنا, لم ينتظر منّا امتناناً ولم يطلب مقابلاً, بقي يعمل ويعمل الى السنين المتقدمة من عمره بلا كللٍ أو ملل, لم يشتري لنفسه ثياباً جديدة ولم يُعارض ما نختاره من الطعام, كان يقتل رأيه بحبٍّ ليعيش رأينا بحرّية, كنّا نغرق بشرذمات طفولتنا وتفاصيل يومنا وترّهات شبابنا, وننسى أو تُنسينا الحياةُ من يُطعمنا ويسقينا ويحمينا, عند عودته لم يكن يطلب منا أن نوقف لعبنا أو نخفض صوتنا ليرتاح, وبيده الكادحة يحمل كيساً من البرتقال وكيساً من التفاح وكيساً من الجوافة, لم يضربني مهما كان خطأي ولم يعاتبني ولم يخدش دقيقة من عمري معه, كم أتمنى لو كنت رسّاماً, لكن حتى لو كنت كذلك فكيف سأرسمه في لوحةٍ واحدة, قد تستغرب أنني ما زلت أتذكر نظرته كأنها ماثلة أمامي الآن, وما زلت أشمّ رائحة قميصه وأرى ابتسامته عندما يراني, في إحدى المرّات كتبت مقالاً في إحدى الصحف وجلبتُ له نسخة من تلك الصحيفة, وفي اليوم التالي جئت لزيارته في الصباح الباكر, كان ما يزال نائماً بينما الصحيفة مطويّة ونائمة تحت مخدته البيضاء, اشتقتُ لك يا أبي…….