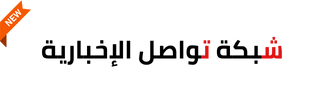د. جمال الحمصي: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ: في حوارات فقه السنن الربانية

د. جمال الحمصي
هل العلم التجريبي شرط كاف لتحقيق “الرخاء” في العالم العربي؟ ولماذا لم تتحقق ثماره الى الآن؟ هل المؤسسات المركزية والدعم الخارجي شرط كاف ل”البقاء والاستدامة” في العالم العربي؟ ولم الهشاشة المتزايدة اذن؟ وما الحلول؟ هذه هي بعض الأسئلة البحثية الهامة والواعدة في فقه السنن الربانية.
السنن الربانية هي نواميس الله للبشرية منذ عهد آدم حتى قيام الساعة. فهي هدية وهداية من نوع خاص، وهي في واقع الحال “النظام التشغيلي Operating System” الأحدث والأكمل للحياة البشرية الأقوم، كما ان العلم التجريبي هو الأساس في فهم آيات الكون وقوانينه السببية المادية (هامش 1).
ومن قبيل المدافعة المعرفية، يرمي هذا المقال الى تلخيص وتقييم، على مستوى عال، أبحاث فقه السنن الربانية -أو فقه الأسباب والتبعات- الواردة في مجلة “الفكر الإسلامي المعاصر” العدد (105) لسنة 2023، وهي للعلم مجلة عالمية مُحكّمة تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي مرتين في السنة.
وهنالك سببان رئيسيان لاختياري هذا العدد من المجلة دون غيره: الأول هو تخصيص العدد كاملا لموضوع واحد هو السنن الإلهية أو الربانية (أو الكونية). وهذا التخصيص Thematic Focus أعتبرها فكرة إيجابية تماماً بدلاً من مقالات متفرقة لا يجمع شتاتها جامع، خصوصاً إذا ما تولدت عن الأبحاث المنفردة قيمة مضافة جديدة، سواء في التنظير (توضيح المفاهيم أو تطوير المنهجية أو مسح ونقد الأدبيات السابقة) أو التنزيل (التطبيق العملي على حالة الأمة في مجال السياسات والاستراتيجيات نحو مستقبل أفضل).
والسبب الثاني لاختيار العدد هو أهمية موضوع السنن -أو الفقه الحضاري حسب تعبير مقدمة العدد – في خضم الأعاصير الوجودية والتنموية التي تعصف بالعالم العربي عموماً، سيما وأن موضوع فقه السنن أعتبره من اهتماماتي البحثية.
بل ان فقه السنن الربانية يتوافق مع علم أصول الفقه في كون كلاهما منتج معرفي أصيل وخاص بهذه الأمة، رغم ان العلم الأول ينتمي أساساً الى فقه الواقع او النواميس الوجودية لتطور الأمم ونظامها وأفولها، في حين التخصص الثاني الهام يؤصل لفقه القيّم (أي ما هي مناهج التوصل الى ما هو مرغوب من أوضاع الحياة البشرية؟).
ضمت المجلة 370 صفحة واحتوت ستة أبحاث أساسية غير مقدمة المحرر (أعدها المؤرخ المعروف عماد الدين خليل). كما ضمت المجلة في النهاية قراءة ومراجعة للسُّنن الإلهية في أبحاث مجلة “الفكر الإسلامي المعاصر”، وعروض مختصرة للعديد من الكتب ذات الصلة بالموضوع المركزي لعدد المجلة. وقد أعجبني البحث الأول والسابع من المجلة.
أما عناوين الأبحاث الستة المنشورة فهي تبدأ ب “حالة البحوث في السُّنَن الإلهية في بناء الأُمم والحضارات” و “سنَن قيام الأُمم”، مروراً ب “فقه السُّنَن الإلهية والثقافة السُّننية” و “الإنسان السُّنَني بين التفكير الحداثي وقيم الاستخلاف والعمران”، وانتهاء ب “خصائص السُّنَن الإلهية وأبعادها العلمية والحضارية” و “موقع التفكير السُّنَني في حركة الإصلاح الفكري المعاصر”.
وكما هو واضح من العناوين، تتسم الأبحاث بكونها عامة، بمعنى أنها لا تختص بتحليل عميق وأصيل لسنُّة/ سُنن محددة كسُنّة التغيير الاجتماعي أو سُنّة مسؤولية الإنسان أينما كان موقعه سواء في العام أو الخاص أو القطاع العائلي (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: الحديد 4)، وكذلك سُنّة “غثائية الأمة” وضرورة التوحّد بين بلدان العالم العربي في مجالات أساسية ذات أولوية وما هي أسس الوحدة المستدامة بعد فشل القومية لقرن من الزمان. كما لم تتعرض الابحاث لمجال محدد من السنن كالسنن التنموية (هامش 2) والسنن الاقتصادية والسياسية.
وأخيراً، تركز أبحاث المجلة قيد المراجعة على بناء الأمم وليس هشاشتها أو فشلها، علماً بأن بعض التفسيرات الضيقة والوجيهة للسُّنن كالسيوطي تحصرها (أو تعطي أولوية) للأسباب الجذرية لإخفاق الأمم وانهيارها.
ولذلك تخلو المجلة من اشارات للأدبيات الحديثة عن أخفاق الأمم وانهيارها، ومثال ذلك أدبيات وكتاب “لماذا تفشل الأمم Why Nations Fail ؟” (2012) من تأليف الأكاديميان عاصم أوغلو وروبنسون. وتحديداً، يرى المؤلفان ان غياب المؤسسات السياسية والاقتصادية التشاركية وهيمنة المؤسسات الاقصائية والاستغلالية وغير التشاركية هو السر في الاجابة على سؤال الكتاب الأساسي.
مفهوم السنن الربانية ونطاقها
يتباين تعريف السنن في أبحاث المجلة (ص15 و135 و231(، وهذا ربما أمر طبيعي رغم ضرورة محاولة تسوية الخلاف المفاهيمي بشأن التعريف أو كلماته المفتاحية، وذلك ضمن الرؤية السُننيّة للكون التي تستهدف المجلة العريقة بلورتها والمبادرة بصياغتها، حتى ولو من خلال مقدمة المحرر.
وكنت أود ان تضم ابحاث المجلة نقاش عميق حول العلاقة بين السُّنة والألفاظ المشابهة مثل: الآية والشريعة. فهل الآيات في القرآن الكريم هي ذاتها السنن؟ على الأغلب ليسوا سواء رغم الترابط. حتى ان الدراسة المسحية من المجلة (البحث الأول) تحيطنا علماً بالمقاربات الأربعة الممكنة للسنن، وهي: ارادة الله وحكمته ومشيئته، القانون الإلهي، المنهج والطريقة، المثال والنموذج والعادة، وليس من بينها الآيات الدالة.
رغم ذلك، فان هنالك ترابطاً. فالسنن الاجتماعية هي عموماً آية للخلق (مثال: هلاك فرعون ونجاة جثته (هامش 3)) وهي بخفاء تتبع “تجاهل” الآيات المحذرة، ولكن ليس كل آية طبيعية هي سُنّة أو قانون سببي/ حقيقة وجودية.
وبناء على سياق آيات ورد فيه مفهوم السنن صراحة في القرآن (وعددها 16)، ولأغراض تحديد نطاق فقه السنن وترابطاته مع فقه العمران وبناء الأمم، أرى حصر مفهوم السنن في المجال البشري أو المجتمعي، دون الطبيعي او المادي، رغم اعجاز النظام القرآني بين السنن الاجتماعية والسنن الكونية في العديد من الآيات. ويؤيدني في ذلك البحث الثالث من المجلة (فقه السُّنَن الإلهية والثقافة السُّننية).
السنن والقيم: أوامر الله التكوينية والتشريعية
بعض الدارسات أكدت على مفهوم الأمة كوحدة واعدة للتحليل في فقه السنن، وربطت بين مفهوم السنن وبين مفهوم رئيسي آخر هو القيم. هنا المقارنة بين أحكام الله الوجودية وأحكام الله التشريعية/ التكليفية. هذا الربط للأسف كان غير موفقاً بنظري، خصوصاً في إطار المساعي لتحويل فقه السنن الربانية الى علم واقعي غير توجيهي يعزز العلوم الاجتماعية المعاصرة في مجال اكتشاف القوانين الاجتماعية الكبرى.
أما أهمية القيم في بناء الأمم والعمران وتعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي فأمر جوهري وبدهي، لكن القيم العليا -كموضوع للبحث- هو ببساطة ليس ضمن نطاق فقه السنن التي تبحث في النواميس التقريرية لا المعيارية، والاستثناء الوحيد هو في اعتبار القيم متغيراً سببياً مستقلاً في سُنّة الهية محددة.
رؤية العالم والتفكير السنني: بعض الملاحظات الختامية
ان السنن الإلهية كما أكدنا هي “نظام التشغيل” للحياة البشرية المثلى، ودونها فان “التجربة والخطأ” والتيه الحضاري هو السيناريو الأكثر احتمالاً- بالطبع باستبعاد الغرور الطاغي!.
ورغم أهمية فلسفة السنن وارتباطها بالعقيدة الإسلامية، لكن هذا الكاتب يؤمن بأن فقه السنن يحوي فوائد عملية وتطبيقية للبشرية وللأمة العربية كذلك، وهو في تفاصيله علم عالمي ومُتحرّر من القيم كالفيزياء.
وهنا لابد البحث الرصين عن السنن والقوانين الناظمة للمجتمعات والدول ونهضتها، وتحديد نطاقها بدقة (هل وحدة التحليل هي الأمة أم المجتمع أم الدولة؟ أم المؤمنين؟ أم الحضارة أم البشرية؟) ومدى خضوع بعض هذه القوانين للتخصيص أو التقييد. وأيضاً التحديد الدقيق للعلاقة بين علم السنن الإلهية والعلوم الاجتماعية المعاصرة وفلسفتها، الى جانب البحث في منهجية تنزيل السنن الاجتماعية وتطبيقها بأفضل الطرق على الواقع العربي المعقد.
وجانب التطبيقات في الحوكمة والتشريع والتربية على العالم العربي والإسلامي هي نقطة ضعف أساسية، كما أكدت الدراسة الأولى من المجلة ذاتها، فهل نجحت أبحاث المجلة قيد المراجعة في تجاوز هذا المثلبة؟
الهوامش:
هامش (1): يذكر العلّامة د. محمد الغزالي في كتابه “المحاور الخمسة للقرآن الكريم” محاور خمسة رئيسية للقرآن الكريم وهي محاور: (1) الله الواحد القهار و(2) الكون الدال على خالقه، و(3) الأمم السابقة وسننها، و(4) البعث والجزاء، و(5) التربية والتشريع. هذا المقال يدخل في محور السنن القرآنية.
هامش (2): جمال الحمصي (2019) علم القرآن التنموي: أعظم عشرة قوانين حاكمة لنهضة المجتمعات والدول. جمعية المحافظة على القرآن الكريم. عمان: الاردن.
هامش (3(: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً (يونس: 92).