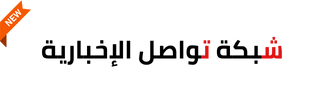يا لها من حماية.. وكم تبدو إسرائيل حريصة على الأقليات!

د. لينا الطبال
القصر الرئاسي في دمشق لا يقصف عادة، لم يكن المستهدف اسقاط النظام: حماية “الأقلية الدرزية”.
نعم، إسرائيل تحميهم… ودولة تدعي الحماية تقتلهم. اسرائيل حامية الإنسانية والحقوق هرعت على اجنحة الـ إف–16 واطلقت صاروخين. الضربات جاءت على مشارف القصر. لم تصب الرئيس، ولا صورة الرئيس في الاطار الذهبي، ولا القلم الذي يوقع به أوامر ارسال الجيش ليقتل ويطهر. توقفت الصواريخ بأدب عند البوابة… يقال انها احترمت البروتوكول، لم تصب السيادة السورية، فالسيادة بحاجة لوجود كي تصاب. لكنها أصابت شيء آخر، شيء نعرفه جيدا: أصابتنا. نحن الذين نبتلع القذائف، ونُقتل نيابة عن الجميع.
في بيان متعب كتبته يد تعاني من فقر الدم، اعلنت الرئاسة السورية ان القصف “تصعيد خطير من قبل الاحتلال يهدد وحدة الشعب”… أي شعب؟ شعبك الذي تقتله في الطرقات وفي البيوت؟ او شعبك الذي يهجر على الهوية، او شعبك التي تساق نساؤه من العلويات الى أسواق النخاسة؟ الضحايا كثر يا سيادة الرئيس. لا حاجة لإحصائهم، فكل من حولك يعدهم.
الدروز… أولا يُقتلون لمجرد التمرين على فن القتل. ثم يقتلون مرة ثانية لأنهم وثقوا بمن وعدهم بالحماية. ثم يحرقون، ويدفنون، ويبكون بلا دموع. خمس مرات يُقتلون، وكل مرة بصيغة اكثر لياقة من التي قبلها.
كلما اشتعلت حرب وجد الدروز أنفسهم في صفوفها الأولى. من حطين إلى الثورة السورية الكبرى… واجهوا الصليبيين والمغول والعثمانيين والفرنسيين. لكل زعيم منهم قصة، ولكل جيل حلمه المذبوح. لكنهم في كل مرة عادوا بأكاليل المجد. 700 ألف درزي سوري، موزعون بين السويداء والجولان وأطراف دمشق، يعيشون على ذاكرة ثقيلة من البطولات، وواقع مليء بالخسارات.
في زحمة الضجيج السياسي والمذابح اليومية، وفي مكان ما، يظهر وجه نتنياهو كالشبح، نصفه ضاحك، غير مكترث بكل الدماء “لن نسمح بتهديد الطائفة الدرزية”، قال. ومتى تحمي إسرائيل انسان واحد دون ان يكون لها منفعة؟ إلا إذا كان جزء من ورقة ضغط أو سلعة أمنية؟ رغم ذلك لا يهم، فالدروز اليوم كالعملة الصعبة، كل الأطراف يريدونهم في محفظتهم.
تتسلل إسرائيل بخطوات هادئة، وتراقب كافة التفاصيل… إسرائيل مختصة بمراقبة التفاصيل. تتسلل بذكاء، مستغلة التمزق الداخلي للمجتمعات، معركتها داخل العقول. وتخصصها تفكيك ما تبقى من مفهوم اسمه “الوحدة”. وأفضل أدواتها هي الأقليات التي جرى رميها فجأة في قلب المعركة… نعم، تلك الأقليات التي كانت في كثير من الأحيان في قلب تصدعات المجتمع، اصبح اليوم لها دور أكبر في الحسابات الاستراتيجية. أليس هذا هو الوجه الحقيقي للصراع؟ اسرائيل تتقن شيء واحد: أن تمسك بطائفة ضائعة، وتهمس لها: “أنا احميك”.
مشايخ الطائفة الدرزية احتجوا. اجتمعوا وأصدروا بيان مزين بمصطلحات مثل “الوحدة الوطنية”، و”رفض الانفصال”، و”التمسك بالوطن”. بيان أبيض بالامكان تلاوته كصلاة، أو قراءته كوصية قبل الإعدام. والطائفة ما زالت تردد: “نحن جزء لا يتجزأ من الوطن السوري. جميلة هذه العبارة تذكرنا انه كان لنا وطن.
يا ترى ما الذي يدور في رأس وليد جنبلاط؟ تشكيل لجنة للتحقيق؟ لا نحتاج الى لجان جديدة. ثم قال “لن نطلب الحماية الدولية، فالسلاح يجب أن يبقى في يد الدولة”! هل يحسب “البيك” انه الوحيد الذي يعرف أن إسرائيل في المنطقة تعمل على استغلال الأوضاع لتحقيق مصالحها؟ موقف جنبلاط هو فقاعة سياسية طرحها لإسكات جمهور خائف، من زعيم لا يريد خوض معركة يعرف تماما ان اول من سيدفع ثمنها… هو.
في السويداء، يبتسم الموت للجميع هذا المساء. وفي جرمانا وأشرفية صحنايا، هناك أشياء أخرى تحدث، أشياء تشبه الموت في كل تفصيل: أصوات متقطعة، طلقات نارية، رعب يلتهم الوجوه، وشوارب لشبان تحلق، ورؤوس قد يجري فصلها عن الاجساد. وأسرى، دمهم يُستباح في صمت، كأنها قصة تروى دون نهاية، في بلد ليس بالبعيد عنا، هناك، في هذا الوطن الذي لم نعد نقيم به بل يقيم بنا، يحدث كل هذا.
الأمم المتحدة أدانت، كالعادة: لاجديد. غوتيريش يُند: لا جديد أيضا. المجتمع الدولي قلق: لا جديد أيضا وأيضا. كأن القلق والادانة والتنديد سيحيون الشهداء وسيعيدون المهجرين، أو سيزيلون هذه الأنقاض عن الرؤوس.
في جرمانا، تم الاتفاق على تسليم السلاح. نعم، هكذا ببساطة… لكن لا أحد يسلم سلاحه طوعا، إلا إذا فقد الأمل أو العقل أو كليهما. في جرمانا، انتهى الأمر، كما تنتهي الأمور دائما عندنا: بلا معنى. صدر تصريح رسمي مترهل أن “الحياة عادت إلى طبيعتها”. والناس كأنهم سمعوا نكتة حزينة جدا، ابتسموا في صمت.
لا أحد يعلم ما هذه الطبيعة، لكن لا أحد يعترض، لأن الاعتراض يعني السؤال، والسؤال جريمة… ولكي تبدو الأمور طبيعية أكثر مما ينبغي، بدأ المسلحون يرقصون، نعم، يرقصون. الجنود الذين لا يتحدثون العربية إلا بمقدار ما يكفي لفهم “اقتل” و”اذبح”، ينشدون بلهجة ركيكة أغنية عبد الباسط الساروت: “الله أكبر يا وطن”. وطن اخترعوه لهم وحدهم.
في ظل الهزائم وفوضى الحكم في دمشق، ماذا يبقى للدرزي السوري من خيارات؟ يُترك وحده أمام سؤال لا يحب أحد طرحه: إن اختار إسرائيل هل هو خائن؟ وإن انتظر دمشق، فقد ينتظر حتما نهايته. هكذا يُحشر الدروز في الزاوية… هم لم يغيروا مبادئهم، الخريطة هي التي تغيرت تحت أقدامهم، والاحتلال صار أقل رعبا من الحليف، وأقرب اليهم من الوطن.
وفي هذا الارتباك، تنبعث الأصوات التي كانت ترفض التطبيع، لتعيد تقديمه كخطة مرحلية وتطالب بتطبيع تدريجي تحت شعار “حماية الأقليات”.
ما تقوم به إسرائيل لا يشبه التحالفات، انها عملية تفكك ببطيء لهويات مكسورة. هي تراقب وتخطط، وتستغل الانقسامات بين الطوائف والمعتقدات…. وعندما يأتي حل السياسة بالدم، كل طرف يصبح قابل للشراء أو للاستغلال. وفي تلك اللحظة بالذات تبحث إسرائيل عن فرصتها وتنقض وتُنهي.
العلويون في سوريا، كما باقي الأقليات عالقون في ممر ضيق من الخيارات الصعبة. وكل يوم ترتكب مجزرة جديدة بحقهم. هل يمكن أن تظل إسرائيل بعيدة عن هذه الفوضى؟ بالطبع لا. فهي تدرك أن تفكيك سوريا إلى كيانات طائفية صغيرة هو السبيل الأفضل لبناء منطقة تحت سيطرتها بشكل غير مباشر. هل سيقع العلويون في هذا الفخ؟ لا نعلم.
على الساحل السوري، إسرائيل لا تشارك في القتال، لكنها تراقب ايضا عن قرب… الجرائم التي تحدث بحق النساء العلويات وكل اعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق الطائفة لا تثير الاستنكار الدولي الكافي، لأن المأساة هنا هي جزء من استراتيجية تهدف إلى استثمار هذه المعاناة في تحقيق مكاسب سياسية.
نعم، في الساحل السوري، المجزرة مستمرة، والدعوى التي أقامها التجمع الفرنسي-العلوي في باريس ضد أحمد الشرع بتهمة الإبادة والتطهير العرقي مستمرة أيضا… شيء ما يشبه الأمل.
ربما تكون هذه المحاكمة مجرد إضاءة صغيرة في نفق بلا نهاية، أو وهم قانوني جديد يوهمنا أن ثمة عدالة في عالم خلق لنا. في كتابه “الحياة أمامك”، كتب رومان غاري: “أحيانا، حتى العدل يمارس متأخرا لدرجة أن يصبح هو الآخر شكلا من أشكال الظلم”… لكن اعلم جيدا انه وفي كل مرة يغلق باب محكمة، تضحك تل أبيب بهدوء.
ربما لم يبق هناك وطن ندافع عنه. فقط ذكريات، وجثث، وأقليات محاصرة في الزوايا تتساءل كل منها: من التالي؟
فما الذي نفعله إذا؟ نحصي الموتى، نشاهد اللاجئين ونبكي على كل شيء يختفي او يرحل، او ننتظر تقارير منظمات حقوق الإنسان، نكتب. نعم، نكتب. لأننا لا نملك غير الكلمات. وكأننا حين نكتب، نؤجل النهاية فقط. الحقيقة أن النهاية وقعت منذ زمن، ولا يوجد لدينا ما يكفي من الدموع لمتابعة البكاء.
دم العلويون والدروز والمسيحيون وكافة الأقليات لم يجف، وأصواتهم المرتعشة ستطرق باب المحكمة، كضحايا وكشهود على جريمة ترتكب ضد الوطن نفسه. ومع كل شهادة تضاف، سنتزع القاتل من وهم نجاته.
قد تطول الرحلة، وقد يهدم ما تبقى من القرى وتبدد الذاكرة، لكن العدالة ليست وهم او ترف، او خيال ادبي. إنها بطء زاحف لا يرحم، كابوس يلاحق القاتل ولا يسامح.
لن تمر هذه الجرائم كما مرت التي قبلها، ولن يمحى اسم أحمد الشرع من سجلات الدم، ولو بعد عقود. لأن لا مرور للزمن على جرائم ضد الإنسانية. ولا مهرب من العدالة، حتى لو تأخرت…
وتسالني هل ما زال هناك مجال لزهرة أمل وسط هذه العتمة التي لا تنتهي؟
طبعا…
ولا بد ان ينجو أحد ليزرعها.
أستاذة جامعية، باحثة في العلاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان – باريس