علي لفتة سعيد: تفكيك بنية السؤال في»ظلالٌ مضاعفةٌ بالعناقات»: مقاربة تأويلية
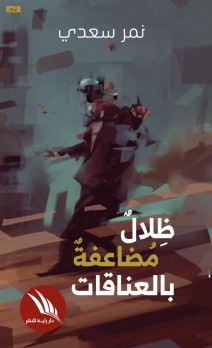
علي لفتة سعيد
تتخذ المجموعة الشعرية «ظلالٌ مضاعفةٌ بالعناقات» للفلسطيني نمر سعدي من السؤال مبنى شعريّا لها، ليكون السؤال دالا مزاحا عن الأصل / المكان والتعويض/ الكينونة لينطلق به للبحث عن إجابةٍ غير مباشرة ترابط بالبيئة والجذور والبحث عن العلاقة بين الظاهر والمخفي من الروح الفلسطينية والدال الشعري المبثوث بين النصوص، لتكون الفاعلية الاشتغالية قائمة على أساس البحث عن تحليل فلسفيٍّ قابلٍ للإشارة إلى المحتوى العام. فالعنوان يدخل في روحه السؤال، وفي داخل تكوينه البحث عن الإجابات. وهو عنوان يحمل رمزية أكثر مما هو واقعي، وفيه واقعية تتميّز بالإزاحة القصدية، التي تعطي للصوفية معنى مقاربا بالدلالة.
فإذا ما أخذنا الواقع الذي يعيشه المنتج/ الشاعر، وهي معرفة دلالية وإشارية من كونه فلسطينيّا، فإن اتجاه القراءة سيكون نحو السؤال المخفي، سواء كان فلسفيّا أو صوفيّا أو واقعيّا، وصولا إلى المعرفة التكوينية. ويجمع هذه الفعاليات الإهداء الذي يأتي مرتبطا بالعامل النفسي والمكاني، (إلى كلِّ من أحبَّني وأحببت)، فهو واقعيٌّ روحيٌّ، واستغاثةٌ محمَّلةٌ بسؤال، )من هم؟ الذين يقصدهم). ليتبعها الاقتباس الذي جعله مدخلا للمجموعة كلها، وهو مأخوذ من قصيدة لبدر شاكر السياب، لها اتصال مباشر بالمعنى المكاني والاتجاه التكويني، وهو ما يعني استثمارها في الاشتغال الشعري:
«هديرُ البحر يَفْتِلُ من دمائي، من شراييني
حبالَ سفينةٍ بيضاءَ يَنْعُسُ فوقها القمرُ
ويُرَعْشُ ظلَّها السَّحرُ
ومن شُبَّاكيَ المفتوحِ تهمس بي وتأتيني
سماءُ الصيفِ خلَّفَ طيفَه في صحوها المطرُ»
الاشتغال وفاعلية السؤال
يعتمد المنتج في اشتغاله على توزيع النصوص على فصول ذات أرقام رومانية (I… II… V) في إشارة إلى صنع النصوص، فهو يريد أن يثبت الوحدة العضوية للنصوص، فضلا عن اختلافها من الناحية الشكلية كذلك. فبعضها جاء على شكل فصول مرقمة، وبعضها حمل عناوين بلا أرقام، وبعضها جمع بين الاثنين معا، بينما مزج نصا واحدا بين الشعر النثري والنص السردي.
يمكن تفسير هذا الأسلوب بأن الشاعر أراد اللعب بأكثر من صيغة، ولكل صيغة منها رسالة تأويلية في الشكل، لكن القصد في المعنى الداخلي ظل تابعا للنص ذاته، الذي تحركه الفاعلية الاشتغالية للفكرة التي يتبناها النص. فهو يشتغل على عدة اتجاهات:
أولها: الممازجة بين الرمزية والواقعية، حيث تنقسم الرمزية إلى رمزية واقعية ورمزية خيالية. يبدأ المنتج بتعزيز الصدارة لفهم النص، سواء من خلال العنوان أو الترقيم، الذي يعني توزيع الفكرة على المقاطع المرقمة. وفي كلتا الحالتين، يعود إلى السؤال الفلسفي، سواء افتتح به النص أو جاء في متنه، إذ يسعى إلى اختبار المتلقي لمعرفة مدى تأصله في الواقع، سواء كان هذا الواقع رمزيا أم خياليا:
(1)»
«من أينَ تبدأُ وحدةُ الشعراءِ؟
من أيِّ الجهاتِ تهبُّ؟
من أيِّ البحارِ تجيءُ؟
من أيِّ السماواتِ البعيدةِ فجأة تأتي؟»
(من نص يحمل عنوان المجموعة: ظلالٌ مضاعفةٌ بالعناقات I)
ثانيها: مهارة الإيقاع الداخلي، التي تتجلى من خلال تكرار المفردات داخل النص، أو عبر الفعل الموسيقي للكلمة، حيث ترتبط المفردة بمسلك التنامي الحدثي تصاعديا. فالإيقاع يكمن بين الكلمات، ما يمنح النص مرونة في التلقي ويقرب وجهة النظر إلى القارئ:
«كلُّ الدروبِ التي في القلوبِ ستفضي إليكِ
وكلُّ القصائدِ.. كلُّ النجومِ التي من ندى العشبِ
كلُّ الغيومِ التي من صدى الحبِّ
نبضُ النهاراتِ.. ومضُ الليالي
سماءُ البنفسجِ، أو عبقُ التوتِ»
)من نص: منمنماتُ عاشقٍ على ضفائرِ امرأةٍ مقدسيَّة (III
ثالثها: الاشتغال على وقوع التناص داخل النص، ليس باعتباره اقتباسا، بل بوصفه امتدادا لعمق فلسفي مرتبط بالسؤال ذاته. فالمنتج يبحث عن استقرار داخلي يقيه مصاعب الحياة، فيلجأ إلى الحب أو إلى المقولات التي تمنحه قدرا من الاطمئنان الذاتي:
«نسيتُ نبضي كلَّهُ في برعمِ الرمَّانِ في آبَ، نسيتُ جسدي المحمومَ في احتراقِ عطرِ الهالْ
ضفائرُ الشمسِ سياطٌ ألهبتْ ظهري، فهل لطائرِ الفينيقِ أن يدلَّني عليَّ؟
هل لوترِ الجيتارِ أن يضيءَ لي الطريقَ؟
هل للقمرِ الأزرقِ في أشعارِ نيرودا أن يهمسَ لي: تعالْ؟
يهتاجُ في خاصرتي سربُ طيورٍ فظَّةٍ
وفي دمي يندلعُ البنفسجُ البحريُّ»
)من نص: كأنني نهرٌ من الرياح، وهو مُهدى إلى الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي).
رابعها: الاشتغال على الحنين، وهو من العوامل النفسية الداخلية التي تعكسها الحالة الزمكانية، مُدلِّلة على وقوع النص في منهجية الحنين، تفاديا للوصول إلى مرحلة التيه التي قد تعصف بكل شيء أمام هول الأحداث. لذا، يتصل الحنين بالسؤال الفلسفي كذلك، وهو حنينٌ يعوّض عن الأرض بالمرأة في أغلب نصوص المجموعة:
«بوردةِ الماءِ أو عطرِ المراجيحِ
ولا أحبُّ نساء فيكِ.. تغمرني
ثلوجهنَّ، سخيَّاتٍ بتلويحِ
كلُّ الأغاني التي ضاعتْ وأجملها
تمرُّ من وترٍ في القلبِ مجروحِ»
(من نص «شدِّي جراحي بجرحِ الماءِ)
خامسها: الاشتغال على القلق الوجودي والمفارقات، وما تمنحه الجملة الشعرية من أجواء متبادلة بين رمزية المرأة كوحدة دلالية والقلق على المكان ومنه، فيصبح التعويض شعريّا:
نوفمبرُ القلقُ الروحيُّ، مزولةُ الأضواءِ، نهرُ عصافيرِ الظهيرةِ، ليمونُ الحنينِ ونعناعُ الحبيبةِ..
من خفقٍ على بابِ قلبي كانَ يولدُ.. من أصابعِ امرأةِ الحنَّاءِ والقمحِ والزيتونِ والتينِ»
(من نص «نوفمبرُ امرأةِ الحنَّاء)
سادسها: الاشتغال على المكان كتعويض دلالي يناصف الحالة النفسية والحاجة الرمزية، عبر تبادل الأدوار بينهما. وهو ما يبرز عملية البحث عن الذات من خلال التفاعل بين الواقع المعيش والرمزية الواقعية أو المستمدة منه:
هل شفةٌ تشبُّ فيها فراشاتٌ / قصائدُ / أقمارٌ من الكحلِ في عينيْ فلسطينِ
في القلبِ حقلُ صدى.. في الروحِ أغنيةٌ
خضراءُ خضراءُ من لفحِ الحياةِ ومن عطرِ الترابِ وأصداءِ البساتينِ»
يا بنتَ صرخةِ قلبي فيكِ من شغفي
(من نص نوفمبرُ امرأةِ الحنَّاء(
ثامنها: الاشتغال على الصورة الشعرية التي تحمل دلالة المجاز الصوري النابع من الذات، إذ تتحول المفردة بجملتها الشعرية إلى ما يشبه الصورة، من أجل استنطاقها ومدّها بمدلولها الشعري:
واحدةٌ تراودهُ وأخرى للحنينِ المرِّ تفضي
ضجرُ الحياةِ يطلُّ مثلَ زنابقِ الدربِ المغطَّى بالنجيلِ
وفي شقوقِ نوافذ الزمن الذليلِ أراهُ يمضي»
أنا مفرطٌ في كلِّ شيءٍ..
)من نص لم أنتظر أحدا(
تاسعها: الاشتغال على المخالفة في تنضيد النص النثري، عبر الموسيقى الداخلية والمثاقفة الشعرية، باستخدام الخزين الدلالي لاستحداث نص شعري ذي قابلية على المماطلة الفكرية، كما يمتلك إمكانية الثبات، مانحا مجالا للتأويل المتعدد:
لو كنتِ زنبقة أعيشُ هناك في أقصى غوايتها، شمالَ جمالها، وعلى مسافةِ قبلةٍ أو لمسةٍ منها ومن أعلى مرامي ليلِ حيفا الياسمينةِ والهواءِ.. لكنتُ ماءكِ واخضرارَ عبيرِ ناركِ في الجبالِ وكنتِ لي حوريَّة في القلبِ، أوَّلَ شهوةِ البرقوقِ، أو وحمَ السنابلِ في حزيرانَ، القصيدةَ والصدى، ولكنتُ أبحثُ عنكِ في صوتي وفي صمتِ الفراشاتِ العطاشِ وكنتُ منكِ أصبتُ وحدي بالرمادِ وكيمياءِ الحبِّ.. «
)من نص هل تأتي القصيدةُ في الشتاء VI)
الدلالة والانزياح
إنّ المجموعة تتخذ هذه المسارات الاشتغالية لتعبّر عن مكنونها من خلال تفاعل المكونات الأساسية للنص الواحد، ليجعل من سطوته الشعرية مقاومة للتفاعل الذاتي، مثلما يجعلها عبر السؤال الفلسفي وكأنه بديل عن الرمز المباشر الواضح. لذا كانت الجمالية عالية، لا تخضع للعاطفة باعتبار ذاتية الشعر والانتمائية، ولا تخضع للسائد المباشر. فاعتمدت على التعويض الدلالي بحضور الحب، كونه الغائب الوحيد في هذه الحياة.
لذا، فالمجموعة بنصوصها المتنوعة الاشتغال والتبويب والشكل، تحمل صوتها الدال على المكنون الوجودي، دون وضع أساس للمراثي والتيه والبكاء والأحلام المختفية خلف صعوبات المكان الذي انبثقت منه النصوص. وهي مجموعة استخدمت اللغة الشعرية والشاعرية معا، فكانت تنساب بعمقها الدلالي والموسيقي معا.
لذا فإنّ المحتوى العام كان التأمل بدلا من الغوص في ثنايا منابع المشكلة ومصبها، عبر فاعلية الزمن والانتظار معا. لذا كانت الفراغات بين النص الواحد والنصوص الأخرى فراغات متأملة لها فاعلية التأويل وفاعلية القصد اللتين تنتجان الفاعلية الفلسفية عبر استثمار الهوية الخاصة بالمنتج/ الشاعر. فهو يذهب إلى التناص مرة، وإلى التاريخ مرة أخرى، وإلى الحب وإن كان ضائعا أو مختفيا خلف المرآة التي تغلف الواقع كله، لينتج فاعلية اتصالية بين الإنسان ومكانه، وبين الذات وجوانيّاتها المضطربة والمتصارعة والمتصالحة أيضا في الوقت نفسه، بعد انعكاس تلك الانكسارات المخفية داخل بنية النصوص لتحويلها إلى حنين وحب.
شاعر وناقد من العراق
