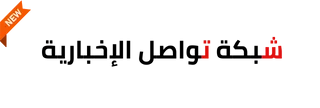د. طريق لمقدمي: المغرب: أفلا يخجلون..

د. طريق لمقدمي
في سياق تأملنا المستمر للواقع الاجتماعي المغربي، ومحاولة النفاذ إلى غياهب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تجثم على صدور المقهورين والبؤساء: غلاء المعيشة، الإقصاء من الوظيفة، ازدياد جيش المعطلين، بنود التخريب الجامعي، القرارات المرتجلة، استفحال ظاهرة الصحافة والنقابات المرتزقة. يظهر بالملموس، أن هذا الوضع المبكي المضحك في ذات الآن، ليس نتاج علة خارجية أو فوقية غير مرئية، وإنما بفعل البرجوازية المزدوجة الجنسية (مغربية- فرنسية) المتربعة على دوائر صناعة القرار السياسي، الاقتصادي والأكاديمي والديني أيضا، بحيث بات كل شيء قابل للبيع والشراء، وهو منطق الرأسمال بامتياز. إذ بفضل سلطتها الناعمة تارة، والصلبة أو القمعية في غالب الأحيان، صارت تتملك وتتحكم ليس في وسائل الإنتاج فحسب، وإنما حتى في مصائر الشعب المغربي وآمالهم. تحديدا، الطبقة المعطلة والمفقرة والمجهلة. حتى خيل إلينا أو يكاد البعض أن يسلم، بأن أمهاتنا لم ينجبن طاقات فكرية وكفاءات علمية، بمقدورها الانخراط في إنتاج السياسات العمومية وتدبير الشأن الثقافي والاقتصادي والإسهام بالتالي، في التقدم الحضاري. وفي سياق هذا، تجد المقربين من “القطط السمينة” وأبناء بعض المناطق “المتعالية” يشغلون أكثر من وظيفة في الإدارة العمومية وعلى رأسها الجامعة. إضافة، إلى مسألة خطيرة سوف أسلط الضوء عليها (إذا اضطررنا) بالدليل الملموس، ألا وهي “الموظف الشبح”؛ إذ يوجد العديد وما خفي أعظم كما يقولون من الذين يتقاضون رواتب وفي غالب الأحيان تكون مرتفعة، وهم في الأصل غير حاضرين موضوعيا بل ورقيا أو قل للدقة، إداريا وبالتوقيع فقط. وهو فعل يدين مبتكره جنائيا. هذا إذا أجلنا النقاش حول التلاعب بجغرافيات مؤسسات الدولة من خلال تفويتها إلى شركات متعددة الجنسيات بذريعة صفقات رسمية تصب في نطاق المصلحة العامة، لكنها في الحقيقة، تخدم البرجوازية الصاعدة الحاملة لشعار: “المال والسيارات خير من الجامعات والمؤسسات”.
لقد تعمدنا طرح هذه الأرضية، لكون الفاعلين أو اللاعبين الأساسيين في لعبة الفساد مرتبطين أشد الارتباط بمحترفي السياسة المشوهة، لكونهم مظلات حماية لهم. فقبل الحديث عن احترافيتهم الهابطة في التواصل مع المغاربة، دعونا نستحضر أمجاد المغاربة الشرفاء الأحرار، الذين رفضوا الاستعمار والاستحمار والظلم والقهر والعار، وقدموا أرواحهم فداء لوطنهم الغالي. وبرزت وقتذاك، قيادات سياسية وطنية من شتى الأحزاب السياسية وفي مقدمتهم، الحسن الوزاني، عبد الخالق الطريس، علال الفاسي، بلافريج وغيرهم كثير، تمكنوا من قيادة الشعب المغربي نحو النصر والظفر بالاستقلال السياسي مبدئيا، فكانت كل خطاباتهم، تحمل شكلا ومضمونا، كلمات تفوح منها رائحة البسالة والشهامة وتقدير المواطن المغربي واحترام رأيه ولو كان مختلفا أو ذو توجه إديولوجي ما. إذ القاعدة الأساس وفق تصورهم السليم، هي احترام المغاربة أولا وأخيرا، وهذه الممارسة السياسية الأخلاقية هي من حققت الإجماع والتلاحم وبالنتيجة، الاستقلال والحرية والكرامة للمغاربة.
يضعنا هذا الاستطراد التاريخي، الذي كان لا بد من استحضاره، أمام واقع الأحزاب السياسية المغربية المتصدرة للمشهد الإعلامي والمتأخرة على مستويات عدة، بحيث ينطرح السؤال التالي: كيف تخاطب قيادات هذه الأحزاب المغاربة الأحرار، خاصة ونحن في زمن ليس فيه الاستعمار موضوعيا، فكيف لو صار واقعيا؟
في البداية، لا مندوحة من القول بأن كل ما سيأتي ذكره هو نتاج التسابق والتنافس ليس من أجل التصنيع والابتكار وطرد الاستعمار، ولكن بغاية الظفر بالسلطة أو قل من أجل التسلط على الضعفاء والمحتاجين وقهر واستضباع المثقفين في عملية مرحلية تسمى “الانتخابات الديمقراطية”.
في البدء، كانت “إعادة التربية” لبعض المغاربة على لسان قيادة “حزب الأحرار”. وذلك ما كان، وفق المنطق البرجوازي من خلال الزيادة الصاروخية أولا، في المحروقات، التي تحتكر سوقها. وثانيا، في كل المواد الاستهلاكية الضرورية وغير الضرورية، ولم تسلم حتى حلويات وعلكة الأطفال البؤساء من هذه الزيادة، التي تندرج حسب منطق عقل البرجوازية في نطاق “إعادة الترابي”. بعد ذلك، فاجأتنا بل صدمتنا قيادة حزب “الأصالة والمعاصرة” عندما نعتت بعض المغاربة في سياق قولها: “القافلة تسير والكلاب تنبح”. ومؤكد، أن زعيمنا يعرف تمام المعرفة من هم هؤلاء الكلاب الذين يخاطبهم. وأخيرا وليس أخرا، خرج زعيم حزب “العدالة والتنمية” يوم فاتح ماي بثياب الواعظين فراح يهدي ويمدح بعض الناس ويسب الآخرين، بل نعتهم بالميكروبات والحمير. ووصفه هذا، جاء في سياق مقولة “تازة قبل غزة”. واعتبرنا أننا لم نقرأ التاريخ. ويبدو، أن الحاج الزعيم، هو الذي لم يقرأ تاريخ تازة ولا حتى غزة، فلو كان يعلمه لما ارتجل بتلك الكلمة. فأهل تازة، متشبثون بالمسألة الفلسطينية لكونها قضية وطنية وأم القضايا أكثر من الذين شرعنوا التطبيع عبر التوقيع. فسكان تازة رجال صناديد أشداء على الخونة وأرباع السياسيين والانتهازيين باعتراف المقيم العام ليوطي نفسه. لقد كان التازيون أشد بأسا وشراسة في مقاومة الدبابة الفرنسية، بحيث لم يتمكن الاستعمار من سيطرته على المدينة حتى سنة 1914 بعد مدينة الحاج الواعظ بسنتين. وفي مقابل هذه الكلمات النابية، والخطابات الممتلئة بالحقد والضغينة والانتقام السياسي، نجد أن الخطاب الرسمي لأعلى سلطة تنفيذية في البلاد، يتضمن الاحترام والتقدير والامتنان سواء للمغاربة أو لأطر الدولة. فكيف نفسر هذا التناقض ما بين الرئيس والمرؤوس؟ سؤال نجد جوابه على ما يبدو، في القول الآتي: “إذا لم تستحي فاصنع ما شئت”.
إن الغرض من هذه المقارنة، بين أخلاقيات الأحزاب السياسية السابقة والآنية، وكذا استحضار بعض تمظهرات الاختلاس والفساد المالي والإداري، هو في الحقيقة، محاولة لتنبيه صانع القرار المغربي من النرجسية المفرطة والجهل المقدس اللذان ينخران أفهام من يعتبرون أنفسهم ممثلي الشعب. وأيضا، تحذير الذين يعتقدون خطأ، أن ترسانتنا خاوية، ولا تشكل أي قلق على مجرى نفاقهم وفسادهم. وهذا ما سيعلمونه ربما بعد فوات الأوان.
إن فساد القرار من فساد الأفكار، وفساد الأفكار بالضرورة تجعل الأفراد ينسلخون عن هويتهم الإنسانية إما وعيا منهم، أو عن غير وعي؛ بحيث يقومون بأفعال وممارسات غير منطقية ولا تتماشى وطبيعة الإنسان العقلية وحتى البيولوجية. مما يفضي بالنتيجة، إلى تشكل فكر برغماتي أو مصلحي لا يهمه سوى المال والثمل. والأخطر ما في الأمر، هو تصورنا للواقع الاجتماعي المستقبلي، إذا ما استمر هؤلاء على رأس دوائر صناعة القرار، فكيف يكون إذ ذاك واقع الحال؟
المغرب/ *تازة*