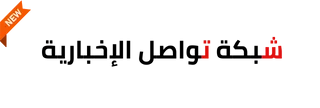د. سيداتي أحمد الهيبة ماءالعينين: القضية الفلسطينية بين الصمت رسمي.. وخفوت الدور الشعبي

د. سيداتي أحمد الهيبة ماءالعينين
إن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي أو صراع سياسي إنما هي اختبار أخلاقي للعرب وللعالم بأسره. فمنذ فجر القضية الفلسطينية، كانت فلسطين رمزًا للوحدة العربية، وعنوانًا للعدالة التي ينتظر تحقيقها كل من آمن بالحرية والكرامة الإنسانية. وقد حملت هذه الأرض هموم العرب وآمالهم، وكتب عنها الأدباء والشعراء كجزء من وجدانهم وأضحت مقياسًا للضمير الجماعي.
ولكن، ومع مرور السنوات، تغيّر المشهد وتبدّلت المواقف.. فمن العجز الجلي للأنظمة العربية، التي تركت القضية خلف ظهورها، إلى العجز التام للشعوب التي باتت صامتة، نشهد اليوم موقفًا مخزيًا يفوق في قسوته ظلم الاحتلال ذاته. في المقابل، يُظهر لنا الغرب، الذي لطالما اتُّهم بالتحيز لإسرائيل، حركات متضامنة مع فلسطين تدافع عنها بحماس، متفوقة في إنسانيتها على من هم أصحاب القضية أنفسهم. فالسلبية المطلقة لا يمكن أن تكون مبررًا، إذ علّمنا التاريخ أن الشعوب، متى اجتمعت إرادتها وتوحد صوتها، كانت قادرة على صنع التغيير. وإن تعذّر النضال السياسي المباشر في ظل الظروف الراهنة، فإن أقل ما يمكن فعله، وأضعف الإيمان، هو المقاطعة
إن اتفاقيات السلام المزعوم، التي أبرمتها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، كانت خصمًا من القضية الفلسطينية؛ فقد منحت إسرائيل شرعية احتلالها للأراضي الفلسطينية مقابل وعود واهية بالسلام والاستقرار، وكأننا أمام رجل ضحى بميراثه الثمين من أجل حفنة من السراب!. هذه الاتفاقيات لم تكن فقط تخلّيًا عن الفلسطينيين الذين يعانون من القمع اليومي، بل كانت أيضًا إقرارًا ضمنيًا بقبول الأمر الواقع، والمساهمة في تعزيز الاحتلال.
إنّ تطبيع بعض الأنظمة مع إسرائيل هو أكبر شهادة على هذا التواطؤ، كمن يبيع بيت جاره للمعتدي؛ بحجة بناء “جسور السلام”، بينما الحقيقة هي أن هذه الجسور مبنية من الأنقاض والدماء؛ فالسلام الحقيقي لا يأتي بالتطبيع مع الظلم، بل بمقاومته والتصدي له.. ولكن، للأسف، اختارت بعض الأنظمة الطريق الأسهل، مفضّلة المصلحة السياسية الضيقة على الوقوف مع الحق والعدالة. ويبقى السؤال المطروح والملح هو ماذا عن الشعوب؟ هل يمكن تبرئتها من المسؤولية؟
إن الحقيقة المرة تكمن في أن الشعوب العربية، التي كانت يومًا عماد القضية الفلسطينية وسندها الأبرز، باتت اليوم غارقة في حالة من الخمول والتقاعس. ولا شك أن الأنظمة القمعية التي تكبل الحريات وتقمع الحراك الشعبي قد ساهمت في ترسيخ هذا الشعور بالعجز، ومع ذلك فهو لا يعفي الشعوب من واجبها الأخلاقي.
فالسلبية المطلقة لا يمكن أن تكون مبررًا، إذ علّمنا التاريخ أن الشعوب، متى اجتمعت إرادتها وتوحد صوتها، كانت قادرة على صنع التغيير. وإن تعذّر النضال السياسي المباشر في ظل الظروف الراهنة، فإن أقل ما يمكن فعله، وأضعف الإيمان، هو المقاطعة.. مقاطعة الكيان الصهيوني وشركاته، وكذلك العلامات التجارية التي تمده بالدعم، هي خطوة رمزية تعبر عن موقف راسخ في رفض الظلم والاحتلال.. المقاطعة ليست مجرد فعل استهلاكي بسيط، بل هي تجسيد للإرادة الشعبية، ورسالة أخلاقية موجهة إلى العالم بأسره، بأننا -وإن لم نستطع حمل السلاح- نرفض أن نكون شركاء في تمويل آلة القمع والعدوان. (كما حدث مؤخرا مع بعض كوادر الشركات الكبرى كمايكروسفت وجوجل وغيرها)…. فالقضية الفلسطينية لا تزال بحاجة إلى دعم شعبي عربي حقيقي؛ فالتاريخ أثبت أن الأنظمة السياسية تتغير، ولكن إرادة الشعوب تبقى هي القوة الحقيقية للتغيير.
إن كثير من العرب باتوا يتعاملون مع القضية الفلسطينية وكأنها شأن سياسي بعيد لا يخصهم، رغم أن الاحتلال الصهيوني هو امتداد لمأساة عربية.. فغابت مظاهر التضامن الحقيقية، وتقلّصت حملات المقاطعة الاقتصادية التي كانت في الماضي رمزًا للمقاومة الشعبية. فالمقاطعة قد تبدو خطوة بسيطة، إلا أنها كانت تعبيرًا عن موقف أخلاقي وإنساني تجاه الاحتلال. ولكن، في ظل هذا الصمت الشعبي، تتراجع قيمة التضامن ليصبح مجرد شعارات خاوية، كمن يهتف بلا صوت في ساحة خالية. والغريب في الأمر أن بعض الحركات الغربية باتت أكثر التزامًا بقضية فلسطين من العرب أنفسهم!…ففي الجامعات والمجتمعات المدنية في الغرب، تنتشر حركات المقاطعة ضد إسرائيل، وتخرج مظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء الاحتلال، وتُمارس ضغوطًا على حكوماتها لاتخاذ مواقف أكثر عدالة تجاه القضية الفلسطينية.. هذا التفوق الإنساني الغربي يُظهر مفارقة قاسية: أن من يدافع عن فلسطين أحيانًا هم من لا تربطهم بها أي علاقة قومية أو دينية، وإنما فقط التزامهم بالمبادئ الإنسانية وفي هذا السياق، نرى أن الحملات التي تُنظم في الغرب، مثل حركة “BDS” (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، أصبحت قوة مؤثرة في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.. هذه الحركة، التي أطلقتها منظمات حقوقية فلسطينية، وجدت صدى واسعًا في الدول الغربية، حيث دعمتها شخصيات عامة وأكاديميون وفنانون. في المقابل، نجد أن الموقف العربي الشعبي أقل فاعلية بكثير، وكأن الشعوب العربية استسلمت للواقع المرير.
إن القضية الفلسطينية لا تزال بحاجة إلى دعم شعبي عربي حقيقي؛ فالتاريخ أثبت أن الأنظمة السياسية تتغير، ولكن إرادة الشعوب تبقى هي القوة الحقيقية للتغيير. وإذا كانت الشعوب العربية قد أبدعت في مقاومة الاستعمار قديمًا، فإنها قادرة على أن تكون القوة المحركة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ففلسطين لن تُحرر إلا إذا اجتمع الجميع على كلمة واحدة: الحرية لا تُشترى بالتطبيع ولا بالصمت، بل تُنتزع بالمقاومة الحقيقية، مهما كانت الوسائل بسيطة. فالاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مشكلة فلسطينية، بل هو قضية أخلاقية وإنسانية. ولأجل هذا الحق، ينبغي ألا نتخاذل أو نتراجع، بل علينا أن نستمر في النضال من أجل العدالة والحرية.
القضية الفلسطينية اليوم ليست مجرد نزاع جغرافي أو صراع سياسي؛ إنها اختبار أخلاقي للعرب وللعالم بأسره. وبينما نرى في الغرب حركات إنسانية تتضامن مع فلسطين وتدافع عن حقوقها، نجد في عالمنا العربي تراجعًا مخزيًا، سواء من الأنظمة التي تخلت عن القضية علنًا، أو من الشعوب التي استسلمت للصمت.
لكن الأمل لم ينتهِ.. لا تزال هناك فرصة لإعادة إحياء القضية الفلسطينية في وجدان العرب، وإعادة تفعيل دورهم في الدفاع عنها. فالعروبة ليست مجرد شعارات، بل هي التزام بالعدالة والحق، وعلى الشعوب العربية أن تدرك أن قوتها تكمن في وحدتها وتضامنها، وأن فلسطين لن تُحرر إلا إذا اجتمع الجميع على كلمة واحدة: الحرية لا تُشترى بالتطبيع ولا بالصمت، بل تُنتزع بالمقاومة الحقيقية، مهما كانت الوسائل بسيطة. ومع ذلك لماذا تباينت المواقف منذ الحرب على غزة ولماذا تم اختزال المقاومة في تسميات ضيقة المراد منها تشويه القضية وتبخيسها.
*هل يمثل الصمت أو الخذلان خطيئة إستراتيجية؟*
اتّسم الموقف العربي من الحرب على غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بتباين حادّ بين موقف الأنظمة العربية بسبب تفاعل تحالفات إقليمية ودولية أَخَلَّت بفاعلية المنظومة العربية في مجابهة الأزمات والتحديات وذلك يعود بالأساس إلى معطيات موضوعية تهم المنطقة في صراع القوى الدولية أو الإقليمية، والتي عملت على تفجير التوترات وتغذية النزاعات البينية، لإحكام الهيمنة والسيطرة على القرار السيادي والاختيارات الكبرى، وهذا ليس جديدًا؛ وإنما يمتد في جغرافيا العرب والمسلمين منذ غروب إشعاع الحضارة في الشرق، وسطوعه في الغرب مع فجر الحداثة والتقدم الذي كانت له مخالب عمل من خلالها على إضعاف الآخرين لحيازة القوة.
هذا عن البعد الموضوعي للانهيار وأفول الدور العربي، أما البعد الذاتي، فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة المنظومة العربية نفسها، وأنماط تشكل السلطة والحكم فيها، فهي قائمة على القهر والغلبة والاستبداد، مما يجعلها تفتقر إلى أدنى درجات التعبير عن الإرادة العامة وتطلّعاتها. وهذا يفسر بشكل ما تباين المواقف والتناقض الحاصل في مواقف واختيارات عدد من الأنظمة والدول العربية والإسلامية مع اختيارات ومواقف شعوبها، بخصوص فلسطين والعدوان على غزة، وما ترتب عنه من أزمة إنسانية مفجعة، إذ يعتبر الجمهور العربي في عمومه؛ فلسطين جزءًا لا تتجزأ عن قضاياه الإستراتيجية (كما أشرت سابقا)، ولا تخضع لحسابات التجار والمصالح الاقتصادية التي تجعل لكل شيء ثمنًا وكسبًا ماديًا من ورائه؛ (أي النظر في القضية بميزان الربح والخسارة)، بل تمثل لهم من حيث الجوهر قضية مبدأ باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين.
وبالمثل يشكل ضياع الوجهة وغياب الرؤية الإستراتيجية والافتقار إلى شرعية الإرادة العامة وغياب المشروع الوطني، مدخلًا لفهم محددات الانشطار في منحيَيه؛ الانشطار الأفقي داخل النظام الرسمي العربي، والانشطار العمودي الذي سيجعل من فلسطين عنصرًا في تعميق الهوّة بين الشعوب ونخبها الحاكمة، وهي القضية التي يمكن أن يشكل فيها الموقف الصريح والضاغط لصالح غزة، مدخلًا للمصالحة والتوافق السياسي والمجتمعي؛ بسبب الرمزية التي تحتلها فلسطين في الوجدان والوعي العربي، وهذا لم يحصل. فما هي علاقة الجمهور العربي بفلسطين؟ وما هي المحدّدات في فهم الموقف؟
تتسم العلاقة بين الشعوب العربية والإسلامية وفلسطين بتفرّد خاص، إذ رغم ما تعرضت له المجتمعات العربية من جرف للوعي وتغذية للانقسامات السياسية والثقافية، أو الحروب والنزاعات العنيفة، لتفكيك النسيج الاجتماعي العربي الإسلامي، وإشاعة الروايات الزائفة بخصوص النكبة وتضييق مجال الصراع في أطواره المختلفة، من صراع عربي – إسرائيلي إلى صراع فلسطيني – إسرائيلي، ثم أخيرًا إلى غزة بمكوناتها وفصائلها وإسرائيل، نقول على الرغم من ذلك، فإن الوعي والشعور العربي الإسلامي حافظ على مكانة خاصة لفلسطين، وإن لم يظهر ذلك في عدد من الدول؛ بسبب منع التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي. تلك المكانة تحفزها على الدوام ثلاثة منطلقات أو محددات كبرى.
أولًا: من منطلق المحدد الديني والتاريخي، ذلك أن الأقصى في الخيال والتصور الديني الإسلامي، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي – صلى الله عليه وسلم-، وفلسطين مهد الرسالات وأرض النبوّات، كما أنها من ناحية الوعي التاريخي والحضاري تمثل نقطة ارتكاز في جوانب الصراع التي مرت منها الحضارة الإسلامية مع الغزاة، فالسيطرة على جغرافيا فلسطين تعتبر مؤشر ضعف للمكون الحضاري العربي والإسلامي، كما أن تحررها مثّل انبعاثًا متجددًا من تحت الرماد، وما أشبه اليوم بالأمس، وكأنه مكر التاريخ، يعيد نفسه في تجارب حية للاعتبار والاستبصار.
إن المحدد الديني لا يعني الانغلاق والتقوقع كما يتخيل للبعض من تجارب مغايرة، أو إقصاء للمكونات الدينية الأخرى، بل إنه منذ أن فتح المسلمون القدس 15 هـ، 636 بالتاريخ الميلادي، تم تأمين ممتلكات وكنائس أهل إيلياء، وضمن المسلمون فيها وفي غيرها من البلدان تعددًا فريدًا وحرية دينية وعقدية قلً نظيرها، والتحم المسيحيون مع المسلمين، جنبًا إلى جنب، وظل الالتحام الاجتماعي والثقافي قائمًا إلى اليوم، مما يجسد صبغة الحرية التي اصطبغ بها النموذج الحضاريّ الإسلامي. ولا يزال هذا الأفق التحرري في فلسطين يستمد أصوله من البعد الديني، الذي يحتاج إلى قراءة مغايرة عما هو سائد بخصوص الديناميكيات التي يخلقها الدين والأثر الذي يخلفه، ذلك أنه إذا كان عنصر إكراه في مجال حضاري معين، فهو عنصر تحرير في حيز آخر، بل إن المأساة التي تشهدها غزة، توحي بانهيار السرديات والرؤى التي نظرت إلى المعطى الديني نظرة أيديولوجية ضيقة مسيّجة بقوالب جاهزة. ويكفي أن نقول إنه في العالم العربي والإسلامي شكّل على الدوام عنصرًا باعثاً للتنوع والتعددية، ومؤلفًا للشعور الوحدوي، والقضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تؤثر من هذا المنحى، وأثره سيكون على المدى البعيد.
ثانيًا: وحدة الشعور والمصير العربي المشترك، ولذلك نالت القضية مكانتها الأولى سياسيًا منذ قرار التقسيم، وثقافيًا في أشكال الإبداع المختلفة التي تعبّر عن رمزية فلسطين في الوجدان العربي بأطيافه المُختلفة.
أما تخاذل الموقف الرسمي العربي بخصوص غزة وفلسطين، فإنه يضمر في واقع الأمر تفريطًا في السيادة والاستقلال، وتعبيرًا عن عجز المنظومة العربية التي حافظت على الشكل والمؤسسات في لقاءات دورية راتبة، في غياب المضمون والروح العربية التي تجسد التطلعات والمصالح الإستراتيجية المشتركة، فهي أشياء تلاشت، وأصبحت في حكم الأمنيات.
أمّا المحدد الثالث، فهو المنحى التحرري من الاستعمار، وتمثّل فلسطين في هذا السياق آخر ضحايا النزوع الاستعماري، ومن خلال هذا المنحى تتخذ فلسطين بكثافتها رمزية، لفضاء تتلاءم فيه مختلف الإرادات الإنسانية من الشرق والغرب، الشمال والجنوب، لمناصرة شعب يعاني الاضطهاد والاستعمار، ولذلك لا تحتل فلسطين مكانتها الأولى على المستوى العربي والإسلامي وحسب، وإنما هي بمثابة وخز للضمير الإنساني برمته، والحافز له للدعم من أجل إقرار الحرية وتقرير المصير. لكن وبالرغم من رمزية القضية في الوجدان العربي والمسلم، والموقع الذي تبوأته سياسيًا في جدول الأعمال العربي والإسلامي الرسمي لعقود طويلة، فإن العدوان الراهن، وعدم قيام العرب والمسلمين بالدور المطلوب، يدفع إلى التساؤل عن أسباب العجز وعدم فاعلية الموقف العربي، ولسنا من نقول العجز وعدم القيام بالدور المطلوب، وإنما استغاثة المكلومين في غزة التي لم تجد آذانًا مُصغية. لكن مالموقف العربي الرسمي من العدوان على غزة؟…
يمكن القول ابتداء وبكثير من الأسف، إن الموقف الرسمي العربي – والإسلامي كذلك – في عمومه، شكل حافزًا مباشرًا أو غير مباشر لاستمرار العدوان على غزة، وإبادة أهلها، وبصيغة أخرى، إن وقف العدوان لا يتوقف فقط على ما سيصدر من البيت الأبيض أو مجلس الأمن أو حكومة الحرب في إسرائيل، وإنما في تجاوز الانقسام العربي والخروج من الرؤى الضيقة للأحداث والعناصر الفاعلة فيها، إلى القضية الفلسطينية برمتها وانعكاساتها على الخيارات الإستراتيجية للوجود العربي، مما يحتم اتخاذ خطوات عملية للضغط السياسي على إسرائيل ولجم عدوانها على أهل غزة. ولعل ما يتم التصريح به إعلاميًا، فهو يرقى إلى رسائل الود وليس تعبيرًا عن إجراءات مقنعة، أو مواقف يمكن اعتبارها مساندة فعلية للحق الفلسطيني، ذلك أن الخطوات التي يتخذها عدد من الدول العربية والإسلامية في الاتجاه الآخر؛ أي في العلاقة مع إسرائيل من حيث العلاقات الاقتصادية والسياسية، مقابل افتقاد القدرة على مجرد حل مشكلة الأزمة الإنسانية في الغذاء والدواء، وهذا يرجع لعدة أسباب تخص المنظومة العربية وهي كالتالي:
أولًا: الانقسام الأفقي في البيت العربي، وانزياح عدد من الدول منفردة في خيارات إستراتيجية لا تعبر عن الضمير العربي.
وهذا يعبر عن أزمة عميقة في المنظومة العربية الرسمية، تتمثل في غياب رؤية إستراتيجية تحمي المصالح العربية، وهي مصالح لا يمكن أن تتم على حساب تصفية القضية الفلسطينية، أو المساومة عليها ضمن خيارات مناقضة لرغبة الجمهور العربي والإرادة العامة، وهي رغبة تكمن في المحددات التي ذكرناها سابقًا، والتي تجعل فلسطين على أولوية الاهتمامات، بل إن عدم اتخاذ مواقف صريحة وإجراءات عملية سيزيد من تعميق الهوة بين الأنظمة وشعوبها، ويغذي تطلعات التغيير الجذري في المستقبل.
ثانيًا: تحول القضية الفلسطينية إلى عبء لدى عدد من النخب والأنظمة العربية، فالقضية الفلسطينية في نظرها مشكلة، لا يهم الطريقة التي ينبغي بها إيجاد حل لها، وهذا يعكس طبيعة النخبة الحاكمة ولفيف من الطبقة السياسية وولاءاتها ومصادر قوتها واستمراريتها، فهي ليست كامنة في قيم ومبادئ العصر السياسية؛ أي في احترام الإرادة الشعبية ضمن مشروع وطني يحقق السيادة والاستقلال في القرار، كما أن التقدم ليس انبعاثًا من داخل الذات الثقافية والدينية والحضارية مع مد للجسور مع روح العصر.
فمصادر القوة والولاء والاستمرارية في الحكم مستمدة من الوكيل والراعي الأكبر للنظام الدولي، ومسارات التقدم تقتضي تنويرًا زائفًا يعمل على تفكيك المقدرات الثقافية والقيمية التي تشكل حصنًا من حصون المناعة، ودافعًا للفعل التحرري بنوازع أخلاقية تنظر إلى فلسطين كجزء من الذات الحضارية العربية والإسلامية.
وهذا الوعي يشكل في منظور الطبقة السياسية الحاكمة تحديًا خطيرًا يفكك الأنساق السياسية وارتباطاتها المناهضة لإرادة الأمة ومصالحها الحقيقية، أي أنه باعث لتحرر مزدوج داخلي وخارجي، ومن ثم تعد إزالة العبء الفلسطيني بمثابة تسوية كاملة تخدم الأهداف والرغبات المتحكمة في نوازع تلك الأنساق والأنظمة، لكن هذا في واقع الأمر يعكس حالة من العمى الإستراتيجي وعدم الوعي بالتاريخ والسنن الاجتماعية، سيؤدي في واقع الأمر إلى نقيضه.
ثالثًا: الخصومة الأيديولوجية والسياسية مع مكونات البيت الفلسطيني، مما دفع إلى حالة من الصمت المريب أو التعبير إعلاميًا وسياسيًا بمواقف وتقديرات قد تضرّ بغزة وفلسطين وتخدم الأجندات الأخرى، بل وبصيغة مباشرة تمثل ضوءًا أخضر لعملية الاستئصال المزمعة التي تحقق رغبات كامنة لدى لفيف من طبقة الحكم هنا وهناك.
وهذا يحمل خللًا من وجهتين: الوجهة الأولى: عدم التمييز بين الخلاف الأيديولوجي الذي لا إشكال فيه والمصالح الإستراتيجية للدول والمنطقة التي تتعالى عن ضيق قفص الأيديولوجيا والحسابات الضيقة، ثم من جانب آخر، يعد الإضرار بأركان البيت الفلسطيني وتدمير غزة كاملة وإعادة احتلالها وإنهاء المكونات الفلسطينية الفاعلة كما يعبر مجلس الحرب، إضرارًا بالأمن القومي والمصالح الإستراتيجية المصرية والخليجية معًا، بل والعربية والإسلامية كاملة، وهو ما يستدعي مراجعة للموقف والضغط والمساندة الفعلية للحق الفلسطيني.
على سبيل الختم: يشكل الموقف العربي الرسمي في صيغته الراهنة، انسلاخًا عن التاريخ وتعبيرًا عن خلل أو خطيئة إستراتيجية ستكون كلفتها مرتفعة في الأمد المنظور، كما أنه منفصل كلية عن الوجدان العربي الإسلامي والموقف الشعبي، وهو بذلك لا يقدر رمزية القضية وحجم الكارثة التي حلت بغزة وستحل بفلسطين، وهي بالتبع ستحلّ بباقي الأنظمة والدول في المنطقة، ذلك أن فلسطين تمثل مهمازًا للضمير والوعي العربي الإسلامي، لقدسيتها ومكانتها وتعبيرها عن حالة نقاء وطهر تلهم التحرر الإنساني برمته، وتعري المنظومة الدولية في جوانبها الأخلاقية والسياسية والحقوقية، بفعل تواطئِها مع آخر الظواهر الاستعمارية.
لذلك فإنّ مراجعة الموقف العربي في سبيل تحقيق ضغط فعلي لوقف العدوان ومنع الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تفتك بأهل غزة في زمن البذخ والترف والاستهلاك، يعد واجب الوقت من جوانب متعددة، أخلاقية وسياسية وإستراتيجية ودينية، وإلا فإن ما يجري بغزة له ارتدادات كبيرة عربيًا وإسلاميًا وإنسانيًا من ناحيتي الوعي والفعل معًا، وعربيًا ستكون آثاره مباشرة على المنظومة القائمة، كما أنه يسجل الخروج الفعلي للعرب من التاريخ، وبدون مواربة، تمثل بعض أشكال الصمت والخذلان خطيئة إستراتيجية. فهل من مستقبل للرسالة؟!
كاتب مغربي