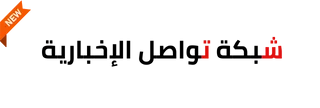محمد سعد عبد اللطيف: الضريح المنسي: تأملات في ذاكرة المكان والروح

محمد سعد عبد اللطيف
في قريتنا القديمة، الواقعة بين منحنيات الترعة وسفوح الذكريات، كان هناك ضريح لا يذكره أحد، ولا ينساه أحد. إنه ضريح الشيخ “عوض”، القائم هناك في هدوء، كأنما يصلي مع النسيم. بالقُرب منه ضريحٌ آخر لشيخ يُدعى “ظهير الدين”، كان يُزار في المواسم، وتُروى حوله الكرامات والحكايات. لكن الضريح الذي كان يشعل القلوب ويجمع أهل القرية في حضرة الاحتفال، هو مقام “العارف بالله الأزمازي”، الذي أُزيل بصمت مع توسيع المسجد… وكأنهم هدموا ركنًا من أرواحنا.
أصل الحكاية: الولي والضريح
لطالما كانت الأضرحة في الريف المصري مرآة للروح الشعبية، تنبض بالحكايات أكثر من الحقائق. يُقال إن الأزمازي لم يكن شيخًا بالمعنى التقليدي، بل كان “مجازًا” من أهل الذكر، له لحظة كشف في صلاة الفجر جعلت أهل القرية يجلّونه كأولياء الله. ومع أنه لم يُطلق عليه لقب “الشيخ”، ظل اسمه يسبق اسم المسجد والشارع والمولد، إلى أن جاء يوم شاحب اللون، وقرروا إزالة الضريح في صمت إداري بارد، دون أن يفهم أحد كيف تُمحى ذاكرة كاملة بجرة قرار.
أما “الشيخ عوض”، فضريحه قائم لكنه منسي، لا تُقام له زيارة، ولا تُشعل له شمعة. تهمس بعض العجائز أنه كان من سلالة المغازية، جاء إلى القرية من المغرب أو من أسيوط، الله أعلم، واستقر تحت شجرة سدر، وأخذ يعالج الناس بالأحجبة والآيات. بقي الضريح هناك، صامتًا، كمن ينتظر من يعيد له اسمه، أو يسأله عن حاله.
بين الدولة والضريح: جذور ممتدة في العصر الفاطمي
تُعد الأضرحة والمقامات جزءًا من بنية التدين الشعبي في مصر، وقد بدأ ازدهارها فعليًا في العصر الفاطمي (969–1171م)، حين تبنّى الحكام الفاطميون نشر مظاهر التشيّع حبًّا لأهل البيت، فبنوا المشاهد الكبرى مثل مسجد الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، وغرسوا بذلك جذور فكرة “الزيارة” كممارسة روحية واجتماعية. ومع تحول التصوف السني في العصور التالية إلى تيار شعبي واسع، ازداد عدد الأولياء، لا سيما في العصر المملوكي، وبدأت الأضرحة تنتشر في الأقاليم، لا كمراكز دينية فقط، بل كمحطات لحفظ السكينة الاجتماعية، وتكافل الأرواح في مواجهة قسوة الدولة والزمان.
وقد ذكر المقريزي في “الخطط” كيف كان المصريون يزورون قبور الأولياء، ويعتبرونها مواضع للبركة والتوسل، كما أشار عبد الوهاب الشعراني في “الطبقات الكبرى” إلى عدد من الأولياء المغمورين الذين عُرفوا بعد وفاتهم من خلال الكرامات لا الألقاب. وربما كان الأزمازي واحدًا من هؤلاء: “مستور في حياته، ظاهر في موته”.
الضريح كمؤسسة اجتماعية
لم يكن الضريح مجرد مقام ديني، بل كان مؤسسة شعبية: فيه تُقرأ الفواتح، وتُوزع اللحوم، وتُحل الخلافات، ويُكتب أول اسم للوليد في السجل الطاهر. كان المولد عيدًا للفقراء، تُنسج فيه الأغاني والحلوى والفرح، وتجتمع فيه الأرواح تحت راية حب تتجاوز المذاهب.
وقد ذكر الباحث الفرنسي “آلان روسيون” في كتابه “الولي والسلطان” أن الأضرحة في مصر شكّلت نوعًا من التوازن بين السلطة المركزية والإرادة المحلية، حيث كان الولي في المخيال الشعبي “ظلًا لله” في الأرض، قادرًا على منح الكرامة حين يبخل بها الحاكم.
النسيان كقتل بطيء للذاكرة
في العقود الأخيرة، بدأ التعامل مع الأضرحة ببرود رسمي، أو عداء أيديولوجي. تأثرت بعض المؤسسات الدينية بالتيارات السلفية التي تعتبر زيارة القبور “بدعة”، بينما رأت الدولة في بعضها “مواقع مخالفة” تستدعي الإزالة باسم التحديث. وهكذا، تم هدم العديد من الأضرحة في دلتا مصر والصعيد، كما حدث لضريح الأزمازي. لكن أحدًا لم يسأل: ماذا يعني أن تهدم الذاكرة؟ أن تترك أرواحنا يتيمة بلا موطن رمزي؟
في حضرة الضريح المنسي
أعود بذاكرتي إلى موسم الأزمازي. كانت القرية تتزين، والرجال يذبحون الذبائح عند المقام، والنساء يضعن أطفالهن قرب الضريح “تفاؤلًا بالستر”. كانت ليلة مولده تتجاوز الزمان، تتحول فيها القرية إلى قرية أخرى، تتصالح فيها الأرواح والقلوب. الآن، لم يعد أحد يتذكر اليوم، كأن الأزمازي خرج من التاريخ ودخل في البرزخ.
لكن ضريح الشيخ عوض ما زال هناك، مهجورًا لكنه صامد، كأنما ينتظر من يعيد إليه اسمه، ومن يُشعل شمعة في ذاكرة المكان.
أخيرًا: ما بين الضريح والهوية
إنّ الأضرحة، على ما بها من خرافات أو مبالغات أحيانًا، تظلّ شاهدة على العلاقة العميقة بين الإنسان المصري وروحه. هي ليست أماكن فقط، بل “وجوه الزمن”، وبيوت للأمل. ضريح الشيخ عوض، والعارف الأزمازي، وظهير الدين، كلهم حلقات في سلسلة طويلة من الروحانية الشعبية التي تستحق الإنصات لا الإلغاء. فهل نعيد النظر في تاريخنا قبل أن تُمحى ملامحه تمامًا؟
كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية,,!!
[email protected]