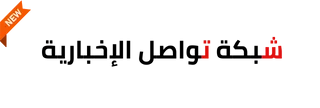نادية حرحش: عامر حليحل: “جذوري من تلك المنطقة”

نادية حرحش
منذ بداية هذه الحرب الغاشمة على غزة، والضحكة صارت بغصة تملؤها المرارة. سمحت لنفسي بابتسامات خجولة يرجوها الامل. وجدتها في “أبو سمير” — شاب غزّي وجهه مضيء كبدر في سماء حالكة. أبو سمير ممرض، استخدم الضحك كوسيلة للعلاج قبل الحرب، ثم صار بعد الحرب عنوانًا لمأساة بلون السخرية، لاذعة في صدقها، تفضح الحقيقة بعقل وذكاء، وابتسامات تُنتَزع من بين أنقاض الكوارث المتلاحقة.
بالأمس، أحيا مسرح الحكواتي عرضاً للفنان عامر حليحل. قررت الذهاب على الرغم من تجنبي الذهاب الى أي عرض او حفل مهما كان، لأنني اخجل بداخلي من ممارسة حياتي بطبيعية، على الأقل بالعلن. اخجل من اهل غزة، من هذا الشعب المنكوب الذي تتوالى عليه الفواجع. أخشى دمعة ام ما زالت مثقلة بثكل مصابها. اخجل من نظرة طفل تخترق اعماقي فقد للتو كل ما يملكه من حياة: اب، أم، أخ، أخت، عائلة بأكملها.
ذهبت هذه المرة، وربما بداخلي رجاء بأن يتوقف هذا البلاء قريباً. صار توقّف القصف لساعات—كي يتمكن اهل غزة من التنفس– هدفاً عظيماً بحد ذاته إن أمكن تحقيقه. أصبح أقصى ما نبتغيه هو إدخال الطعام، بأي طريق وبأي ثمن، كي لا يموت الناس جوعاً في هذا العراء الذي عرّانا من كل معنى لوجودنا.
أحتاج تبرير ذهابي — لنفسي أولًا، ولأولئك الذين يعيشون مأساةً حقيقية في مسرح تراجيدي قاتل.
كل يوم في غزة هو تمثّل حيّ لطبقات جحيم دانتي.
وربما، عامر حليحل كان مثلي في شعوره.
كيف يمكن لفنان ان يقدم عرضا، أن يسرق بسمة أو ضحكة؟ أن يصنع مونولوج يقول فيه ما لا يمكن قوله تحت وقع استبداد وقمع للحريات، كنا نسمع عنه من الاباء والاجداد، ونظنهن جبناء، لعدم قدرتهم على التصدي للظلم والقهر؟
جلست كالكرسي متخشبة، أحاول الا اتفاعل مع قهقهات الجمهور خلال عرض مفعم بالإبداع والبلاغة.
قلت في نفسي: لست هنا لأضحك. انا هنا لأتحسر.
ولكن الابتسامات تسلّلت اليّ، كما تتسلّل الحياة الى جسد طريح الفراش.
خلال ساعة ونصف، مرّت المأساة محمولة على جناح السّخرية، كمرارة علقم تتجرّعها مضطراً، لأنّك جائع.
وربّما، هذا تحديدا، أقوى ما يستطيع الفلسطيني أن يقدّمه: نفسه.
كلّ ما احتاجه عامر حليحل هو أن يقف أمام الجمهور كمرآة، يري كلّ منّا فيها نفسه.
فالتّجربة الفلسطينيّة فريدة—مختلفة لكلّ واحد منّا، لكنّها واحدة في جوهرها، رغم الجغرافيا التي قطّعت أوصالنا داخل الوطن الواحد.
كانت صرخة عامر حليحل الجليّة في عرضه بلا انقطاع: تلك المتعلّقة بهويّته.
وكأنّه يصرخ: “انا من هنا. انا من هناك. أنا أنت. وأنت أنا. هنا…وهناك.
ربّما نحتاج هذا الوصال الفلسطيني المتعلق بهويتنا التي تشرذمت، وتمزقت، واهترأت على مر ثماني عقود، بفعل الاحتلال مرة وبفعل الفساد مرات كثيرة.
هناك ما يعكس نفسه في “الأنا الفلسطينية”، قد تختلف اللهجات واللكنات والظروف التي جعلت من المناهج التعليمية أداة مسح وسحق للهوية الفلسطينية. ولكن هناك ما يتغلغل بالعروق، تتنفسه جدران البيوت ربما.
وكأنّ كلمات محمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وإبراهيم طوقان وكوكبة شعراء سطعوا في سماء فلسطين عندما لم تسعهم أرضها، صارت كالهواء يتنفّسه الفلسطيني. لا تستطيع أي جغرافيا أن تمنعه. فلا يتمكّن من إيقافه حاجز، ولا يقدر قصفه صاروخ. كالهواء تأثُر تلك الكلمات في وجداننا وتصير أغنيات وأناشيد يجعل من الفلسطيني مهما كبر، فتى يتطلع الى يوم حرّيّة.
ما قدّمه عامر حليحل كان دعوة ربّما.
أو كان مونولوج ربّما.
كان تذكرة ربما، للفلسطيني: أن الهوية لا يمكن احتلالها، حتى لو احتُلّت الأرض وقسّمت وسُرقت واستُبيحت وقُمعت وتدمّرت.
إنّ الهويّة الفلسطينيّة في حالتنا، هي انبعاث ربّما.
كالروح لا تموت، تبدو لوهلة وانّها خُنقت، قُتلت، تمزّقتْ، تشرذمتْ، انتهتْ.. ولكنّها دوماً تعود، لأنّها باقية قد تنتهي من جسد، ولكنّها ترتقي إلى ملكوت لتعود أدراجها إلى جسد.
نحن نتنفس هذه الهوية لنكون… لنبقى …
لتكون فلسطين أكبر من خارطة تشكّل بقعة جغرافيّة.
لتكون فلسطين… هذا الإنسان المتمسّك بهذه الهويّة بكوْنها هواؤه… ومعنى وجوده.
لذلك…
حين وقفتُ في قاعة المسرح، أحاول تبرير لحظة عادية في عالم غير عادي، أدركت أن الهوية ليست فقط ما نعيشه، بل ما يَحْيَا فينا رغم كل محاولات المحو والقتل.
وجدت في كلمات راشد حسين مرآةً لما نشعر به الآن — رغم المسافة، رغم تغيّر الزمن.
كان يرى الجرح ذاته، يحدّق في غزة من زمنٍ آخر، لكنه كان يعرف أن النار لم تنطفئ، وأن البحر لا يزال وراءنا، والنار أمامنا.
وكأنّ غزّة هي ذلك الجرح الذي لا يتوقف عن النّزيف…
متعبٌ من خُطَب الأقزامِ
يا غزّة… متعبْ
وورائي البحرُ، والنار أمامي
ولذا.. أمشي على قلبي إلى النارِ، وأشربْ
متعبٌ…
جلدي استوى، عظمي استوى، عقلي استوى
والنار من عينيّ تشربْ
ولهذا…
أنا لا أحمل صلباناً، ولكنْ
أُحرِق الصلبانَ
أو أصنع منها سفناً تحمل أطفالي
إلى أجمل ثورة، أو لصبحٍ يتدرّبْ
متعبٌ…
حتى صلاح الدّين يا حطّين، أمسِ ناداني إلى حُلمٍ وقال:
بالأغاني حرّروني!
بالأغاني…
حوّلوا حتى خيام الموت في أرضي… أغاني
رسموني بدمي الباكي على أعلى المباني
كتبوني… لخّصوني… وأذاعوا كلّ عمري وبلادي
في ثواني
ثم لمّا اعتقلوني…
بالأغاني اعتقلوني
بالأغاني…