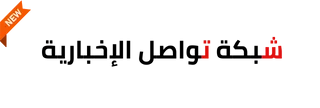ضياء اسكندر: الانتصار الروسي في سوريا… هل هو هزيمة بشكل آخر؟
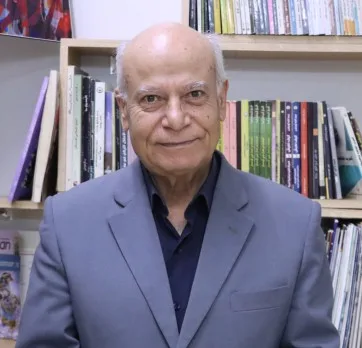
ضياء اسكندر
بدأت ملامح النفوذ السوفييتي تتشكل في سوريا، منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث توطدت العلاقات بين دمشق وموسكو عبر بوابة الدعم العسكري والاقتصادي، خصوصاً بعد انقلاب البعث عام 1963 وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائي.
ومع تصاعد الحرب الباردة، تحوّلت سوريا إلى حليف استراتيجي للاتحاد السوفييتي، فتلقّت دعماً ضخماً في مجالات الدفاع والتسليح، وتم تدريب آلاف الضباط السوريين في الأكاديميات العسكرية الروسية. هذا الإرث العميق من التحالف لم ينقطع بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بل تعزز مع عودة روسيا إلى الساحة الدولية في عهد بوتين، حيث سعت موسكو إلى ترميم نفوذها التاريخي في الشرق الأوسط، وكان التدخل العسكري المباشر في سوريا عام 2015 تتويجاً لهذا المسار الطويل.
منذ 30 أيلول 2015، حين أطلقت روسيا عملياتها العسكرية المباشرة في سوريا، بدا وكأن موسكو تحوّلت من داعم سياسي إلى لاعب رئيس يمسك بزمام الميدان. أنشأت قواعد عسكرية استراتيجية، أبرزها ميناء طرطوس البحري ومطار حميميم الجوي في جبلة، وارتفع عدد جنودها في البلاد إلى نحو 60 ألفاً قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
مقابل ذلك، اقتصر الوجود العسكري الأميركي على قواعد محدودة في منطقة التنف وشمال شرق سوريا، بعدد لا يتجاوز ألفي جندي. وبالأرقام والمعطيات، لم يكن هناك مجال للمقارنة بين الحضور الروسي الكثيف والدور الأميركي المحدود… ظاهرياً.
فمن المفترض أن من ينتصر في الحرب، يفرض شروطه في السلم. إلا أن الواقع السوري حمل مفاجأة صارخة: على الرغم من نجاح القوات الروسية، بالتعاون مع الجيش السوري والمليشيات الرديفة، في استعادة مساحات واسعة من البلاد كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، فإن الكلمة السياسية العليا لم تكن من نصيب موسكو. خلال أحد عشر يوماً فقط، نجحت قوى إقليمية ودولية – في مقدمتها الولايات المتحدة وتركيا و”إسرائيل” – في قلب الطاولة، والإطاحة فعلياً بالنظام السوري، وتقديم سلطة جديدة مصممة على مقاس مصالحها. فهل غفلت روسيا عمّا يُحاك؟ أم أنها كانت على علم، وربما شريكة بصمتها؟
إذا كانت موسكو قد فوجئت بما جرى، فإن ذلك يعني فشلاً ذريعاً في تقدير الحسابات الدقيقة، وسقوطاً استخباراتياً لا يليق بدولة بحجم روسيا.
أما إذا كانت مشاركة ضمنية أو رضاً ضمني، فالكارثة أعظم: إذ كيف يُعقل أن تضحي بكل ما بنته خلال عقود من العلاقات والمصالح، دون أن تحصّل ثمناً سياسياً يليق بحجم تدخلها؟ هل كانت تعلم، وتغاضت؟ أم أنها تنازلت في مكان لتحصد في مكان آخر، كجزء من صفقة دولية غير معلنة؟
في الحالتين، فإن روسيا، التي ظهرت في سوريا كقوة لا تُقهر، وجدت نفسها فجأة خارج دائرة القرار، تنظر من بعيد إلى مسرح كانت تظن أنها تسيطر على خشبته وستاره وممثليه.
حين لا يكفي النصر العسكري
لم يعد يكفي في الحروب أن تنتصر بالبندقية وحدها. فالمعارك الحديثة تُحسم في غرف التفاوض، وممرات الاستخبارات، وشبكات النفوذ الخفي. وربما، في الحالة السورية، تبيّن أن من يملك الأرض لا يملك بالضرورة القرار… وأن الانتصار العسكري قد يكون، في بعض الأحيان، شكلاً مموهاً للهزيمة.
تداعيات قادمة… وسيناريوهات مفتوحة
ما حدث في سوريا لا يُمكن عزله عن السياق الأوسع لصراع النفوذ العالمي، حيث تعيد القوى الكبرى رسم خرائط الهيمنة بأدوات أكثر مرونة وخبثاً. وإذا كانت روسيا قد اكتشفت متأخرة أن السيطرة العسكرية لا تكفي لضمان موطئ قدم دائم، فإن هذا الدرس القاسي لن يمر مرور الكرام على استراتيجيتها القادمة، لا في سوريا فقط، بل في سائر مناطق نفوذها. أما بالنسبة لسوريا، فإن هذا التحوّل يُنذر بمرحلة شديدة التعقيد، تُعاد فيها هندسة السلطة وفقاً لمصالح متعددة ومتناقضة في آن معاً.
ومن غير المستبعد أن تشهد البلاد، في السنوات المقبلة، المزيد من التبدلات في موازين القوى الداخلية، لا بفعل إرادة السوريين، بل بتصميم خارجي دقيق تُرسم ملامحه في أنقرة وواشنطن وتل أبيب، وربما في موسكو أيضاً… ولكن من مقعدٍ أبعد هذه المرّة.
كاتب سوري