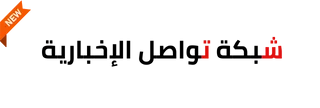متى سوف نعيد عيون إيلي كوهين؟

د. لينا الطبال
مرت سنوات، ثم عقود، ثم ثلاثة أجيال مكسورة، شاخت فيها الأوطان، ومازلنا نحلم. تعاقبت أنظمة، وانقرضت مذاهب وأحزاب… مع ذلك، لم تستطع إسرائيل أن تستعيد من دمشق عظام جاسوسها إيلي كوهين… ولا ظفرا واحدا منه، ولا حتى “فردة من كلساته” القطنية التي ربما كانت صناعة عربية.
الصحافة العبرية، مازالت تكتب بأسى أن دمشق لا تزال تحتفظ بنظارات إيلي كوهين كغنيمة حرب. في الواقع، لا أحد في دمشق يعرف اليوم أين دفن كوهين. تماما كما لا أحد يعرف أين دفنوا آخر ما تبقى من الكرامة الوطنية. ربما لأننا لم نعد نملك ترابا في ارض الوطن.
ها نحن، في الجمهورية الشامية الرابعة… او الخامسة، لا فرق، فالأرقام غير مهمة لنا، نشهد على اشهر قليلة من حكم أحمد الشرع: الرئيس الهادئ، الأنيق، الذي يتحدث بلباقة عن العدالة الانتقالية بينما يخطو على الدماء بحذاء إيطالي ويضبط الفوضى بساعته السويسرية.
في عهده القصير، وبينما الوزارات تنقح بياناتها بـ”الشفافية” و”إعادة الإعمار”، نجحت إسرائيل بهدوء بيروقراطي مذهل في استرداد مقتنيات إيلي كوهين : أوراقه، دفتر ملاحظاته، صور وربما الكثير منها عن السوريين الذين ابتسموا له كثيرا.
قال بيان الجيش الإسرائيلي ” لقد استعدنا مقتنيات من الحقبة الذهبية للاختراق الأمني.” دمشق، في المقابل، لم تصدر أي بيان. لأنها لم تعرف اصلا انها فقدت أي شيء. لم تعرف أن هناك من دخل، ثم خرج، ثم عاد ليأخذ ما نسيه منذ نصف قرن… ولم يسأله أحد عن اسمه… ماذا عن نظارات ايلي كوهين؟
هل تريدون الضحك قليلا؟ إسرائيل، بكل برودة اعصاب تستعيد ما فشل فيه بيغن، وشارون، وشامير، ونتنياهو في ذروات غرورهم. استعادت أوراق جاسوسها، وأشياءه، تلك التي تفوح منها رائحة عطر دمشقي خفيف… إسرائيل استعادت هذه الاوراق تحت راية أصدقائها في الدولة.
من هم يا ترى؟ فكر قليل لكن لا تتعب نفسك… انه الفيلق المسلح من الملتحين الذين لا يسمعون ولا يرون، حين تقصف طائرات الـF-35 الإسرائيلية سوريا. أعطيك مؤشر آخر، لا تجهد نفسك كثيرا: هؤلاء هم من كانوا يرسلون جرحاهم للعلاج في مستشفى زيف، في مدينة صفد… نعم، صفد التي خرجت منها النساء باكيات في النكبة، وسيعود اليها ابناؤنا حاملين راية النصر.
لا أحد يعالج اخوانه في مستشفى عدوه، إلا إذا كان يعتبره صديقا.
الساعة الآن في دمشق تشير إلى زمن رمادي، يستوطن القلب والرئتين كضيق تنفس دائم… حان الوقت لنفخ الحياة في جسد الجاسوس.
في وقت قريب عندما ستستعيد اسرائيل رفاته، ربما ستنظم له جنازة رسمية وستبثها قناة عربية شعارها على شكل قطرة ماء، خُط بلغة الضاد، بالخط العربي الديواني تحديديا…
الغريب أن إسرائيل لم تنس كوهين. نحن من ننسى. نحن من ننسى كل شئ نحن أبناء الهزيمة المتوارثة، نفتح أفواهنا لنبتلع الغبار… كل شيء عندنا يُنسى. قد نكتب عن إيلي كوهين اليوم وننسى اسمه بعد ذلك. حقا نحن نسينا أسماء القرى التي احترقت، والمدن التي بيعت، والشهداء الذين سقطوا لكي نحيا…نحب أن ننسى، لأنها مهارة الشعوب المهزومة. نحب أن ننسى، لأن الذاكرة ثقيلة، والكرامة مكلفة…. والوطن بعيد.
الساعة الآن في دمشق تشير إلى التوقيت ذاته الذي يعرض فيه متحف في تل أبيب “وثائق الجاسوس” تحت ضوء أصفر هادئ، يضيء على قميصه الأبيض الذي ارتداه ذات مساء، في حفلة داخل وزارة الدفاع السورية.
منذ أن تم دفن إيلي كوهين في قبر لا يحمل اسمه، ظلت إسرائيل تنبش كل شيء في الوطن حتى داخل ذاكرتنا أيضا… والمفارقة أن من دفن كوهين لم يكن حفار قبور… كل من عرف أين دفن الجاسوس مات: أمين الحافظ، حافظ الأسد، أحمد سويداني، مصطفى طلاس… كلهم أخذوا السر إلى القبر وتركوا إسرائيل تنبش … لكن إسرائيل لا تنسى. تأتي بعد خمسين عاما، وتسألنا بكل برود: أين دفنتم جاسوسنا؟ في اليرموك؟ وبعد أن تم هدم اليرموك وتحول الوطن إلى مقبرة جماعية، تعود إسرائيل لتسأل: أين دفنتم جاسوسنا؟ لكن ما لا تفهمه إسرائيل أننا لم نعد نعرف أين تم دفن الجاسوس… نحن فقط نعرف أن رفات الجاسوس مع ثلاث جنود آخرين ستسلم قريبا الى اسرائيل، تماما كما جرى تسليم الأرض، والذاكرة، والتاريخ…
تخيل معي هذا: جاسوس كاد أن يصبح وزير في حكومة “البعث”، وربما لو تأخر انكشافه أسبوع آخر، لكان اصبح وزير داخلية أو ناطق باسم القيادة القطرية… او رئيس بديل، لا فرق.
يقال ان ايلي كوهين كان صديق امين الحافظ، وأنه فكر جديا في توزيره. نعم، الجاسوس وزير في حكومة الوحدة والحرية والاشتراكية. قيل إنهما جلسا سويا، يحتسيان القهوة، ويتبادلان النكات الثقيلة عن “المؤامرة الإمبريالية”. كان كوهين يومها يضحك، ثم يرسل ضحكته مشفرة إلى تل أبيب، وعدد الكؤوس الفارغة أيضا… قالوا إن المعلومات التي سربها ساهمت في هزيمة حزيران. اكيد، لن نعرف كم ساهم… ويقال ايضا، ان كوهين لم يسقط لأنه جاسوس، بل لأنه نسي سورة الفاتحة… طلب منه أمين الحافظ أن يتلوها، فخانته الذاكرة. تخيلوا، رجل جاء من تل أبيب، وسقط في دمشق لأنه نسي سورة الفاتحة.
لكن فلنترك الماضي. دعونا نذهب إلى الحاضر، حيث الجولان هادئ ومحتل، والجنوب السوري منزوع السيادة و الميركافا على مشارف دمشق، وبشار الأسد خرج من الصورة إلى جهة لا نعرفها، وربما لا تهمنا.
نعم، يا صديقي…
نجح كثيرون مما لم يكن لهم وجه كوهين، ولا اسمه العبري، ولا أذنه الموصولة بتل أبيب، لكنهم كانوا أخطر منه، لأنهم خرجوا من قلب هذه الامة العربية. لم يكونوا بحاجة إلى جهاز إرسال تحت الأرض، ولا إلى رسائل مشفرة ولا الى الحبر السري. كانوا رؤساء شرعيين، ملوك، قادة، او ابناء جنرالات الانقلابات.
دخلوا القصور محمولين على أكتاف الجماهير، ثم فتحوا بوابات البلاد للمستعمر المحتل.
بعضهم وقع اتفاقيات سلام…
وبعضهم سلم الجولان… وبعضهم بارك قصف بغداد وهو يبكي على القدس…
وبعضهم حول الأمن إلى مؤسسة تجسس على مواطنيه… وبعضهم باع فلسطين والقضية. وسوريا. ولبنان.
هل هؤلاء جواسيس؟ ربما أسوأ.. الجاسوس خائن من الخارج. أما هم، فخونة من الداخل، باسم الأمة، والدين، والعلم، والنشيد الوطني. وباسم الشعب…
نعم، كما في ختام الأحكام القضائية،”باسم الشعب”: يصدر الحكم. لكن هنا يصدر الحكم على الشعب نفسه.
لذلك، لا تسأل.
لا تكتب.
لا تصرخ.
ففي الجمهوريات المهزومة،
كل من يعرف شيئا…
يغمض عينيه كي لا يرى.
تلك النظارات هي رمز لما فقدناه من ورؤية حقيقية للواقع المؤلم الذي نعيشه.
إسرائيل تسترد كل ما يخص جاسوسها
أما نحن، فنبحث عن شبر من وطن،
لنحرسه ويكبر.
النهاية.
أستاذة جامعية، باحثة في العلاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان – باريس