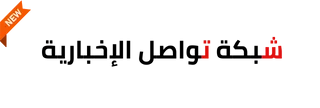هند دويكات: “البلطجة القادمة إلى الشرق”.. العمل السينمائي الأخير

هند دويكات
لن تسمى متابعا سينمائيا جيدا لو لم يكن مارلون براندو قد استمر في إدهاشك منذ المرة الأولى التي رأيتَه فيها ببدلته السوداء ولهجته المتعالية الكسولة في “العرّاب” 1972، إلى المرة الأخيرة التي أعدتَ فيها مشاهدة الفيلم، بل ولن تكون كذلك إذا لم تحفظ وتكرر بعض عباراته “الجذابة”، كيف لا تفعل وهو “قائد المافيا” الذي لم يأت، ولو لمشهد واحد، بعمل مناف للفطرة السليمة، فلم يظهر وهو يقتل بيده أحدا، أو يسرق بيده مالا، أو يتاجر بيده في سوق سلاح، أو يؤسس بيده محلا للقمار، بل كان، في مشاهده كلها، الأب الحكيم الحاني، والزوج المخلص، والصديق الذي لا يخذل أبدا، في حبكة تنسيك تماما أن كل من حوله ممن ظهروا ولم يظهروا في الكادر هم القفازات التي تحفظ يديه من قباحة فعله، حبكة تجعلك تبدو زعيم مافيا أكثر منه.
يمكنك أن تسمي هوليوود، وشريكاتها، بكاتب “الإلهام” الأمريكي المقدّس، فهي كما كانت تقدم الأعمال التي تحضّ الجنود الأمريكيين على القتال في فيتنام، وتجعل الأحياء والقتلى منهم أبطالا خالدين، تحولت بسيناريوهاتها في مرحلة لاحقة إلى تسجيل المجد والسؤدد الدائميْن في تاريخ أرباب الأعمال الإجرامية، على سبيل المثال الوقتي. وأما في أمثلة توجهاتها “العامة” ومنهجها المستدام، فالأفلام التي تروعك من ألمانيا-هتلر وحصرها مسألتَه مع اليهود كسبب أوحد “لشذوذه” السياسي والعسكري، أو التي تثير فيك الشك من أن كل جاسوس خفيّ محتمل هو روسيّ لا محالة، أو التي تثير اشمئزازك من كل لحية طويلة وثوب رث لتؤكد لك أن عربيا سيتكلم حالا وسيأتي بفعل بغيض، معا. يمكنك ببساطة تتبع بعض الأعمال البارزة وسنوات إنتاجها، لتجد أن الولايات المتحدة لم تنتج سينمائيا إلا تحولات مصالحها الكاملة، ولم تقدم أعمالا بمعزل عما يدور في رحى سياستها الخارجية والداخلية، بل وما يجعلها اقتصاديا واجتماعيا وعقائديا (لنقل عقائديا) رهنا بما تمليه على الكاميرا. وإذا ما حطت بك رحال التتبع عند السنوات القليلة الأخيرة، ستجد سينماها قد وصلت بمحتواها إلى ذروة أمراض الانفصال عن الواقع والرعب المركّب والإجرام الذي لا تحدّه رقابة سينمائية أو غيرها، أما ما يزيد الأمر رعبا أن رحالك لن تحطّ هنا طويلا، بل إنك لن تملك إلا أن تقفز إلى الأمام قفزا أولومبيا.
لن تعطيك السينما الأمريكية أكثر مما أعطتك، فالإدارة الأمريكية الحالية ستبهرك بتوقُّفها عن الإبهار، بمعنى أبسط أنها لم تعد تمتلك ما يجعل العالم متطلعا لما هي عليه من قوة وسيطرة واستحواذ من حيث أدواتها المعتادة. فمنذ أوائل القرن الماضي، ومنذ سقوط الخلافة الأخيرة في الشرق، تنوعت أدوات الغرب في تنويع أشكال الحكم والإمساك بعصا تثبيته، من: استخدام الإدارات المكونة من أصحاب البلاد التابعين لها، والتدخلات العسكرية المحددة المكان المحدودة القوات، والتي ساعدت عليها ابتداء الأسوار الإسمنتية وأبراج المراقبة والأسلاك الشائكة التي قسمت الشرق إلى دويلات متناحرة، وتسليح الجماعات المعارضة للحكم الذي اختاروه أولا، وفي كفة موازية مساوية تسليم امتيازات تسيير كل ما يدور على الأرض، وما تحتها، لشركات أوروبية وأمريكية، وإقراض/إغراق “الدويلات المتناحرة” بتريليونات من العملات الورقية التي لا تحتمل وفاء فوائدها. كل ما ذُكر، كمثال لا حصر، لم يعد يجدي نفعا في المرحلة الحالية لتقديم الولايات المتحدة عن غيرها، وهذا ما سيجعلها تستخدم آخر “كرة نار” من عليائها، الباقي حتى اللحظة، وتلقيها في وجه الجميع فتحرق بها مصالح العدو والحليف على السواء.
ستسأل نفسك، أو أحدهم، ما الذي أوصل الولايات المتحدة إلى هنا بهذه السرعة الخاطفة؟: ما الذي دفع الحكومات الأوروبية لتفصل بين مصالحها والمصالح الأمريكية؟ وما الذي جعل الولايات المتحدة تحاول إيجاد حليف مؤقت من الأعداء التاريخيين كروسيا والصين رغم مشاكستها إياهم في العلن؟ وما الذي أخّر امتثال بعض الدول العربية للرغبة الأمريكية بالتطبيع (ومثلها في التهجير)؟ ما الذي يؤخر دفع الإتاوات (على اختلاف أسبابها ومسمياتها) التي تتوعد الإدارة الأمريكية بها دول العالم؟ وما الذي خلق أصواتا داخل المؤسسات العالمية البارزة تقاطع/تحارب السياسة الأمريكية؟
لتجد الإجابة في رواية عُرضت بتاريخ السابع من تشرين أول 2023 لم تكن لتصدقها لو لم تعاصرها بحواسك كلها: مجموعة مسلحة تدخل إلى الأراضي المحتلة منذ ١٩٤٨ لتأسر بضع عشرات من العسكريين والعسكريين الاحتياط وتعود بهم من حيث أتت، ولكن ما شأن الولايات المتحدة بذلك؟
ليس لأنها الحليف والداعم الأول “لدولة الأسرى” المذكورين أعلاه وحسب، بل لأن “الفوضى الخلّاقة” التي سببتها تلك “الجماعة” هي ما جعلت الولايات المتحدة تعرض، بنفسها، على شاشات العالم كافّة أنها كانت تتهاوى داخليا لاقتراب “نفاد أدوات سيطرتها العالمية” منذ مدة غير قصيرة، في الوقت ذاته والمفترض أنها كانت ستحاول فيه حل أزماتها دون “فضائح”، كعجوز متصابية تبحث عن ممول محتمل لإجراء جراحة تجميلية تخفي تجاعيدها المخيفة، ولكن سبقتْ “الدراجات الغزّية/الغازِيَة” سيارات الفورد والشفروليه.
لم يعد بالإمكان إلا إعلاء الفوضى، ولكن هذه المرة فوضى غير أخلاقية وغير بشرية على الإطلاق، والتي حان فيها وقت تشمير “السوبر مان” عن ساعديه، ليفعل ما يتقن فعله غير أنه كان يخفيه تحت بدلة “منقذ العالم”: ضرب كل ما تطاله يده دون تراجع عن هدف أو تخفيف حدة أو استثناء جهة، والخوض في حرب طاحنة بكلتا يديه دون استخدام كامل “لقفازات” أو استعانة تامة بوكلاء، والموازنة بين الحليف الأكيد والحليف الممكن ثم زجهما معا في المحرقة، وتصنيف كل ما يتحرك على الأرض، أو يسكن فيها، بالجسم المشبوه الواجب إنهاؤه، حتى يفنى “البطل الخارق” وقوته معا، ويسجل، هذه اللقطة السينمائية “المبهرة”، عبر كاميراته لصالح فيلمه الأخير.
ولكن ما يعنيك، ويعنينا جميعا في هذا الشرق الحزين، هل سنتفرج، كعادتنا، على هذا الفيلم، ونحترق قربانا لصنّاعه، أم سنغيّر “العادة”؟!
كاتبة فلسطينية