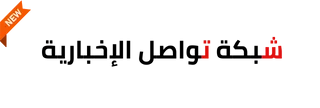الهوية والتكوين الثقافي للطفل من خلال الحكاية..تكوين المخيلة وتغذية الحس الأخلاقي

مسقط
في 5 مايو / العُمانية / تُعد الحكاية من
أقدم الوسائل الشفهية التي استخدمها الإنسان لنقل القِيم والمعارف الإنسانية عبر
الأجيال، ولكونها أداة مهمة في تشكيل وعي الطفل منذ البدايات وبناء هويته
الثقافية، فقد أصبحت لغة مجتمعية لا يمكن تجاوزها أو الاستغناء عنها، فهي عامل
يكتشف الطفل من خلاله ملامح بيئته ليتعرّف على عاداتها وتقاليدها، أضف إلى أنها
تلعب دورًا محوريًا في تكوين المخيلة وتغذية الحس الأخلاقي والإنساني لديه، مع
مساهمتها الفعلية في ترسيخ الانتماء وتشكيل ملامح الهوية الفردية والجمعية له.
في
هذا السياق، يتحدّث الشاعر والكاتب المسرحي العُماني عبدالرزّاق الربيعي عن الهوية
والتكوين الثقافي للطفل من خلال الحكاية، حيث التفاعل والترسيخ، وما يمكن تفعيله
والعمل عليه في هذا السياق والحديث، ويقول: تمثّل الحكايات الشعبية مصدرًا مهمًا
في تشكيل هوية الطفل وتعزيز تكوينه الثقافي، من هنا تأتي خطورة التعاطي مع
الحكايات الشعبية، التي هي نِتاج تجارب وخبرات متراكمة؛ فكثير منها خلّف جراحًا
نفسية ظلّت راسخة في ذاكرة وطبقات اللاوعي لدى الأطفال، وخصوصًا الحكايات المخيفة
التي تتحدث عن الجن والأشباح، والحيوانات المفترسة. وكثيرًا ما ظهرت للأطفال عند
منامهم على هيئة كوابيس مسبّبة الفزع والخوف لهم، لأن تلك الحكايات من نتاج
المخيال الشعبي، وهو مخيال يقوم على الفطرة والعقل الجمعي، لا على التفكير
المنطقي. من هنا ينبغي غربلة تلك الحكايات وإعادة إنتاجها، وحذف غير المناسب منها،
وهذا لا يتم إلا عن طريق الكتابة الإبداعية وتقريبها من أذهان الأطفال، وطرحها
بأسلوب مشوّق، وجعلها محبّبة لهم. علينا اختيار الحكايات التي تعزّز القيم
والأخلاق.
ويضيف
الربيعي: أمثال هذه الحكايات من الضروري أن تبقى حيّة في الأذهان لكونها تمثّل
هوية وطنية، ومن المفيد لنا أن نوصلها إلى النشء الجديد قبل أن تندثر، لكونها بقيت
شفاهية، والكثير منها غير مدوّن. وفي ظل الانفتاح على العالم الخارجي، صارت
الهويات الثقافية مهددة بالاندثار مع هبوب رياح العولمة. وإذا وجدنا بعض الحكايات
فيها الصالح والطالح، فعلينا عدم تجاهلها، بل ينبغي وضع معالجات جديدة. ويكون
واجبنا -ككُتّاب ومشتغلين في هذا الحقل- أخذ المناسب وترك غير ذلك، تجنبًا للأثر
السلبي الذي تتركه تلك الحكايات على نفسية الطفل في المستقبل.
ولي
تجربة في هذا المجال في مسرحية “كهرمانة”، في قصة “علي بابا
والأربعون حرامي”، وهي من حكايات “ألف ليلة وليلة”، والكثير من
حكايات “ألف ليلة وليلة “غير صالح للأطفال، علمًا أن أول مسرحية للأطفال
في الوطن العربي مأخوذة من كتاب “ألف ليلة وليلة”، كتبها كامل الكيلاني
سنة 1927، وعنوانها السندباد البحري. الكثير من الحكايات تقوم على السحر، والسخرية
من البشر، والخيانة. وحين قرأت حكاية “علي بابا والأربعون حرامي”، لفتت
نظري شخصية كهرمانة، فركّزت عليها، أما بقية الحكاية فقد وجدتُ فيها مشاهد دامية
وقتلًا وخداعًا وسرقة، وهي لا تناسب الأطفال. لذا؛ قمت بتشذيبها وإضفاء طابع
كوميدي على الشخصيات والأحداث، وفي النهاية التركيز على ذكاء وشجاعة كهرمانة، وهما
الدرس المستفاد من المسرحية. وبذلك نضمن للعرض أن يساهم في تكوين شخصية الطفل،
ودفعه للأمام، فالمسرح: “أقوى معلم الأخلاق، وخير دافع للسلوك الطيب، فدروسه
لا تُلقن بالكتب، بل بالحركة المنظورة” -كما يقول مارك توين-.
أما
الحكواتية اللبنانية سارة قصيّر الزين، فتتحدث عن الكيفية التي يمكن أن تُشكّل بها
القصة / الحكاية، لتكون هدفًا يحمل قيمة أخلاقية ورمزية من خلال الصوت، لتتحوّل
إلى الفكرة المراد التعبير عنها وصورة ذهنية متحرّكة لدى الطفل، مرورًا بالأدوات
التي يجب العمل عليها ليكون الطفل أيضًا شريكًا في إنتاج المعنى الحقيقي المتعلق
بالحكاية، وتقول: منذ القدم، شكّلت الحكاية محورًا أساسيًا في النسيج الثقافي
العربي، حيث أدّت أدوارًا تتجاوز حدود التسلية إلى نقل القيم والمعرفة والتجربة الإنسانية
عبر الأجيال. واحتلّت الحكاية الشفوية منزلة مرموقة في التربية، إذ كانت وسيلة
لبناء الوعي الجمعي وتثبيت الهوية، من خلال مضامينها الرمزية وأشكالها التعبيرية.
ومع تطوّر النظريات التربوية والنفسية الحديثة، تزايدت القناعة بأن الحكاية ليست
أداة تعليم غير مباشر فحسب، بل منظومة متكاملة تُسهِم في تنمية الخيال، وتعزيز
اللغة، وبناء الهوية الثقافية لدى الطفل.

وتضيف:
تُعد الحكاية اليوم وسيطًا تربويًا وثقافيًا مركّبًا، قادرًا على تحويل الطفل من
متلقٍّ سلبي إلى منتج للمعنى، ضمن تجربة تفاعلية تُفعّل قدراته التعبيرية
والمعرفية. ويُعد الصوت في الحكاية أحد أبرز العناصر التي تُمكّن هذا التحوّل؛ فهو
لا يُفهم بوصفه مجرد وسيلة لنقل الكلمات، بل كقناة حسّية معقّدة تُفعّل الجهاز
العاطفي لدى الطفل. فنبرة الصوت، إيقاع الجمل، الوقفات، والهمسات، كلها عناصر
تُحوّل الكلمات إلى مشاهد داخلية حيّة. فحين يستمع الطفل إلى صوتٍ يرتفع عند ذكر
لحظة خطر، أو يهبط عند توصيف حالة حزن، توجد لديه صورة ذهنية تُشبه “المشهد
السينمائي” في الذاكرة. وبهذه الطريقة، يتحوّل الصوت إلى لغة رمزية ثانية، تُترجم
المفردات إلى إدراكات بصرية وعاطفية، وتُعزز من عمق التفاعل مع القصة.
وتؤكد
بالقول: إن هذه الصورة الذهنية ليست جامدة، بل هي متحرّكة ومتجددة، تُعيد تشكيل
نفسها وفق تجارب الطفل ومخزونه الثقافي، ما يسمح للحكاية بأن تتجاوز زمنها النصي
لتعيش في وجدان الطفل كخبرة متجددة تُسهم في بناء هويته ووعيه القيمي والنفسي. غير
أن هذا الدور لا يكتمل دون أدوات تُشرك الطفل في بناء المعنى، مثل: السرد
التفاعلي، وإعادة التمثيل، والتحليل الرمزي، والوسائط المتعددة، والكتابة
الإبداعية، فمن خلال هذه الوسائل، يُمكن للحكاية أن تكون أداة لتوليد المعنى لا
تلقينه.
وتوضِّح:
في السياق العُماني، تزخر الذاكرة الشعبية بحكايات مثل: “غرنوق وسعدة”
و”سعلوه في الوادي”، وهي نماذج قابلة لإعادة التوظيف ضمن مقاربات حديثة
تعزّز من حضور الطفل كفاعل ثقافي، يُنتج المعنى ويُعيد بناء علاقته بجذوره وقيم
مجتمعه.

وتتحدث
الحكواتية الفلسطينية دينيس أسعد عن الحكواتي، وكيف يمكن أن يكرّس صوته الحسّي
الظاهر ليصبح الوسيط الحيوي بين العالم الخارجي وخيال الطفل، والممكّنات التي يمكن
أن يُعمل عليها لإدخال الطفل في علاقة شخصية ووجدانية مع شخصيات الحكاية: تناقُل
القيم المسيطرة في أي مجتمع، الإيجابية منها والسلبية، والعادات الاجتماعية من جيل
إلى جيل، كانت -وما زالت- من أهم وظائف الحكواتي عبر العصور، فمن خلال اختياره
للحكاية وسردها بأسلوبه الخاص، مع التشديد على ما يعتبره الأهم من عناصر الحكاية،
يُسهم الأمر في بلورة أفكار الأطفال، وبالتالي في التأثير على هويتهم الثقافية
والوطنية، خاصة في حالتنا الفلسطينية.

وتضيف:
لكل حكواتي أسلوبه الخاص في السرد، وينعكس الأمر على اختيار الحكاية التي أحبّها
والتي تعكس القيم التي يؤمن بها ويرى أنها مناسبة لجمهوره، ومنها القيم الإنسانية
والوطنية والدينية، مع تحرير نص الحكاية أدبيًا أولًا ليكون متكاملًا من ناحية
ميزات الحكاية الشعبية الأدبية، وثانيًا -وهو الأهم- للتخلص من أي مقولة أو حدث
عنصري في الحكاية. أضف إلى ذلك أن لغة السرد تعتمد على ثقافة الحكواتي وتجربته،
وعلى ما ينوي ترسيخه في ذهن الأطفال من كلمات ومرادفات ومعلومات. مثال من حكاياتي:
أنا أحاول إدخال تفاصيل المكان بهدف الحفاظ على صورة خريطة فلسطين الكاملة، من
البحر إلى النهر، حيّة في قلوب أطفالنا، -وبالطبع هذا أضعف الإيمان-: “كان يا
ما كان، يا مستمعات ويا مستمعين، في أجمل مروج فلسطين الواقعة بين الناصرة وجنين،
وقبل الاحتلال…”، وأسأل الأطفال إذا كانوا يعرفون اسم المرج، وهكذا.
مع
إتاحة الفرصة للجمهور لأخذ دور فعّال في سرد الحكاية، ويتم ذلك من خلال تكرار
لازمة معيّنة في الحكاية عدة مرات، أو التوقف عند موقف معين وطلب رأي الأطفال فيه،
مما يساعد على شعور الطفل بأنه مؤثر في مجرى الأمور في الحكاية. ولطالما اعتُبر
إعادة سرد الحكاية من قبل الأطفال جزءًا من طقوس سرد الحكاية من قبل الجدّات
والأجداد، لذلك من المهم إعادة سرد الحكاية مع الأطفال، وإعطاؤهم الفرصة لسردها
بلغتهم الخاصة.
وتتابع:
لقد طوّرتُ منهجية علمية عملية لإعادة سرد محور أحداث الحكاية بعدّة طرق: من خلال
الحركة، ومن خلال اللمس، ومن خلال الصور، وهناك عناصر أخرى تؤثر في مساعدة الأطفال
لتذويت الحكاية، بدايةً بما يرتديه الحكواتي.
وتتحدث
المدربة العُمانية والمهتمة بالتربية وأدب وثقافة الطفل، زهرة بنت أحمد الجامعية،
عن الحكاية /القصة/ بوصفها أداة لتشكيل الوعي لدى الطفل، ومدى تأثير رمزيتها
الشعبية أو التراثية في تكوين وتشكيل هويته الثقافية، كونها أداة من أدوات التربية
الوجدانية لديه، وتقول: على مر الأزمان كانت الحكاية ولا تزال أحد الأدوات
الأساسية لصياغة وتشكيل ما هو مرغوب ومنبوذ في المجتمعات، ولا تزال شخوص الحكايات
وأبطالها باقية، رغم أننا في بعض الأحيان لا نستطيع الجزم بأنها كانت واقعة أو
حقيقية، إلا أننا توارثناها منذ اللحظة التي وصلت إلى مسامعنا، فلا تزال تلك
الدهشة التي اعترتنا في اللحظة التي سمعنا فيها حكايات نور الزمان المختبئ في جذع
الشجرة الذي ينفتح كل ليلة لعروسه من الإنس ليكشف لها قصرًا ممتدًا، أو علاء الدين
وهو يجوب الأرض محلقًا على بساطه السحري الطائر، أو مغارة علي بابا والأربعون
حرامي، باقية حتى اللحظة. لا يزال يقيننا بأن الخير لا بد أن ينتصر، وبأن الشرير
سيقع في شر عمله، وأن حفظ الأمانة فوز عظيم.

وتضيف:
أن القصة -بلا شك- هي أحد أهم أدوات تشكيل الوعي، وترسيخ القيم والمبادئ، بدءًا
بالقرآن الذي فيه سورة كاملة اسمها سورة القصص، وقوله تعالى: (نحن نقصُّ عليك أحسن
القَصَصِ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) (الآية 3 سورة
يوسف). ونحن نتحدث هنا عن منهج رباني أراده الله دستورًا للبشرية، هذا المنهج
استخدم القصص كأحد أهم الوسائل لغرس القيم الربانية التي يريد لها الله أن تكون
منهجًا للبشرية، لتبقى أكثر من 1400 سنة حتى الآن. فما الذي يجعل القصة أو الحكاية
بهذه القوة، خصوصًا عندما نتحدث عن مرحلة الطفولة؟
وتؤكد:
إن عالم الحكاية هو أحد أجمل العوالم التي يمكن للطفل أن يعيشها، حيث تبقى تفاصيله
مغروسة في عقل الطفل، بدءًا بالوقت والرائحة ودفء صوت الحكواتي (أيًّا كان: الجدة،
الأم، الأب، المعلم) والتفاصيل الصغيرة، حيث بمجرد وصول صوت الحكواتي إلى مسمعه
تبدأ مخيلته في تشكيل الصور والشخوص والأماكن والأحداث، وتبدأ ملامح خارطته
الإنسانية بالتشكُّل، ففي كل حكاية هناك بطل أسطوري يرى الطفل فيه نفسه، مشكّلًا
بذلك أنموذجًا قيميًّا يرغب في أن يتقمّصه. وكل حدث في الحكاية يأخذ الطفل إلى
أبعاد شعورية مختلفة؛ يغضب، ويتحمس، ويحزن، ويفكر، ويخاف، ويقلق مع اختلاف الشخوص،
ولكنه بطبيعة الحال سيختار دوره الذي يريده لنفسه. وفي هذه المرحلة المباركة من
عمر الطفل، هو لا يستمع لحكاية عابرة فحسب، بل هو يشكل الذكريات والروابط العصبية
ومنظومته القيمية الخاصة في دماغه، الذي سيحتفظ بكل هذه المعلومات، والتي ستظهر في
مراحل عمره القادمة كردود أفعال تجاه المواقف التي تحاكي الحكاية؛ لينبذ الظلم على
سبيل المثال، ويمقت الكذب، أو ليتقمّص دور المفكر والعالِم ونهجه في الحياة. ستتضح
له قدواته التي يرغب أن يسلك طريقها، والشخصيات التي يرغب بأن يتجنبها، ستحدد له
دائمًا الدروب التي ينبغي له أن يسلكها، وستحدد أيضًا زاده وحمولته التي يرغب بأن
يتزوّد بها في دربه. ليس ذلك فحسب؛ بل ليحاول أن يتقمّص هوية أبطال الحكايات التي
نشأت في بيئته، ويفخر بها.
وتبيّن
حديثها: يمكننا أن نقول إن الحكاية هي من أهم الأدوات التي يمكن للمربي أن
يستخدمها لتشكيل الهوية والتربية الوجدانية للطفل، حيث إنها تثري حصيلة الطفل
بنموذج قيمي وسلوكي يعبر عن خصوصية مجتمعه، مما يساهم بلا شك في تشكيل المنظومة
الإنسانية للمجتمع. ولكن في خضم الانفتاح الكبير على العالم وثقافة الآخر، أجد بأنه
لا بد لنا من العناية بهذا الأدب / أو الفن، والاشتغال عليه بشكل ممنهج لصناعة
وتأصيل رموزنا الثقافية والفكرية في عقول النشء القادم، وذلك لا يتأتى إلا بالعمل
المدروس والمنظم. اليوم تقلصت الأوقات التي يمتلكها المربون مع أطفالهم، وذلك بحكم
طبيعة الحياة والانشغال، فنحن اليوم بحاجة إلى صناعة تواكب توجهات هذا الجيل،
كإعداد برامج قصصية مرئية، أو تبني مشروع كتب تتضمن النماذج المشرفة للهوية
الوطنية سواء من الجيل المنصرم أو الحالي، ولا بد أيضًا للأسرة أن تعي أن القصة
والحكاية هي أحد أهم المفاتيح التي يمكنهم استخدامها لتشكيل هوية الطفل بدءًا من
توجهاته وقيمه وثقافته وانتمائه، وذلك يعيدنا إلى ضرورة ما يقع تحت أعين أطفالنا
أو مسمعهم، لأننا بلا شك سنحصده جميعًا بعد حين.
/ العُمانية/ النشرة الثقافية/
خميس
الصلتي