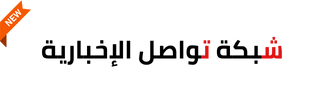موازنة Pac-Man: بين المحاسبة والاقتصاد

ليست كل الرسوم البيانية مجرّد أشكال هندسية ملوّنة، فأحيانًا تختزل الأرقام ما تعجز الكلمات عن شرحه، وهذا تمامًا ما فعله رسم بياني بسيط أعددته بمناسبة إعلان موازنة العام المالي القادم، عارضًا من خلاله تطوّر نسب استخدامات الموازنة العامة في الفترة من 2015 حتى 2026، وقد لاقى هذا الرسم تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزه ما نُشر من قبل أحد صنّاع المحتوى محمد جلال، والذي جاء مصحوبًا بتساؤلات عميقة رأيت أن من المهم التوقف عندها.
يقارن الرسم بين المكونات الرئيسية لهيكل الموازنة خلال هذه الأعوام، وهي بند الإنفاق العام الذي يمثل إجمالي المصروفات الحكومية المختلفة، وبند الأجور المعني بالرواتب والأجور التي تدفعها الحكومة للعاملين في القطاع العام، ثم بند الدعم الذي يرصد المخصصات المالية لدعم السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وأخيرًا بند الدين المعني بتوضيح أقساط وفوائد الديون المستحقة على الدولة خلال العام.
ويعكس الرسم البياني تصاعدًا مطّردًا في نسبة مخصصات عبء الدين الأقساط والفوائد من إجمالي استخدامات الموازنة العامة، إذ ارتفعت من 43.7% في عام 2015 إلى 62% في 2025، مع توقع استمرار هذا الاتجاه لتصل إلى 65.4% خلال العام المالي القادم، وهو ما يأتي على حساب باقي المكونات، حيث تراجعت نسب الأجور والدعم والإنفاق العام بشكل ملحوظ خلال الفترة ذاتها، مما يعكس اختلالًا متزايدًا في هيكل الإنفاق العام ومدى اتساق نموذج إدارة المال العام مع أولويات التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.
وكتب جلال نصًا: الصورة دي -يقصد الرسم-، اللي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد رسم بياني بألوان متناسقة، هي في الحقيقة مرآة دقيقة لأولويات مالية في بلد يقترب تعداده من 120 مليون نسمة.. رسم دائري بسيط يختصر في تفاصيله شكل الموازنة العامة للدولة، ويعكس تحولات عميقة في بنود الإنفاق خلال عقد من الزمن، من 2015 إلى التوقعات المعلنة لعام 2026.
يتساءل: هل النموذج المالي الحالي في مصر قابل للاستمرار؟ وهل يمكن أن نتصور تنمية حقيقية وإنفاقًا اجتماعيًا فاعلًا في ظل موازنة تقيدها أعباء الدين إلى هذا الحد؟، ويزيد تساؤلاته: هل هذا معناه إن الدولة بتسعى لسداد ديونها بأي ثمن؟ أم أن هناك خطة طويلة المدى لا تظهر في لغة الأرقام؟
إلى هنا قد انتهت تساؤلات هذا المدون الذي لا تربطني به أي معرفة سابقة، لكن لفت انتباهي بشدة واحترام ما طرحه من تساؤلات هامة للغاية تتعلق بتحليل الرسم البياني وما يحويه من إشارات، وأرى أن مثل هذا الطرح يثري النقاش العام ويُشجّع على التفكير والحوار البنّاء، وربما يفتح الباب أمام حلول حقيقية.
اللافت أيضا في تفاعل المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي هو ذلك التشبيه الذكي والعميق الذي صوّر الموازنة العامة كأنها لعبة Pac-Man الشهيرة، ففي هذا التصوّر، تمثل بنود الموازنة – مثل الأجور، الدعم، والإنفاق العام – حبات النقاط الصغيرة المنتشرة داخل المتاهة، والتي يُفترض أن تجمعها الحكومة كلاعب رئيسي، في محاولة لاستكمال المستوى وتحقيق أهداف التنمية.
لكن في نسخة الموازنة، هناك وحش يركض في المتاهة بسرعة وبدون توقف هو عبء الدين العام، لكن ما يميّز هذا الوحش عن نظرائه في اللعبة الأصلية، أنه ليس من السهل الهروب منه أو التغلب عليه، بل هو اللاعب الحقيقي الذي بدأ بابتلاع كل شيء في طريقه.
في عام 2015، كان هذا الوحش يلتهم نحو نصف النقاط، تاركًا مساحة لبقية البنود لتُصرف على المواطنين، لكن مع مرور الوقت، كبر الوحش وازداد جوعه، حتى أصبح في عام 2026 يبتلع قرابة ثلثي الخريطة، ولم يتبقّ لباقي البنود سوى الفتات يُقسَّم على التعليم، والصحة، والدعم، والمرتبات.
وأود أن أوضح بإيجاز أسباب اختياري لهذا الرسم تحديدًا، وما يمثّله من دلالات تتجاوز ظاهر الأرقام، إذ يعكس هذا الرسم الفارق الجوهري بين نظرة محاسبية تكتفي برصد البيانات وتجميعها، ونظرة اقتصادية تحاول النفاذ إلى ما وراء الأرقام، لفهم ما تخفيه من توجهات وأولويات وقرارات.
صحيح أن هذا الرسم يُبين في ظاهره مشكلة مالية، تتمثل في تضخم بند خدمة الدين داخل الموازنة العامة، إلا أن هذه المشكلة المالية في جوهرها تعكس خللًا اقتصاديًا أعمق، يتجلى في اختلال ترتيب الأولويات، حيث باتت الدولة تخصص جزءًا متزايدًا من مواردها لسداد أقساط وفوائد الديون، على حساب بنود محورية تمس حياة المواطنين مباشرة مثل التعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي، وحتى في الحالات التي قد ترتفع فيها مخصصات هذه البنود بالقيمة المطلقة، فإن معدل نمو تكلفة خدمة الدين يفوقها بكثير، ما يؤدي عمليًا إلى تآكل حصصها النسبية، ويقيّد قدرة الدولة على تخصيص مواردها بمرونة وكفاءة.
ويُشير هذا الاتجاه أيضًا إلى خلل أوسع في بنية الاقتصاد ذاته، حيث يتضح أن النشاط الاقتصادي لا يُنتج ما يكفي لتغطية التزاماته، وأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي أصبح يعتمد على الإنفاق الحكومي والاستهلاك، لا على الاستثمار الإنتاجي أو التصدير الذي يولّد موارد ذاتية مستدامة، وبالطبع فإن هذا النوع من النمو لا يبني قاعدة اقتصادية متينة، بل يزيد من الاعتماد على الاستدانة لتمويل الاقتصاد، ويؤدي تدريجيًا إلى اتساع عجز الموازنة وتآكل مقومات الاستدامة المالية.
كما أن تطوّر هيكل الموازنة العامة بهذا الشكل ليس مجرد انعكاس لعجز مالي أو تفاقم ديون، بل هو تجسيد ملموس لتحوّل الدولة من فاعل اقتصادي يملك زمام المبادرة، إلى كيان مالي محكوم بمنطق السداد والاستمرار، لا بمنطق التنمية والتوسع، خاصة وأنه حين تُلتهم الموازنة عامًا بعد عام بفعل خدمة الدين، فإن ما يضيع ليس فقط الدعم أو الأجور، بل تضيع معه قدرة الدولة على إعادة تشكيل اقتصادها، والتحكم في مصيرها التنموي، وتُنتقص معه بنود العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة.